السؤال
أنا في ال 16 من العمر، ومتدين والحمد لله، وأنا أصغر إخوتي، وأنا تركت الأفلام والمسلسلات والأغاني وكل حرام، ولكن إخوتي لا، ولما أنصحهم يقولون نحن أكبر منك ونعرف الدين وأنت لن تعلمنا، وأرى أخطاء كثيرة ولكني أنصح إخوتي، ولكن أفراد عائلة أعمامي أرى الأخطاء الكثيرة ولكني لا أستطيع أخاف أنهم يضحكون علي لأنهم يستهزؤون بالناس فأتوقف عن نصحهم. فماذا أفعل هل علي إثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحبب إليك الإيمان، ويزينه في قلبك، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ثم اعلم أيها الفتى الكريم أنك قد ذكرت عن نفسك فضيلتين عظيمتين وهما: التزامك بطاعة الله والعمل الصالح. ودعوتك إخوتك إلى ذلك.
فاحرص على أن تجمع إلى ذلك فضيلة ثالثة ضرورية، وهي الصبر على ما أصابك في سبيل ذلك، كما قال تعالى: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {لقمان: 17} قال السعدي: وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. ومن كونه فاعلا لما يأمر به، كافًّا عما ينهى عنه، فتضمن هذا، تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك فقال: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اهـ.
وبذلك يستكمل المرء الفضائل وينجو من الخسران، كما قال تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .{العصر3:1}
وينبغي أن تحرص على طلب العلم النافع الذي يؤهلك لبيان الحق والترغيب فيه والحض عليه، وينبغي كذلك أن تتحلى بحسن الخلق وجميل العادات ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة فتنال بذلك ثقة ومحبة من حولك وتنقلب الخصومة والعداوة إلى صداقة ومودة، كما قال سبحانه: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 34-35} قال السعدي: أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق، ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها، ولا في وصفها، ولا في جزائها هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ، ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصًا من له حق كبير عليك، كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فَصلْهُ، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا فلا تقابله، بل اعف عنه وعامله بالقول اللين. وإن هجرك وترك خطابك فَطيِّبْ له الكلام، وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، حصل فائدة عظيمة، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أي: كأنه قريب شفيق. وَمَا يُلَقَّاهَا أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله، لا يفيده شيئًا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع للّه رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحليًا له. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 35} لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 13288.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

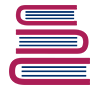
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات