السؤال
قمت بإدانة شخص أعرفه بقيمة كبيرة من المال (من باب تفريج كربة عن مسلم)، وكان الأولى أن نكتب وثيقة تثبت الاستدانة كما أمر الله في كتابه، لكننا لم نفعل بداعي الثقة من جهة، ولعاجلية الأمر؛ فقد احتاج المبلغ ليومه، وكان بعيدا جدا في مدينة أخرى، والواقع أن وجود الوثيقة من عدمه ليس هو مربط السؤال، بل: "ما هو الأولى: متابعة حقي أم العفو؟"
وهاكم تفصيل القصة:
بلغ أجل السداد منذ أشهر، ولم يتصل الشخص بي، ولم يرد على اتصالاتي، ثم انقطعت صلتي به تماما، فلا أرقام هاتفه تعمل، ولا عنوانه البريدي يستقبل الرسائل، علما أن سبب استدانته للمال هو مشاكل خاصة بسداد الكراء، ويبدو أنه تم طرده، وقد سألت عن أرقام هاتفه فعلمت أنها قطعت لأنه لم يدفع الاشتراكات، ويبدو أن مشاكله المالية لم تنته، كما أن هناك احتمالا أنه قطع اتصالاته فقط كي يتخلف عن السداد.
الآن لا أملك أي وسيلة للاتصال به، وهو كان يعيش في مدينة أخرى بعيدة جدا عن مدينتي، وليس لي وإن بحثت عنه فرصة في إيجاده بنفسي، ولم يبق لي إلا طريق واحد هو أن أبلغ الشرطة فتتحرى عنه، ولها أن تجلبه أينما كان لتسمع أقواله. لكنه ربما أنكر وفي هذه الحال ليس لدي حق عليه من وجهة نظر القضاء، لكنه ربما فعلها مع غيري من قبل، وبلاغي يزيد في إدانته أو لعله (على حسب ظني فيه) ليس كاذبا، وربما اعترف بالقرض، وربما وجدنا وسيلة لكي يرده لي ولو بعد زمن.
سؤالي هو: في ظل هذه الظروف ما هو الأولى: متابعته أم مسامحته؟ وإذا كان الأولى مسامحته، فهل يجزئ عدم متابعته وستره وإن لم يطب القلب تجاهه بالعفو من هول ما كان منه، والدعاء عليه بإصابته بمثل ما أصابني في الدنيا مع العفو عنه يوم القيامة؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل استحباب إبراء المعسر من دينه، والعفو عن الحق، فالشرع قد مضت أدلته على الندب إلى العفو في حقوق الخلق مطلقًا؛ قال ابن تيمية: فإن الله لم يوجب على من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم أو مال أو عرض أن يستوفي ذلك، بل لم يذكر حقوق الآدميين في القرآن إلا ندب فيها إلى العفو. اهـ.
ويرى بعض العلماء عدم تفضيل العفو في بعض الأحوال - كما سيأتي ذكره - . وراجع في فضل إبراء المعسر والعفو الفتوى رقم: 124262، والفتوى رقم: 27841.
لكن العفو وإبراء المعسر ليس بفرض، فلك أن تطالب بدينك، وأن تسعى في تحصيله، لكن إن علمت أن المدين معسر لا يملك وفاء دينه فالواجب عليك شرعًا إنظاره، ولا يجوز لك ملاحقته؛ قال ابن قدامة: وإن كان الدين حالا، والغريم معسرا، لم تجز مطالبته، لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] ولا يملك حبسه ولا ملازمته؛ لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك. اهـ. من الكافي.
ولتتنبه إلى أنه ليس لك إساءة الظن بالمدين دون موجب، كأن تتهمه بأنه يتهرب منك أو أنه ماطل في ديون من قبل، ونحو ذلك من الظنون السيئة، وإنما أنت بين خيرتين: إما أن تعفو عنه لله، وإما أن تسعى في الوصول إلى حقك.
والعفو ليس عند المقدرة على أخذ الحق فحسب، بل يكون كذلك عند العجز عنه؛ جاء في كتاب بريقة محمودية: (فإن لم يقدر على أخذ الحق) لعتو الظالم ورياسته، وكون المظلوم من أخساء الناس (فله التأخير إلى يوم القيامة) هذا الإطلاق وإن سلم بالنسبة إلى الحقوق البدنية والعرضية، لكن بالنسبة إلى المالية لا يخلو عن خفاء؛ لأنه يقتضي تفصيلا، وفي صلح النوازل: لو مات الطالب والمطلوب جاحد فالأجر له في الآخرة سواء استحلفه أو لم يستحلفه، ولو قضى ورثته برئ من الدين، وفي بعض الفتاوى: إن أمكن استيفاء بالقاضي أو الوالي فأهمل وأخر إلى الآخرة، فينقل إلى الورثة، وإلا فلا، بل للطالب، وقيل: ثواب وزر الأذى في عدم الإعطاء للطالب وثواب نفس المال للورثة.
(و) له (العفو وهو أفضل) من التأخير إلى الآخرة؛ قال في الإحياء: أخذ الحق بلا زيادة ولا نقصان هو العدل، والإحسان بالصدقة والعفو هو أفضل، والظلم بما لا تستحقه هو الجور، وهو اختيار الأراذل، والفضل: إحسان الصديقين، والعدل: منتهى درجات الصالحين، وسيشير إليه المصنف (قال الله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] والتقوى: جماع كل خير. أي: أقرب إلى الله تعالى لأجل التقوى، ولا تنسوا الفضل -كالعفو والإحسان- بينكم، وقال الله تعالى: {خذ العفو} [الأعراف: 199].
قال القاضي عياض في شفائه: وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا مما أدب الله تعالى به نبيه محمدا - صلى الله تعالى عليه وسلم -، فقال: « {خذ العفو وأمر بالعرف} [الأعراف: 199] وروي: «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شديدا، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة؛ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وقال الله تعالى: {والعافين عن الناس} [آل عمران: 134] آخر الآية {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] عن تفسير العيون: «قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على الله تعالى؟ فلا يقوم إلا من عفا» . وقال الله تعالى {وليعفوا وليصفحوا} [النور: 22] أي: ليعرضوا عن ذنوبهم، وهو في معنى العفو فيدل على العفو ولو التزاما {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22] قيل: أي: إذا عفوتم.
(وما زاد الله عبدا بعفو) أي: بسبب عفوه (إلا عزا) في الدنيا؛ فإن من عرف بالعفو والصفح عظيم في القلوب أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيهما. وجه الاستدلال بالحديث: أن العفو سبب لعزة الدارين، ولا يخفى ما فيه من الفضل.
(وإن قدر) على أخذه (فله العفو أيضا) كما إذا لم يقدر (وهذا أفضل من العفو الأول) أي: العفو مع العجز وعدم القدرة لعجز ذلك عن الأخذ حالا، وأنه أشق على النفس (و) من (الانتصار أي استيفاء حقه من غير زيادة عليه وهو) أي: الانتصار (العدل المفضول)، وقد عرفت قريبا ما نقل عن الإحياء أن العدل منتهى درجات الصالحين، والفضل إحسان الصديقين. هذا إذا خلا عن العوارض، وطبعه أن يكون كذلك (لكن قد يكون) العدل (أفضل من العفو بعارض) موجب لذلك (مثل كون العفو سببا لتكثير ظلمه) لتوهمه أن عدم الانتقام منه للعجز (و) كون (الانتصار) سببا (لتقليله أو هدمه) إذا كان الحق قصاصا مثلا (أو نحو ذلك) من العوارض مثل كونه عبرة للغير. (وإن زاد) على حقه (فجور وظلم). اهـ. باختصار.
وأما الدعاء على المدين: فلا يجوز إلا إذا ظلمك وماطلك مع القدرة على الوفاء، ولا يجتمع العفو عن الظالم مع الدعاء عليه أبدًا، فمن دعا على ظالمه فقد فاته مقام العفو؛ جاء في الآداب الشرعية: وقال يحيى بن نعيم: لما خرج أبو عبد الله أحمد بن حنبل إلى المعتصم يوم ضرب قال له العون الموكل به: ادع على ظالمك. قال: ليس بصابر من دعا على ظالمه. يعني الإمام أحمد: أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه فقد انتصر، كما رواه الترمذي من رواية أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعا: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» قال الترمذي: حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وهو ميمون الأعور، ضعفوه لا سيما فيما رواه عن إبراهيم النخعي، وإذا انتصر فقد استوفى حقه وفاته الدرجة العليا، قال تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] إلى قوله {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] .اهـ.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

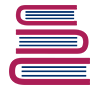
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات