السؤال
أنا طالب جامعي، والجامعة مكان مختلط، ولباس البنات ملفت للنظر بشكل كبير، ويثير الشهوة، وأقرب للفاضح، وأنا أحاول جاهدًا أن أغض البصر، ولكن دون جدوى، فلو نظرت للطريق أمامك فلا بدّ أن تلمح شيئًا يثيرك، وعندما أعود للمنزل بعد مشاهدتي لتلك المناظر، أشعر بصداع شديد، ورغبة شديدة لإفراغ شهوتي، فلا أجد سوى الاستمناء طريقًا لذلك، وإن لم أفعل أظل أشعر بصداع شديد، وأفكّر بتلك المناظر؛ حتى أقوم بالاستمناء، لأرتاح، وتهدأ أعصابي، فهل هذا حرام، أم يجوز لي أن أمارس الاستمناء في مثل هذه الحالة؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ابتلي بالاستمناء، أو العادة السرية أن يقلع عنها، فهي عادة خبيثة منكرة، لها آثارها السيئة على فاعلها، في دينه، وصحته النفسية، والبدنية، وقد سبق بيان تحريم الاستمناء، وبيان كيفية التخلص منه في الفتاوى: 1087، 7170، 284110، فراجعها للأهمية.
ولمعرفة المزيد مما يعين على غض البصر، والتغلب على الشهوة، نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423، 23231.
واعلم أن طلب سكينة الروح، وزوال الغمّ بالمحرم، لا يزيد المرء إلا وبالًا، فإن الله لم يجعل معصيته سببًا إلى خير قط -كما قال ابن القيم-، فننصحك بالتوبة، وترك الاستمناء.
ولا شك في أن العاصي قد يجد لذة بفعل المعصية، ولكن هذه اللذة وتلك السعادة التي يشعر بها سرعان ما تزول، وتبقى تبعة الذنب، وحسرته، فالعاقل اللبيب يفكّر في مرارة العاقبة، والذل، والهمّ، والألم الشديد الدائم الذي تورثه المعصية؛ فإن هذه الحسرة الطويلة لا تقارن بها لذة عاجلة تنقضي سريعًا، فهذه اللذة الحاصلة بممارسة المعصية، أشبه شيء بطعام لذيذ الطعم، لكنه مسموم، فأي عاقل يقدم على تناوله لأجل لذته، وقد عرف ما يعقبه من الهلاك، وكان الإمام أحمد -رحمه الله- ينشد:
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعارُ
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النارُ
هذا فضلًا عما تعقبه المعاصي من حلول النقم، وزوال النعم، وأدنى أثر من الآثار الضارة المترتبة على المعاصي لا تقارن به هذه اللذة العاجلة، يقول ابن القيم -رحمه الله-: والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذةٌ مّا، هي شر، وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة، وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي، لكنه مسموم، إذا تناوله الآكل لذّ لآكله، وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل، فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد، حتى لو لم يخبر الشارع بذلك، لكان الواقع، والتجربة الخاصة، والعامة من أكبر شهوده. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته!؟ فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة، حفظها عليه، ولا يغيرها عنه؛ حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ}، ومن تأمل ما قصّ الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم، الذين أزال نعمه عنهم، وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره، وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره، وما أزال الله عنهم من نعمه، وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب، كما قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن المعاصي تزيل النعم
فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه، فإنها نار النعم التي تعمل فيها، كما تعمل النار في الحطب اليابس، ومن سافر بفكره في أحوال العالم، استغنى عن تعريف غيره له. انتهى.
وقد أفاض ابن القيم في ذكر آثار المعاصي السيئة في كتابه: "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"، فيمكنك الرجوع إلى الكتاب.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
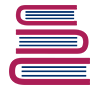
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات