الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سرقوا منك وهم صغار لا يأثمون بذلك؛ لرفع القلم عنهم، فلو ماتوا قبل البلوغ فلا شك أنك لا تأخذ من حسناتهم شيئا، ولا يحملون من سيئاتك شيئا.
وأما إذا بلغوا ولم يردوا إليك حقك بعد بلوغهم: فإنهم يأثمون بذلك؛ لأن حقك باق في ذممهم لا يسقط. وحينئذ: فإنك تأخذ من حسناتهم، أو يحملون من سيئاتك، إلا أن يتفضل الله عليهم، ويتحمل حقك عنهم.
وبيان ذلك: أن غير البالغ مرفوع عنه القلم، ولا يأثم بالسرقة، لكن ضمان المسروق لا يسقط عنه، بل يجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه.
قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ»، إنما يقتضي رفع المأثم، لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، فلو أتلفوا نفسًا أو مالًا؛ ضمنوه.
وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما، أو زنى، أو قطع الطريق، فهذا عُلِم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث. اهـ.
والأصل هو أن المظلوم يأخذ من حسنات ظالمه، أو يحمّل الظالم من سيئات المظلوم، كما في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار". أخرجه مسلم.
لكن قد يعوض الله -سبحانه- بفضله المظلوم عن مظلمته، دون أخذ شيء من حسنات الظالم، إذا تاب وصدق في توبته وعجز عن رد الحق.
قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة، وهذا حق. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين.
فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته.
وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا.
ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. اهـ.
وقال البيهقي في شعب الإيمان معلقا على الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة:
هذا يحتمل أن يكون المراد به حتى إذا هذبوا ونقوا، بأن يرضى عنهم خصماؤهم، ورضاهم قد يكون بالاقتصاص كما مضى في حديث أبي هريرة، وقد يكون بأن يثيب الله المظلوم خيرا من مظلمته، ويعفو عن الظالم برحمته.
وقد روي فيه -وأسند حديث عباس بن مرداس- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة، والرحمة، فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه أني قد فعلت، إلا ظلم بعضهم بعضا، وأما ذنوبهم فيما بينهم وبيني قد غفرتها، فقال: "يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته، وتغفر لهذا الظالم" فلم يجبه ذلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه: إني قد غفرت لهم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها، قال: " تبسمت من عدو الله إبليس، أنه لما علم أن الله تعالى قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل، والثبور، ويحثو التراب على رأسه".
قال البيهقي: وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب البعث، فإن صح بشواهده، ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]، وظلم بعضهم بعضا دون الشرك. اهـ.
وقال الغزالي في منهاج العابدين: وجملة الأمر، فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت، وما لم يمكنك راجعت الله -سبحانه وتعالى- بالتضرع، والصدق، ليرضيه عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله -تعالى- يوم القيامة، والرجاء منه بفضله العظيم، وإحسانه العميم: أنه إذا علم الله الصدق من قلب العبد، فإنه -سبحانه- يرضي خصماءه من خزانة فضله. اهـ.
ونوصيك بالعفو عن ظالميك ومسامحتهم، قال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

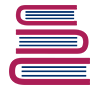
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات