الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشابه المذكور بين الأحداث تشابه ظاهري، ولكن عند التأمل يظهر أن الاختلاف جوهري بينها، فأفعال الخضر كانت بأمر الله تعالى، وهي أفعال ظاهرها منكر، وفي باطنها رحمة، أو حكمة خفية لا يدركها العقل البشري إلا بالوحي، أو العلم الخاص الذي وهبه الله لبعض عباده، بخلاف الأحداث السابقة.
ففي قصة التابوت كان إلقاء موسى في اليم خشية عليه من فرعون، بوحي من الله لأمه، ووعد لها بنجاته، ورده إليها، قال الله تعالى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ [القصص: 7].
فالأمر والحكمة ظاهران، أمّا في حادثة السفينة، فكان يخشى الهلاك على أهلها بسبب فعل يراه مخالفًا للمعروف، ولم يكن يعلم الحكمة الإلهية فيه.
وأمّا قتل الخضر للغلام، فكان بأمر إلهي مباشر، وبعلم خاص أُعطي للخضر من الله، حيث كان الغلام مستحقًا للقتل بسبب كفره، أو ما سيؤول إليه أمره من إضلال والديه المؤمنين، وكان في ذلك رحمة بالأبوين، وابتلاء لهما.
أمّا قتل موسى للقبطي، فقد كان ذلك بدافع نصرة المظلوم، ولم يكن القتل مقصودًا، إنما وقع عن طريق الخطأ، فلذا؛ استغفر موسى ربه من ذلك الذنب، قال تعالى: قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [القصص: 16].
وأمّا في السقي للفتاتين، وبناء جدار الغلامين بغير أجر، فأوجه التشابه الظاهري بينهما أظهر مما سبق، فكلا الفعلين فيه إحسان بلا مقابل، وعمل خير للآخرين دون انتظار جزاء دنيوي، وكلاهما وقع في حال شدة وحاجة ونحو ذلك من أوجه التشابه، إلا أن اعتراض موسى -عليه السلام-؛ لأنه كان يظن ذلك إحسانًا لأهل القرية الذين قابلوهم بالإساءة، وعدم الإكرام، فكان يرى أن من الحكمة المعاملة بالمثل، ولم يكن يعلم الحكمة الباطنة التي علمها الخضر، وهي أن الجدار كان لغلامين يتيمين تحته كنز لهما، وإقامة الجدار كانت لحفظ حق اليتيمين وليس مكافأة لأهل القرية، فحرم بذلك أهل القرية من أن يقع الكنز بأيديهم.
ولما لم يكن موسى -عليه السلام- يعلم الغيب، أو الحكمة الخفية في تلك الأحداث، خاطبه الخضر بقوله: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا [الكهف: 68]، فعدم الإحاطة بالخبر هنا يعني عدم معرفة الحكمة الباطنة وراء الأحداث.
قال ابن كثير في تفسيره: أي: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل، ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. اهـ.
ثم إن الإنسان بطبيعته قد لا يربط بين التجارب السابقة، والمواقف الجديدة إذا اختلف السياق، أو ظهرت الأمور بوجه مخالف لما اعتاده، أو كان الحدث تحت تأثير المفاجأة؛ فقدرة الإنسان على الربط بين الأحداث ليست دائمًا حاضرة، خاصة إذا كان الأمر متعلقًا بحكمة إلهية خفية لم يُطلع عليها بعد.
وأما الفائدة من تشابه القصتين: فهو التأكيد على محدودية علم الإنسان، فتشابه الأحداث يبرز أن الإنسان مهما بلغ من العلم والخبرة، يبقى علمه محدودًا أمام علم الله، وأن الحكمة قد تكون أعمق مما يظهر للعيان.
ومن الفوائد: التسليم لأقدار الله، والرضا بذلك، حتى وإن خفيت الحكمة، فكم من أمر ظاهره شر وباطنه خير.
ومن الفوائد أيضًا: التواضع، وأنه مهما أوتي الإنسان من علم، فهناك من هو أعلم منه، فموسى -عليه السلام- رغم كونه نبيًا، علّمه الله أن هناك من هو أعلم منه في بعض الأمور.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

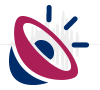
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات