
قتل ودمار وغاراتٌ وحروب، أريقت فيها الدماء، وأُزهقت لأجلها الأرواح، مؤامرات وخيانات تبدو على صفحات التاريخ كنقاطٍ سود تذمّ أصحابها أينما كانوا، وما أقدموا على فعلتهم المشينة -على الرغم من يقينهم بسوء العاقبة- إلا لسُكرهم بخمرة المال، ولأجله: باع الأخ أخاه، والرفيق رفيقه، واختلس الناس ما لا يحقّ لهم، والمرجع في ذلك كلّه: الفتنة بالمال.
إن حب الناس للدنيا قديم، وتعلّقهم بالمال وشغفهم به لا يُوصف، وقد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه في معرض الذمّ فقال: {وتأكلون التراث أكلا لمّا * وتحبّون المال حبّاً جمّاً} (الفجر:19-20)، ومثّل له النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) متفق عليه، فلا يزال الإنسان حريصاً على المال لاهثاً وراءه، مستكثراً منه، جمّاعاً له، حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره.
وثمّة حادثةٌ مستقبليّة بيّن القرآن الكريم نتائجها، ومرجع ذلك إلى العلم التامّ بطبيعة الإنسان ورغبته في الإخلاد إلى الأرض، ونقصد تحديداً قول الله تعالى مبيّناً عمق افتتان الناس بالدنيا: { ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون* ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون*وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين} (الزخرف:33-35)، فالآية تدلّ أنه لولا الخوف على الناس من الفتنة في الدين لأمد الكفّار بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، إذ لا تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة، فكان المنع حمايةً للعباد من هذه الفتنة المتوقّعة.
فلنربط هذه الآيات السابقة بالحادثة المذكورة في الصحيحين، والتي تتحدّث عن انحسار الفرات عن جبلٍ كامل من الذهب في آخر الزمان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة، تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: لا يزال الناس مختلفةً أعناقهم في طلب الدنيا، قلت: أجل؛ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبنّ به كله، فيقتتلون عليه، فيُقتل من كل مائة تسعة وتسعون) رواه مسلم.
إنها الفتنة التي تتضاءل عندها فتنة الناس بمال قارون الذي كان ولا يزال مضرباً للمثل في الطغيان المالي الذي بلغ حدّه ومنتهاه، والذي جاء وصفه القرآني في غاية البلاغة والدّقة، قال تعالى: { وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة} (القصص:76)، وتنطق أفواه المساكين حسرةً وطمعاً فتقول: { قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم} (القصص:79)، لكنّ فتنة نهر الفرات تفوق نتائجُها ما حصل بسبب الثروة القارونيّة، فإن الأحاديث تتكلّم عن ثروةٍ طائلةٍ تفوق الخيال، ويمكن لصاحبها أن يتربّع عرش العالم بلا منازع، فتدين له الأمم، ويمكنه من خلال تلك الثروة أن يتحصّل على لذائذ الحياة الدنيا بجميع أشكالها.
والآن يحسن بنا استجلاء بعض ما تضمّنته تلك الأحاديث، ونبدأ ببيان النهر المشار إليه وهو الفرات، ويقع شمال شبه الجزيرة العربية، فإنه ينبع من جبال طوروس في تركيا وتجري مياهه حتى تصبّ في شطّ العرب، وهو في أيّامنا هذه لا يزال معطاءً ومصدراً للخيرات كما كان في السابق، وسيظلّ كذلك حتى ينحسر عن جبلٍ من الذهب كما أخبر الصادق المصدوق.
وعن معنى الانحسار ومقصوده، ذكر العلماء في ذلك أن الفرات يغور ماؤه لينكشف عن الذهب، يقول النووي: " أي ينكشف لذهاب مائه".
وقد جاءت الروايات تصف الذهب مرّة بأنّه "كنز"، ومرّة بأنّه "جبل"، ووصف النبي –صلى الله عليه وسلم- له بأنّه كنز باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته لا باعتبار حقيقته، كما يقول الحافظ ابن حجر.
وعندما تقع هذه الفتنة، ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم، سيتقاطرون من كلّ جانب، في سباقٍ محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم على الجبل الذهبي كما يتهافت الذباب على الحلوى، وبعد ذلك: تحدث المجزرة الكبرى التي أخبر عنها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بحيث يُقتل من كلّ مائة تسعة وتسعين، أو من كلّ عشرة واحداً –كما جاء في رواياتٍ خارج الصحيحين-، والمحصّلة: ندرة المتبقّين بعد تلك المقتلة.
وفي قول النبي –صلى الله عليه وسلم- حكايةً عن المتقاتلين: (ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو) لفتةٌ تدلّ على عظم هذه الفتنة، والغشاوة التي تغشى عقول هؤلاء بحيث ينسون أن بغيتهم ومطلبهم باهظ الثمن، قد يكون مقابله بذل المُهج والأرواح، وأن فرصة النجاة ضئيلة، ولكنّه الطمع الذي لا ينتهي.
يقول الطيبي: " فيه كناية ; لأن الأصل أن يقال: أنا الذي أفوز به، فعدل إلى أنجو ; لأنه إذا نجا من القتل تفرّد بالمال وملكه".
ثم يأتي الحديث عن النهي النبوي المذكور: (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) والسرّ في ذلك كما يذكر الشرّاح أن النهي متعلّقٌ بالآثار المترتّبة عليه وليس لذاته، ولما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، فهو من باب سدّ الذريعة، وإلا فإن أصل المال طيّب.
ومنشأ هذه الفتنة المستقبليّة التي لم نرها حتى الآن: الاغترار بالدنيا وزخرفها، والحرص على جعل اللذائذ الفانية واعتبارها غاية المراد ومنتهى المطلب، وهو الأمر الذي حذّر منه النبي –صلى الله عليه وسلم- في أكثر من مناسبة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) رواه أحمد والترمذي، وعن كعب بن عياض رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) رواه الترمذي في سننه.
بقي أن نُشير إلى مسألةٍ نجدها في الكتب المعاصرة، وهي محاولة تفسير جبل الذهب بالبترول، باعتبار أن الاقتصادات العالميّة تسميّه الذهب الأسود، ولا شكّ في اعتلال هذا المسلك الأعوج في تأويل النبوءات قبل وقوعها وإخراج الألفاظ عن مدلولاتها، وهو ما يُشير بجلاء إلى خضوع الفكر لسطوة المفاهيم الماديّة، والحقّ أن نقول: لن نعلم حقيقة هذا الإخبار الغيبيّ وكيفيّته إلا بعد وقوعه، ممتثلين في ذلك بالأمر الربّاني:{ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب} (آل عمران:7).



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج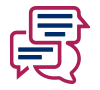 استشارات الحج
استشارات الحج

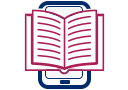












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات