
تعرّضنا في جزء سابق للفرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضيّ، وكيف ضلّت القدريّة حينما أخرجوا وقوع المعاصي من جملة القضاء والقدر، وقولهم في ذلك: "ليست المعاصي مما يقدّره الله عزّ وجل"، فأنكروا تعلّق القضاء والقدر بهما.
كذلك ذكرنا ضلال غلاة الجهميّة حينما جعلوا تقدير وقوع المعاصي بقضاء الله وقدره يترتّب عليه الرضا بتلك المعاصي ومحبّتها، فخالفوا في مراضي الله ومساخطه، وخرجوا عن شرعه ودينه.
بعد تأسيس ما سبق، ننتقل إلى الحديث عن مسألةٍ عقديّةٍ أخرى لا تقل أهميّة، ويكثر تنالوها في الكتب التي تُعني بمباحث العقيدة، ألا وهي مسألة بيان حكم الرضا بالقضاء، وحكم الرضا بالمقضيّ على العباد، وما هو كلام العلماء فيهما؟
أما شيخ الإسلام ابن تيميّة، فقد فصّل في حكم الرضا بالقضاء إلى قسمين: قضاءٌ شرعيّ، وقضاءٌ كوني، يقول شيخ الإسلام ما نصّه: "والقضاء نوعان: ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به، كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله، وإن كانت بقضائه وقدره".
وعلى أية حال، يمكننا تناول المسألة كالآتي:
أولاً: الرضا بالقضاء: من حيث أن القضاء هو فعلٌ لله سبحانه وتعالى، فيلزم العبد الرضا به وتقبّله، ويحرم عليه فعل ضدّه من التسخّط والبغض لقضائه وقدره، وهذه المسألة مجمعٌ عليها من هذه الناحية، ووجه ذلك أن القضاء هنا متعلّقٌ بفعل الرب تبارك وتعالى، والرضا به من مقتضيات محبّة العبد لربّه ولأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا لازم على المكلّف حتى لو تعلّق ذلك القضاء بأمرٍ يكرهه ولا يُحبّه، فالقضاء كفعلٍ إلهيّ هو مرتبطٌ بحكمة الله البالغة فيما يفعله ويُقدرّه: {وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم} (آل عمران:62)، وهو سبحانه الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره.
وعلم الله كامل وشامل لأنه سبحانه واسع العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، بخلاف علم العبد فإنه محصورٌ وقاصر، فلا تتضح له جميع أبعاد تلك التقديرات الإلهيّة حتى يُدرك وجه الحكمة فيها، ويعلم كيف صار ذلك القضاء الإلهي: "وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها" كما هو معلومٌ من تعريف الحكمة.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الجلال والجمال كلّها، وتنزّه عن المعايب والنقائص؛ لأنه القدّوس المعظم والمنزه عن صفات النقص كلها وعن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، وهو سبحانه السلام، وهو السالم من النقصان، ومن كل ما ينافي كماله سبحانه، فلذلك فإن قضاءه هو عين الكمال فيجب الرضا به.
وفي تقرير هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله، كعلمه وكتابته، وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله عز وجل ربّاً وإلهاً، ومالكاً ومدبّراً".
وأما الرضا بالمقضيّ، وهو النتيجة الحاصلة من الفعل الإلهي، فحكم الرضا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: أمورٌ يجب الرضا بها، وهو يشمل كلّ ما أوجبه الله تعالى على عباده، فالواجبات الشرعيّة كالصلاة والزكاة والحج، والأمر بالمعروف وإقامة شرع الله، كلّها أمور ارتضاها الله سبحانه وتعالى فيجب الرضا بها، قال سبحانه: { ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون } (التوبة:59)، وفي سورة النور: { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم} (النور:55) .
القسم الثاني: أمورٌ يحرم الرضا بها، وهي كلّ الأمور التي حرّمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها، كشرب الخمر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وظلم العباد والجور عليهم، واغتصاب الحقوق، وغيرها من الذنوب والمعاصي، فإننا نُبغضها لبُغض الله تعالى لها شرعاً، وربنا لا يرضى من عباده المعاصي فكذلك العباد لا يرضونها، قال سبحانه: { والله لا يحب الفساد} (البقرة:205)، وقال تعالى: { يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} (النساء: 108)، وفي الزمر: { ولا يرضى لعباده الكفر} (الزمر:7).
القسم الثالث: أمورٌ يُستحب الرضا بها، وهي كلّ ما يقع على الإنسان من المصائب والبلايا، كالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها، فصحيحٌ أن الصبر واجبٌ عند حلول تلك المصائب، إلا أن الرضا بالمقضيّ أمرٌ آخر تماماً.
ولا يمكن أن نُوجب على العباد الرضا بما تحدث لهم من النكبات والمًلمّات، بل هو فضيلةٌ يحبّها الله من عباده وليست بواجبةٍ عليهم، وقد علّل العلماء ذلك بأن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياً، ولا دليل يدل على الوجوب، وإنما الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات، وقد رأينا في سيرة النبي –صلى الله عليه وسلم- كيف حزن لموت ولده إبراهيم وزوجته خديجة، ولمقالة السوء التي أشاعها المنافقون في حق عائشة رضي الله عنها، فالأنبياء بشرٌ طباعهم تتألم وتتوجع من المؤلمات، وتسرّ بالمسرات، ومن دون الأنبياء من باب أولى، مما يدلّ على أن المقضيّ من المصائب ليس بواجب على العباد.
يقول القرافي: " إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضيّ، ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات الحوادث، ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه، ولم يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤلم ولا غيره من المرض، بل ذم الله قوماً لا يتألمون ولا يجدون للبأساء وقعاً فذمهم بقوله تعالى: {ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون} (المؤمنون:76)".
ونختم بمسألة أخيرة: كيف يُقدّر الله كوناً ما يُبغضه شرعاً؟ والجواب الصحيح أن يُقال أن الله سبحانه وتعالى قد قدّر كلّ شيء -بما في ذلك المعاصي- لما له في ذلك من الحكمة، فإذا كان الإنسان قد يفعل ما يكرهه كشرب الدواء الكريه لما فيه من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية، فشرب الدواء مكروه من جهة، محبوب من جهةٍ أخرى، فلذلك فإن العبد يوافق ربه فيكره الذنوب ويمقتها ويبغضها; لأن الله يبغضها ويمقتها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية; لأجل الحكمة المترتّبة عليها.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج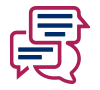 استشارات الحج
استشارات الحج

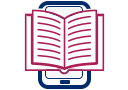












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات