
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك، فما من أحدٍ يدعي العلم بصناعةٍ أو مقالةٍ إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة، وكذلك من أظهر قصدًا وعملًا كمن يُظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوهٍ متعددة، والنبوة مشتملة على علومٍ وأعمالٍ لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟!! ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوهٍ كثيرة؟!! لا سيما والعالم لا يخلو من آثار نبيٍّ من لدن آدم إلى زماننا، وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه، ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل.
فلو قُدر أن رجلًا جاء في زمان إمكان بعث الرسل، وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب، ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر، هل كان مثل هذا يحتاج أن يُطالَب بمعجزة ؟! أو يشك في كذبه أنه نبي؟!
ولو قدّر أنه أتى بما يظن أنه معجزة، لعُلِم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة؛ ولهذا لما كان الدجال يدعي الإلهية لم يكن ما يأتي به دالًّا على صدقه، للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها، وإنه كذاب.
وكذلك من نشأ في بني إسرائيل معروفًا بينهم بالصدق والبر والتقوى، بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودينه، ثم أخبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم، فإن هذا لا يكون أولى بالرد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه أنه رأى رؤيا.
وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم، ولا ريب أن المحققين من كل طائفةٍ على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه الضروري بخبر المخبر، بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضاء الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها.
كما قال تعالى: {ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم} ، ثم قال: {ولتعرفنهم في لحن القول} (محمد:30)، فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلّق معرفتهم بالسيما على المشيئة، لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات وجهه، وقد قيل: "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه"، فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار، فإذا اقترن بذلك إخباره كان أولى بحصول العلم، ولا يقول عاقل من العقلاء إن مجرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يفيد العلم، بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة، بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين.
وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه، فكيف بدعوى المدعي إنه رسول الله؟! كيف يخفي صدقه وكذبه؟! أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى؟!
وإذا كان الكاذب إنما يأتي من وجهين : إما أن يتعمد الكذب، وإما أن يُلبَّس عليه كمن يأتيه الشيطان، فمن المعلوم الذي لا ريب فيه إن من الناس من يُعلم منه إنه لا يتعمد الكذب، بل كثير ممن خبره الناس وجربوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علمًا قاطعًا إنهم لا يتعمدون الكذب، وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكن، فليس كل ما علم إمكانه جُوِّزَ وقوعه، فإنا نعلم أن الله قادرٌ على قلب الجبال ياقوتًا والبحار دمًا، ونعلم إنه لا يفعل ذلك، ونعلم من حال البشر من حيث الجملة إنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانيا ونحو ذلك، ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من أشخاص وإن من أخبرنا بوقوعه منهم كذبناه قطعًا، ونحن لا ننكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمد الكذب بعد أن لم يكن كذلك، لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره .
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي -صلى الله عليه وسلم -إنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: (إني قد خشيت على عقلي)، فقالت: "كلا !! والله لا يخزيك الله ! إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتُكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق"، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فإنه يعلم من نفسه - -صلى الله عليه وسلم -- إنه لم يكذب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولًا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال، وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق، ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه الله، وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان، وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه.
وأيضًا : فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام، فإنه كان نبيًّا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار، وقد عُلم جنس ما يدعو إليه الرسول، وجنس أحوالهم، فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم، وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل علم إنه منهم، لا سيما إذا علم أنه لا بد من رسول منتظر، وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه، فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر، ولهذا قال تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} (البقرة:146).
والمسلك الأول النوعي هو:
مما استدل به النجاشي على نبوته، فإنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤوه عليه قال: "إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة".
وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم -بما رآه، وكان ورقة قد تنصر، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له خديجة: "يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك ما يقول!"، فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم -بخبره، فقال: "هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وإن قومك سيخرجونك"، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -:(أو مُخرِجيّ هم؟!)، فقال "نعم! لم يأت أحدٌ بمثل ما جئت به إلا عُودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا"، ثم لم ينشب ورقة أن توفي.
والمسلك الثاني الشخصي :
استدل به هرقل ملك الروم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم -لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام، طلب هرقل من كان هنا من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفةٍ من قريشٍ في تجارةٍ إلى غزة، فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصار يجدهم موافقين له في الأخبار.
فسألهم : هل كان في آبائه ملك ؟! قالوا : لا .
وهل قال هذا القول أحدٌ قبله ؟! قالوا : لا .
وسألهم : أهو ذو نسبٍ فيكم ؟! قالوا : نعم.
وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟! فقالوا : لا جربنا عليه كذبًا.
وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟! فذكروا : أن الضعفاء اتبعوه.
وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون ؟! فذكروا : إنهم يزيدون .
وسألهم : هل يرجع أحدٌ منهم عن دينه سخطةً لـه بعد أن يدخل فيه ؟! فقالوا : لا .
وسألهم : هل قاتلتموه ؟! قالوا : نعم .
وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا : يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى.
وسألهم : هل يغدر!؟ فذكروا : أنه لا يغدر.
وسألهم : بماذا يأمركم ؟! فقالوا : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
فهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الدلالة، وإنه سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته، فرآها منتفية، وسألهم عن علامات الصدق، فوجدها ثابتة.
فسألهم : هل كان في آبائه ملك ؟! فقالوا : لا .
قال : قلت فلو كان في آبائه ملك، لقلت رجلٌ يطلب ملك أبيه.
وسألتكَ : هل قال هذا القول فيكم أحدٌ قبله؟! فقلتَ : لا.
فقلتُ : لو قال هذا القول أحدٌ قبله، لقلت رجلٌ ائتم بقول قيل قبله.
ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتدائه بمن كان قبله كثيرًا ما يكون في الآدميين، بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله، وطلب أمرٍ لا يناسب حال أهل بيته فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع، ولهذا أردفه بقوله :
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟! فقالوا :لا.
قال : فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذب على الله.
وذلك أن مثل هذا يكون كذبًا محضًا يكذبه لغير عادةٍ جرت، وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب، فإذا لم يكن من خلقه الكذب قط بل لم يعرف منه إلا الصدق وهو يتورع أن يكذب على الناس كان تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق، والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه، فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق .
ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق فقال :
وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟! فقلتم : ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل.
قال فهذه علامة من علامات الرسل، وهو اتباع الضعفاء له ابتداء، قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: { قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون} (الشعراء:111)، وقالوا: { وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي} (هود:27)، وقال تعالى في قصة صالح عليه السلام: {قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون* قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون} (الأعراف:75-76).
ثم قال هرقل : وسألتكم أيزيدون أم ينقصون ؟! فقلتم : بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم.
وسألتكم : هل يرتد أحدٌ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟! فقلتم : لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم على اتباعه، فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون، وهذا من علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبىء الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة، وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم، حيث رأى رجلًا يسب النبي -صلى الله عليه وسلم -من رؤوس النصارى، ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبىء الكذاب، كم تبقى نبوته فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء إن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، لمدة قريبة إما ثلاثين سنة أو نحوها، فقال لهم : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابًا ؟! ثم ضرب عنق ذلك الرجل.
وسألهم هرقل عن محاربته، فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلِب كما غلب يوم بدر وتارة يغلَب كما غلب يوم أحد، وإنه إذا عاهد لا يغدر، فقال لهم : وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟! فقلتم إنها دوال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها، قال : وسألتكم هل يغدر؟! فقلتم : إنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر.
فهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله، فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون، علم أن هذا من علامات الرسل.
فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء:
لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال (والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا لـه، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له).
والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أُحد من الحكمة، فقال: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين} (آل عمران: 139-140) فمن الحكم تمييز المؤمن عن غيره، فإنهم إذا كانوا دائمًا منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم، إذ الجميع يظهرون الموالاة فإذا غُلبوا ظهر عدوهم، قال تعالى: {وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين* وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون} (آل عمران:166-167)، وقال تعالى: {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب} (آل عمران:179) وأمثال ذلك.
ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء، فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة، ولا بد من الموت، فموت العبد شهيدًا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه والله لا يحب الظالمين.
ومن ذلك : أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب، فإنهم إذا انتصروا دائمًا حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة والهوان، قال تعالى: { ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} (آل عمران:178)، وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة)، وسئل -صلى الله عليه وسلم -"أي الناس أشد بلاء؟!" فقال (الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وقد قال تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب} (البقرة:214)، وقال تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين} (آل عمران:142)، وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى: ( يا ابن آدم !! البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك )، وفي الأثر أيضًا إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله: (كيف أرحمه من شيء به أرحمه).
وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله، وذل وتاب إلى الله من الذنوب، وطلب النصر من الله، وبرىء من حوله وقوته متوكلًا على الله، ولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال:{ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون} (آل عمران:123) وقال تعالى: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين} (التوبة:25) وشواهد هذا الأصل كثيرة، وهو أمر يجده الناس بقلوبهم ويحسونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم وهو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها والأخبار المتواترة لمن سمعها.
ثم ذكر حكمة أخرى فقال {وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين} (آل عمران:141) وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم، والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا، فإذا لم تبق لـه حسنة عاقبه بكفره، والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المحق، ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به.
وأما الغدر :
فإن الرسل لا تغدر أصلا، إذ الغدر قرين الكذب، كما في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، وفي الصحيحين أيضا عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: (أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر).
قلت : الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين* فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون* فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} (التوبة:75-77)، فالغدر يتضمن كذبًا في المستقبل، والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن ذلك فكان هذا من العلامات.
قال وسألتك : بم يأمركم ؟! فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيًّا يُبعث، ولم أكن أظن أنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما يقول حقًّا فسيملك موضع قدمي هاتين.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر، من أشد الناس بغضًا وعداوةً للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: ( فقلت لأصحابي ونحن خروج : لقد أَمِر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنًا بأن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره) .
قلت فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علمًا جازمًا بأن هذا هو النبي الذي ينتظره .
وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالماوردي ونحوه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة وإنما تعلم بالمعجزة، وليس الأمر على ما قال، بل كل عاقلٍ سليمُ الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب، وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل كل ما يحصل للإنسان من شبعٍ وريٍّ وسكرٍ وفرحٍ وغمٍّ بأمورٍ مجتمعةٍ لا يحصل ببعضها، لكن بعضها قد يحصل بعض العلم، وكذلك العلم بمجرد الأخبار وبما جربه من المجربات وبما في نفس الإنسان من الأمور، فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم، حتى يتزايد فيقوى، وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما يراه من أحوال الشخص، وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه.) انتهى من شرح العقيدة الأصفهانية.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج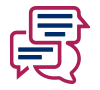 استشارات الحج
استشارات الحج

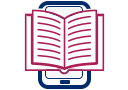












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات