
تُعد هذه الفترة - فترة الحرب على الإرهاب - التي تمر بها أمتنا فترة تاريخية حاسمة، وهي حقبة جديرة بالدراسة المتأنية، من حيث حقيقتها، وأسبابها، ومآلاتها، بل يمكن وصفها فعلاَ بأنها فترة إعادة التشكّل، أو أعادة بناء العلاقات الاجتماعية والدولية من جديد، وهي بهذا المعنى يمكن أن تكون من أهم فترات تاريخنا الطويل، وأن نجعلها بداية يقظة إسلامية حقيقية، أو إرساء أسس لنهضة إسلامية فاعلة، إن أردنا ذلك.
نعم، يمكن لمفكري هذه الأمة - إن أرادوا - أن يوجهوا أحداث هذه الفترة إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وذلك من خلال محاولتهم الحقيقية لإعادة سؤددها، ولا يتم ذلك إلا أن ينطلق أصحاب القرار فيها، والنخب الثقافية والفكرية من علمائها ومفكريها في دراسة هذه الفترة من النواحي الفكرية والثقافية، التي من خلالها فقط تحدد مسارات الأمم في ميادين الحياة المختلفة.
الكل يعلم أن الدول العربية قد نالت استقلالها منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن، والكل كان يظن أو يرى أن ذلك الاستقلال الذي نالته الدول العربية لم يكن منة من أحد، وأن الشعوب العربية قد طردت الاستعمار الذي جثم على صدرها لفترة طويلة من الزمن، وظنت شعوب الأرض أن الأمة العربية كانت رائدة لكل ثورات التحرر في هذا المضمار.
ولكن المؤسف حقاً أن نعلم أن ذلك الاستقلال لم يكن إلا صورياً وليس حقيقياً، وأن معنى الدولة العميقة - التي نسمع صداها كثيراً في أيامنا هذه - تمتد جذورها إلى ذلك الزمان وأبعد، وأن ما تم فعلاً في بعض الدول العربية أو أكثرها ما هو إلا صورة من صور التحرر، وهي أن يخرج الاستعمار بثوبه ولونه، ويُبقي من أبناء الوطن من ينوب عنه في مهماته وأدواته، وهذا ما حصل فعلاً، فالسلطة تحررت من أشكال الاستعمار، ولكن الشعوب بقيت ترزخ تحت وطأة ذلك الاستعمار، ثم من ينوب عنه.
وساعد في ذلك أن الأمة في ذلك الوقت لم تكن أمة واحدة، أو مجتمعاً واحداً، بل كانت منقسمة أو متشرذمة إلى عدة مجتمعات، وأن الذين تصدروا قيادة الثورات في ذلك الزمان كانوا ينضوون تحت فئتين متباينتين في التفكير، لم تكن أياً من تلك الفئتين على دراية بحقيقة ما يجري على أرض الواقع حتى لو ادعى بعضهم ذلك، ولم تكن أي منهما على وعي لما عند الفئة الأخرى على الأقل، ولم تكن أي من تلك الفئتين على فهم لحقيقة الإسلام وكيف ينبغي أن يتعامل في مثل هذه الظروف، وماذا يريد الإسلام من أتباعه في مثل هذه المواقف.
كانت الفئة الأولى من أولئك الذين بهرتهم الحضارة الغربية؛ بتقدمها العلمي والمادي من حيث قوتها، وتسهيلها لجميع وسائل الاتصال والتقدم، وبراعتها في شؤون الصناعة وغيرها، وساهم في ذلك الانبهار جهل هذه الفئة بحقيقة الإسلام، وظنهم أن الإسلام لا يملك تصوراً أو أنظمة قادرة على التعامل في مثل هذه الظروف والأجواء، أو أن النظام الإسلامي لا يمكنه أن يصل إلى مثل هذا المستوى من النهوض الحضاري، مما جعلهم يرتمون في أحضان تلك الحضارة، ويرون أن الحل المطلوب للخروج بأمتهم مما هي فيه يكمن فقط في ثنايا هذه الحضارة، ولا يتحقق إلا بانسلاخهم من تعاليم الإسلام وقيمه، فتم ذلك بوعي أو بدون وعي منهم بمآلات مثل هذا الأمر.
أما الفئة الثانية فهي التي تتمثل في التيارات الإسلامية بأنواعها، التي كانت تدّعي فهم الإسلام، ولكنها لم تستطع أن تكون فاعلة في قيادة شعوبها أو نيل ثقتها، ولعل وقوف السلطات في وجهها بكل قوة ساهم في انحسار هذه الحركات وبُعدها عن دفة القيادة والتوجيه، فلم تستطع هذه الحركات بأنواعها وأطيافها – بسبب أو بآخر- أن تحوّل الإسلام إلى روح جديدة تسري في كيان هذه الأمة الناهضة، فتحييهم بالقرآن والسنة النبوية الصحيحة، إنما كان جل اعتماد كثير منهم على فهوم ما كتبه العلماء في العصور المختلفة عبر تاريخنا الطويل، مما كان يعكس ظروف ذلك الزمان وملابساته، والذي فيه ما فيه من التحريف التطبيقي لتعاليم الإسلام على مر العصور.
وبسبب هذا الانقسام والتنازع حول قيادة دفة الأمة، وبسبب الدعم الخارجي المرسوم لفئة من هاتين الفئتين دون الأخرى وقعت الأمة العربية والإسلامية فيما نحن فيه من المصائب والمحن، والتي كان من أشدها وأعمقها المحنة الفكرية والثقافية، التي تمثلت في الاستبداد السياسي والانغلاق الثقافي، مما أفقد هذه الأمة شخصيتها ومميزاتها، وأدخلها في متاهات مظلمة، فأصبحت تبعاً وذيلاً لغيرها من للأمم، بعد أن كانت رائدة وقائدة لكل الأمم الأخرى.
إن قابلية الاستعمار- كما يسميها مالك بن نبي - التي يتمتع بها الكثيرون من أبناء أمتنا هي من أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ذلك أن بعض أصحاب النفوس الصغيرة، وجدوا أن أسهل الطرق لوصولهم إلى السلطة هو أن يضعوا أيديهم في أيدي أولئك المستعمرين، الذين خرجوا من الديار بعد أن بحثوا عن من ينوب عنهم من أبناء الوطن، فانتدب هؤلاء الصغار أنفسهم وقاموا بالمهة، واتبعوا الوسائل والأساليب التي رُسمت لهم في كيفية تعاملهم مع أبناء جلدتهم، وقاموا بالواجب خير قيام، وظنوا أو روجوا بأن هذا الذي جرى هو تحرر أو استقلال، حتى وصلت أمتنا إلى ما هي عليه الآن... ولا شك أن الكلام في هذا المعنى يطول، بل ويصعب حصره في مقال أو مقالات.....
لقد تعرضت أمتنا وما زالت تتعرض في أيامنا هذه إلى كافة أنواع الغزو والتشويه، حيث رماها أعداؤها بكل سهام الغدر، وقد اجتمعوا في صعيد واحد كاجتماع الأكلة على قصعتها، ورموها عن قوس واحدة، وحاربوها بكل أنواع الأسلحة، المادية والمعنوية، أسلحة استهدفت الدين والعقل والثقافة، قبل أن تستهدف الأجساد والأبدان.
ولكن الأدهى والأمر في كل ما نراه ونعاينه، أن ما يحدث الآن يحدث بالرضا والقبول من كثير من أبناء هذه الأمة، أو على الأقل من أصحاب القرار فيها، ويجري التخطيط في ذلك بين الدول العربية والغربية على حد سواء، وكأن العالم كله يعيش في أمن وأمان، إلا هذه البقعة التي تُسمى الوطن العربي، وكأن كل أطياف البشر مسالمون أو حمائم سلام إلا هذا النوع من الجنس البشري الذي يسمى (عربي ) فهو وحده الإرهابي..... فحسبنا الله ونعم الوكيل.
كتب المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي مقالاً وصف فيه السلطة الفلسطينية وهي توقع على اتفاق أوسلو عام 1994م، سماه (ضحايا موافقون) وهو ما ينطبق على أمتنا الإسلامية والعربية في أيامنا هذه، حيث اتفق العرب مع كل الدول على ضرورة محاربة الإرهاب، فانطلقت الطائرات من الأراضي العربية لتقصف أجزاء أخرى منها، تحت ما يسمى (محاربة الأرهاب) ذلك الجسم أو الشبح الغريب الذي لا يمكن توصيفه، بحجة أن من هم فيها هم إرهابيون يقتلون البشر، بينما رأى الجميع ما فعلته إسرائيل في غزة من قتل ودمار ولم يسموه إرهاباً، وهم يشاهدون في كل يوم ما يفعله بشار الأسد من إلقاء البراميل المتفجرة على القرى والمدن السورية ولم يسموا عمله هذا إرهاباً، ويرون في كل يوم ما يفعله غير المسلمين في العالم من قتل ودمار، ولكنه كله ليس إرهاباً، ولم نسمع أحداً يصف مثل هذه الأعمال بالإرهاب، وكأن وصف الإرهاب أصبح حكراً على أهل السنة دون غيرهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
من هنا أقول: إن مهمة هذه الأمة كبيرة عظيمة، بل إن مهمة العلماء والمفكرين في هذه الأمة كبيرة، وإن على قادة هذه الأمة أن تعي الكثير والكثير، ولعل من أهم الأمور التي يجب أن نعيها جميعاً، أننا أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير هذا الدين أذلنا الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليها أن تكون أقوى وأعلم بما يجب عليها في مثل هذه الأحوال، فهذه الأمة هي الوحيدة من بين جميع الأمم التي تملك إمكانية قيادة البشرية إلى دفة النجاة، وهي الأمة الوحيدة القادرة على إحداث نهضة إنسانية حقيقية، تقوم على تعاليم الإسلام، وتملك الخارطة الصحيحة.
ولكن السؤال الكبير الذي لا يمكن أن نتخطاه، بل ولا يمكن أن تغادر هذه الأسئلة أقلام كل المفكرين المخلصين في كل زمان ومكان، والتي من أهمها: كيف يمكن الخلاص مما نحن فيه؟ ومن أين نبدأ؟ وإلى أين نتجه؟ وما هي الوسائل والأساليب التي ينبغي أن نتبعها؟ وكيف يمكن لهذه الأمة أن تعود إلى ما ينبغي أن تكون عليه؟ وكيف يمكن للفكر الإسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي أن يعود نموذجاً سليماً يحمل الصورة المشرقة التي يطلبها الناس ويشعرون أنها تحمل الحل الذي يحتاجون وتمثله؟
إن التدافع الحضاري سنة من سنن الحياة، وهو أمر ضروري لتطور الحياة واستمرار التاريخ، قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة: 251] فهل آن لهذه الأمة بعد كل ما مضى، وبعد كل ما يجري أن تعيد الثقة في هويتها وتراثها، وأن تعيد النظر والمراجعة لكافة المواقف والمجالات، والتي من أهمها ما يتعلق بالقضايا الفكرية والثقافية، وأن تتلمس لها مخرجاً من هذا الفكر الإرهابي الذي نُسب إليها، وأن تتلمس كذلك مخرجاً للإنسانية لتخرجها من المأزق التي تاهت وتتيه فيه، وأن تعيد هذه الحضارة إلى مسارها الذي ينبغي أن تكون عليه، وذلك بأن تكون في صالح الإنسان والإنسانية جميعاً، لا أن تعمل من أجل فئة أو مجموعة منهم، ولا يتم ذلك إلا بعد أن تعود الراية إلى الأمة الإسلامية العظيمة، وأن تنتزعها من يد أولئك البغاة العتاة أعداء الإنسانية، وتقودها باسم الإسلام الحق وعدالته، التي أرادها الله تعالى، والتي هي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: أما آن الأوان بعد كل هذا التيه، أن تقوم الأمة الإسلامية بواجبها، وأن يحمل قادتها هذه الراية، ويرفعوا قناديل الهداية، لإنقاذ الإنسانية من دياجير هذه الجاهلية، كما أنقذتها من الجاهلية الأولى، أما آن الأوان لهذه الأمة التي وصفها الله تعالى بقوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران: 110] وقوله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) [البقرة: 143] أن تعود إلى ما يجب أن تكون عليه.، نأمل ذلك، وما ذلك على الله بعزيز.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج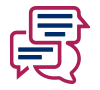 استشارات الحج
استشارات الحج

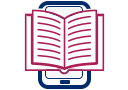












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات