
السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لهذا الدين، وهي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تدل على تطبيقه لهذا الإسلام، والمفسرة لهذا القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]، والسيرة النبوية هي التي تفتح لنا الأبواب لتطلعنا على حياته صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها، منذ ولادته وحتى وفاته، وهي المبينة والمفسرة للقرآن الكريم، من الجانب العملي، وهي بهذا المعنى تساعد على فهم كتاب الله تعالى؛ لأن فيها أسباب النزول، ومن خلالها يمكننا تفسير الكثير من الآيات، يقول الدكتور عماد الدين خليل: "إن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم تجربة غنية بأحداثها، زاخرة بدلالاتها، متنوعة بمعطياتها، وما كان لباحث يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل إلا أن يوسع نطاق رؤياه ويصب اهتماماته على هذه الجوانب جميعاً: حركة سياسية وعسكرية وشخصية وفقهية وروحية وواقعية وغيبية وعقيدية وحضارية".
مصادر السيرة
المصدر الأول للسيرة هو القرآن الكريم، الذي اشتمل على الكثير من الأحداث في العهد المكي والعهد المدني، والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال حديثه عن بعض الغزوات وما جرى فيها كغزوة الخندق وغيرها، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً * إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً} [الأحزاب:9- 11].
ومن المصادر كذلك كتب السنة والأحاديث النبوية الشريفة، التي تتحدث عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أو صفاته الخلقية والخُلقية، والتي تحوي الكثير والكثير من أحداث السيرة العطرة، كأبواب الجهاد والسير، أو المغازي، التي تسرد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة والأذى الذي لحق به صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وتتحدث عن الغزوات والسرايا وغيرها.
ومن المصادر أيضاً كتب الشمائل، التي تضمنت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وصفاته وعاداته وفضائله، وأشهر كتب الشمائل كتاب "الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي، ثم كتب السيرة والتاريخ، حيث صنف بعض المؤلفين والمؤرخين كتباً مستقلةً، جمعت أحداث السيرة وغزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعوثه وسراياه، وما جرى معه صلى الله عليه وسلم من أحداث خلال مراحل دعوته وحياته.
ويعد من أوائل من اهتم بكتابة السيرة النبوية من الرواة: عروة بن الزبير (ت94هـ) وأبان بن عثمان (ت105هـ) ووهب بن منبه (ت110هـ) ومحمد بن شهاب الزهري (ت 124هـ) وعاصم بن عمر بن قتادة (ت130هـ) ثم موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق حيث كتب كتابه في السيرة، التي رواها وهذبها ابن هشام، وأصبحت تعرف بسيرة ابن هشام. وكذلك كتب الواقدي كتابه في السيرة المعروف (بمغازي الواقدي). وهناك من المؤلفين الذين كتبوا في هذا الفن، مما لا يتسع المجال لحصرهم وذكرهم.
ولا شك أن أي كتاب من هذه الكتب ما كان ليغني عن بقية الكتب، ومن هنا فإن جميع هذه المراجع والمصادر لدراسة السيرة جاءت لترسم لنا صورة حية واقعية لما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات جليلة، وخصال حميدة، لتكون لنا نبراساً ونوراً نقتدي به؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا جميعاً. ولا شك، فإن دراسة السيرة النبوية هي جزء من دراسة السنة، فحياته صلى الله عليه وسلم كانت موجهة من الله تبارك وتعالى، والوحي يحكم على العقل، وليس العكس، ومن هنا فلا ينبغي أن لا نُخضع أحداث السيرة للعقل الإنساني، خصوصاً ما يتعلق بمسائل الوحي والعصمة.
ثم ينبغي أن تُدرس السيرة لاستنباط الأحكام، واستلهام الدروس والعبر، ومحاولة تطبيقها وربطها بالواقع، وليس الغرض من دراستها هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية، ولا سردها كما تسرد القصص والأحداث، ولا ينبغي أن تدرس السيرة كبقية الدراسات التاريخية؛ فالسيرة النبوية تشكل المحور الذي تدور عليه حركة التدوين لتأريخ الإسلام في الجزيرة العربية، بل هي العامل الذي أثر في أحداث الجزيرة، ثم أحداث سائر العالم الإسلامي ثانياً.
مناهج كتابة السيرة النبوية عند المسلمين
رغم أهمية السيرة النبوية، ورغم اهتمام كثير من المؤلفين والمؤرخين بها، إلا أن مناهجهم وطرقهم في كتابتها قد اختلفت، حيث لم يلتزم أصحابها منهجاً واحداً يسيرون عليه، إنما تعددت أساليبهم ومناهجهم، بحسب تخصص ومجال كل مؤلف منهم، فكان منهم من اعتمد المنهج السردي لأحداث السيرة، تساق فيه الروايات بتسلسل مترابط، وهذه الروايات لا تكون على درجة واحدة من صحة الإسناد، وكذلك لا تتضمن أي تحليل للأحداث لأخذ العبر منها، واستنباط ما يمكن استنباطه من حكم ودروس وعبر. وتعد كتابة عروة بن الزبير نموذجاً من هذا التأليف، حيث نقل السيرة النبوية المطهرة عن أبيه الزبير بن العوام، وعن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن غيرهما.
ومن المؤرخين من اعتمد المنهج التاريخي في كتابة السيرة والأحداث، وذلك بأن يكتب السيرة بأحداثها وترتيبها ترتيباً زمنياً بحسب وقوعها وتسلسلها الزمني، فيذكر أحداث السنة الأولى، ثم الثانية، وهكذا. ومن الذين نهجوا هذا النهج الإمام الطبري، وابن الأثير وغيرهما. ومنهم من اعتمد المنهج التحليلي، فكان لا يكتفي بسرد أحداث السيرة أو ترتيبها زمنياً، وإنما يغوص في نصوص الأحداث، يتأملها ويستلهم منها العبر والعظات والدروس، ويربطها بالواقع، ويوازن ويقارن ليصلح من حياة الناس بما يتوافق مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، استدلالاً بما يقال: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله)، وممن اعتمد هذا المنهج ابن قيم الجوزية في كتابه "زاد المعاد"، حيث يعرض نصوص السيرة ويوثقها، ثم يعقد فصلاً أو فصولاً لاستنباط الفوائد والأحكام من هذه النصوص والأحداث. ومنهم من اعتمد المنهج الموضوعي للسيرة، بأن يجمع المعلومات والأحداث المتعلقة بموضوع واحد، ليعطي فكرة متكاملة شاملة عن هذا الموضوع، كمن يأخذ مثلاً الجانب التربوي في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو الجانب العسكري، أو الجانب الاجتماعي، أو الجانب الفقهي، وغيره، ومن الأمثلة على هذا النوع من التأليف كتاب "الشمائل" للإمام الترمذي، وكتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض، وكتاب "الخصائص الكبرى" للسيوطي، وكتاب "فقه السيرة" للشيخ الغزالي، ومثله للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. وقد صُنفت كتب كثيرة، قديماً وحديثاً خاصة فيما يتعلق بالغزوات وتفصيلاتها. ومنهم من اعتمد النظم الشعري، بأن ينظم أحداث السيرة في قصيدة، كما فعل الإمام البصيري في نظم (البُردة).
ولا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي سار عليه، وهو الموجه بالوحي الإلهي، والحكمة التي التزمها في دعوته قد حققت نجاحاً منقطع النظير في فترة زمنية قليلة، ما ساهم في بقاء الإسلام واستمرار دعوته إلى يومنا هذا.
والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة توثيق صلتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحمل علماؤهم في هذا الميدان مسؤولية كبيرة؛ لأنهم وحدهم القادرون على رسم التصور الصحيح لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم، من خلال تتبع أحداث السيرة، وفهم دوافع حركة الفرد في ظل المجتمع المسلم.
ومن هنا ينبغي أن يكون منهجهم في هذا هو المنهج العلمي الصحيح، الذي يقوم على منهج المحدثين وقواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، الذي وضعوه أصلاً لخدمة الأحاديث والسنة، ثم أصبح من بعد ذلك منهجاً لنقل أحداث السيرة والتاريخ عموماً. ويغلب على كتابات المؤرخين مراعاة ترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً وموضوعياً، في حين تظهر تجزئة الأحداث في كتابات المحدثين، وذلك لالتزامهم بقواعد الرواية، وتمييز الأسانيد عن بعضها، وربما قطَّعوا الرواية الواحدة، فخرَّجوا بعضها في مكان، وبعضها في مكان آخر، كما يظهر ذلك واضحاً في عمل البخاري في "صحيحه"، وعلى نحو أقل منه في "صحيح" الإِمام مسلم.
وجمع بعض المصنفين بين منهجي المحدثين والمؤرخين، كما فعل ابن إسحق وخليفة بن خياط، والطبري، حيث أفادوا من منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد وجمعها، أو سرد الروايات التي تشكل وحدة موضوعية واحدة، بينما انصب اهتمام سائر المؤرخين على جمع ما أمكنهم من الروايات وتدوينها، دون اشتراط الصحة فيما يكتبونه، وربما أحالوا على الأسانيد التي كانوا يوردونها لتمييز الصحيح من الضعيف، كما عبَّر عن ذلك الإمام الطبري حين قال: (من أحالك فقد حمّلك).
وكان المتخصصون في القرون الأولى على دراية بالأسانيد وأحوال الرواة، وكان بوسعهم تمييز الروايات والحكم عليها، ولكن هذه المعرفة بالأسانيد والرجال لم تعد ذات أهمية في القرون المتأخرة، ولذلك جاءت كتابات المؤرخين المتأخرين خالية من الأسانيد، وكثير منهم تعامل مع روايات السيرة من خلال مناهج النقد التاريخي، وليس من خلال منهج المحدثين الذي يعتمد على الأسانيد في الحكم على الرواية بالصحة أو عدمها.
ومن هنا، فإن إهمال نقد الأسانيد في الرواية التاريخية والاكتفاء بنقد المتون أوقع العلماء في حيرة أمام الروايات التي يبدو فيها التعارض، خاصة عندما تكون هذه المتون متفقة مع المقاييس النقدية العقلية، وهذا حدث فعلاَ في كثير من الأحداث التأريخية، وخاصة المتعلقة منها بتاريخ صدر الإسلام، ما اضطر كثير منهم إلى الرجوع إلى منهج المحدثين في نقد الأسانيد، وإلا فإنه سيقف أمام العديد من المشاكل دون حل أو ترجيح.
الفرق بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين
هناك فرق كبير بين رواية (الحديث) ورواية (الأخبار) الأخرى، فالأحاديث تبنى عليها الأحكام، وهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع، ولذلك تحرّز العلماء في شروط من تؤخذ عنه الرواية فيها، أما رواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة كأحداث السيرة وغيرها، إلا أن التدقيق فيها أقل، فمن الصعب تطبيق منهج المحدثين بكل خطواته على الأخبار التاريخية؛ لكونها لا تصل في عدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة.
لهذا فرق أصحاب هذا المنهج بين ما يُتَشدد فيه من الأخبار وبين ما يمكن أن يُتَساهل فيه، فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه يجب التدقيق في رواته، ويلحق به ما كان متعلقاً بتجريح أحد العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته؛ لأنّ كل من ثبتت عدالته لا يُقبل جرحه إلا ببينة واضحة، يُضاف إلى ذلك ما كان متعلقاً بالاعتقاد أو الأحكام الشرعية، فإنه لابد من التثبت من حال الرواة ومعرفة النقلة، ولا يؤخذ في هذا الباب إلا من الرواة الثقات الضابطين، أما ما كان غير ذلك فإنه يُتَساهل فيه. وهذا لا يعني قبول الرواية عن عُرِف بالكذب، أو كان مجروحاً في عدالته؛ لأن من سقطت عدالته لا يُحمل عنه أصلاً، وإنما المقصود بالتساهل قبول رواية من ضعُف ضبطُه بسبب الغفلة، أو من كثُر غلطه، أو تغير واختلط، ونحو ذلك، أو في حالة عدم اتصال السند كالمرسل وغيره، ويضاف إليها تلك الأمور التي جوّز بعض الفقهاء العمل فيها بالحديث الضعيف، مثل فضائل الأعمال وغيرها، مع ضرورة التنبيه على ضعف الحديث.
ومن هنا يرى بعض أصحاب هذا المنهج قبول الروايات التاريخية الضعيفة، ويستشهدون بها؛ لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، ويتم الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً. وربما يُستدل بها على بعض التفصيلات، وهذا ما أشار إليه الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه "دراسات تاريخية"، وذكر أن اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة فيه تعسُّفٌ كبير، والخطر الناجم عنه ليس بيسير، وأن المؤرخين تساهلوا في الروايات التاريخية، وأننا في حالة رفضنا لمنهج المؤرخين، فإن العديد من الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثِّل هوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا.
إلا أن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية سيبقى هو الوسيلة الوحيدة للترجيح بين الروايات المتعارضة، وسيبقى خير معين لنا في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا، فالحافظ ابن حجر -مثلاً- عند الجمع والترجيح بين الروايات في كتابه "فتح الباري"، يرفض رواية محمد بن إسحاق إذا (عنعن) ولم يصرح بالتحديث، ويرفض رواية الواقدي؛ لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل، فضلاً عن غيرهما من الإخباريين، الذين ليس لهم رواية في كتب السنة كالمدائني، ومع ذلك فإنه قد يستشهد برواياتهم، ويستدل بها على بعض التفصيلات، ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق منها إسناداً، وذلك من أجل بناء الصورة التاريخية الصحيحة.
وعليه فإن منهج المحدثين، وإن لم يطبق تماماً على الروايات التاريخية، بيد أنه قدّم خدمةً عظيمة تتمثل في التحري والتدقيق والنقد، فأضاف الكثير وجمع التاريخ الصحيح المبني على الأصول والقواعد، البعيد عن الأهواء، والنزعات، ولم يكن التاريخ في الحقيقة إلا ميداناً من ميادين علم الحديث، ولم يكن المنهج المستخدم فيه إلا منهج المحدثين، وما كان مشاهير المؤرخين إلا رواة الحديث.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج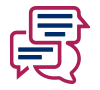 استشارات الحج
استشارات الحج

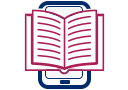












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات