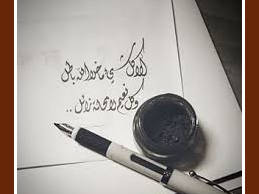
لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي ثم الجعفري، من بني عامر، ذاك اسمٌ لم ينْسهُ التاريخ في العصور الغابرة، خصوصاً في خانةِ الشعراء الأفذاذ، الذين ملؤوا جزيرة العرب في جاهليّتها بالأشعار القويّة والنظمِ البديع، حتى قال عنه الحافظ ابن حجر: "كان شاعراً من فحول الشعراء".
وكان للبيدٍ قصّةٌ وأيُّ قصّة، لم يزلْ العلماء يستذكرونها، ولم تخلُ كتب العقيدة من الاستشهاد بها، كيف لا وقد كان لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- تعليقٌ على ما دارَ فيها؟
فلنتّجه صوبَ صحيح مسلم، وفي كتاب الشعرِ تحديداً، إذ يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ) ولمن لا يعرف، فإن معنى ما خلا: أي ما سوى، ذلك التعليق النبوي جاء على إثر موقفٍ يرويه المؤرخون، وهو أن القريحة الشعرية للبيدٍ تحرّكت عند سماعِه بوفاة ملك الحيرة النعمان بن المنذر، فأنشدَ قصيدةً صادقة المشاعر مليئةً بالجواهر، ويوم أشرقت شمسُ الإسلام في سنواتِه الأولى، صادفَ أن مرّ عثمان بن مظعون رضي الله عنه على لبيدٍ وهو يُلقي بقصيدتِه تلك، وكان فيها قولُه: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" فقال عثمان: صدقت، ثم قال لبيد الشطرَ الثاني من البيت: "وكل نعيم لا محالة زائل"، وهنا تعقب عثمان رضي الله عنه لبيداً، فقال له: "كذبت، نعيم الجنة لا يزول".
والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان له رأيٌ في الشطر الأوّل من البيت، إذْ جعلَه صلى الله عليه وسلم أصدقُ كلمةٍ قالَها شاعر، فلماذا كان الشطرُ الأوّل صادقاً؟ والشطرُ الثاني كاذباً؟ ولماذا كانت تلك الكلمة متربّعةً على عرش الكلمات الشعريّة الصادقة بحسب الوصفُ النبويّ لها؟ وما الأسرار العقديّة المنضوية تحت هذه الحادثة التاريخية؟
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
كلّ ما سوى الله سبحانَه فهو باطلٌ؛ لأن الله هو الحق المبين، و(الحق): اسم من أسماء الله الحسنى التي تسمّى بها جلّ في علاه، وهذه الأحقّية ذات أبعادٍ كثيرة تتجلّى من هذا الاسم الإلهي العظيم، فالله هو الحق: فلا يسعُ أحدٌ إنكاره، بل يجب إثباتُه والاعترافُ به، لتظاهرِ الأدلةِ على وجودِه سبحانه، ومهما أنكرَ المنكرون من الملاحدةِ وجود الله سبحانَه فمعركتُهم خاسرةٌ لدلالة العقل من وجوهٍ لا تُحصى على وجودِه سبحانه، ولشهود الفطرةِ التي تجزمُ بوجدِه سبحانه، من غير سبقِ تفكير، أو تعليم، تلك هي الفطرةُ الأوليّة التي خُلق الإنسان عليها، ولا ينصرف عن مقتضاها إلاَّ من من أُفسدت فطرتُه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ما من مولود إلا و يولدُ على الفطرة، فأبواهُ يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه) رواه البخاري.
والله سبحانَه هو الحق في صفاتِه وأفعالِه، لأنه لم يزلْ بالجلالِ والجمالِ والكمالِ موصوفاً، وكلُّ أفعالِه وأقولِه حقٌّ؛ لأنها صادرةٌ من الحكيم الذي يضعُ الأشياء في مواضعِها، والخبير بظواهر الأمورِ وبواطنها، الكاملُ الذي لا يعتريه نقص، القدّوس المطهر من كلّ عيب، سبحانه وتعالى، فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسولُه حق، وكتُبه حق، ودينُه هو الحق، وعبادتُه وحدَه هي الحق، وكلُّ شيءٍ إليه فهو حق، قال تعالى: {ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير} (الحج:62)، وقال سبحانه: {وقل الحق من ربكم} (الكهف:29)، وقال عز من قائل: {ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم} (محمد:3).
وتأكيداً لما سبق، فقد كان من أشهر الأدعية النبويّة التي تُقال في صلاة الليل: (اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق) رواه البخاري ومسلم.
والباطل ضد الحق، فكلّ ما سوى الله باطل، وذلك يعني أن المعبودات من دون الله عز وجل باطلةٌ لعدمِ استحقاقِها للعبادة، ولذلك شدّد الله النكيرَ على من يصرف العبادةَ لآلهةٍ لا تملك من أمرِ السماواتِ والأرض شيئاً، نجد ذلك جليّاً في سورة يونس في قول الحق تبارك وتعالى: {قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون * فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون} (يونس:31-32).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المنفي في كلمة الإخلاص هي الطواغيت والأصنام وكل ما عُبد من دون الله، وكلها باطلة بلا ريب، كما قال لبيد في شعره الذي سمعه منه النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألا كل شيء ما خلا الله باطل".
والبطلان على مقتضى كلام العرب نوعان: ما يُراد به المعدوم، فهو نحوٌ مما ذُكر في قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} (القصص:88)، فمآلُ كلّ شيء هو الفناء، والله هو الباقي سبحانه وتعالى.
والنوع الآخر: الذي لا ينفع، ومن هذا الإطلاق تكون الآلهة دون الله عز وجل باطلة؛ فهي موجودةٌ لكن عبادتَها ودعاءَها باطلٌ لا ينفع، والمقصودُ منها لايحصل، كما أُثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قولُه: "أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل، إلا وجهك الكريم"، ومن هذا القبيل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) رواه أبو داود والترمذي، وما جاء من وصفٍ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه رجلٌ لا يُحبّ الباطل. والمتحصل أن كل فعل لا ينفع فهو باطل؛ لأنه ليس له غايةٌ موجودةٌ محمودة، كما يقول العلماء.
وكل نعيم لا محالةَ زائل
هذه اللفظة من الشاعر فيها حقٌّ وباطل، أما الحق: فإن نعيم الدنيا مآلهُ إلى الزوال والفناء وعدم الاستمرار، فلا ملكٌ يبقى، ولا نعيم يدوم، وحقٌّ على الله ألا يرتفع شيءٌ إلا وضعه. جاء في الحديث القدسي المتفق عليه: (يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت).
أما ما يتعلّق بالآخرةٌ فذاك شأنٌ آخر؛ لأن نعيم الآخرة دائمٌ وخالد، وذاك من مقاصد تسمية الحياة الآخرة بدار البقاء، فهذا هو المعنى الذي أنكرَ عثمان بن مظعونٍ رضي الله نفيَه؛ لأن من ركائز العقيدة الإسلاميّة الإيمانِ بسعادةِ المؤمنين يوم القيامة إلى الأبد.
وقد تضافرت النصوص الشرعيّة التي تُثبت ديمومة النعيم الأخروي، كما قال سبحانه: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا} (النساء:57)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ينادي مناد: يا أهل الجنة! إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً) رواه مسلـم، والنصوص في ذلك كثيرةٌ ومعروفة.
العدل مع الخصوم في العقيدة
وتلك فائدةٌ بديعةٌ قلَّ من ينتبِه لها، خصوصاً في باب المحاورات أو الجدال مع الخصوم، فالحقّ الذي كان مع لبيد وعلى الرغم من كفرِه لم يمنع عثمان رضي الله عنه من قبولِه وتصديقِه والجهر بذلك، ولا عجب في ذلك فقد تخرّج عثمان من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصف تلك المقولة بأنها أصدق ما قاله شاعر، لصدقِ متعلَّقها وصدقِ ما تضمّنتْه، فلما جاء إلى الباطلِ فيها ردّه وبيّن الحق الوارِد فيه.
ومن هنا تبلورت ركيزةٌ أساسيّة عند أهل السنة والجماعة، وهي العدلُ مع الخصوم، وعدم إخفاء الحق الذي قالوه أو تحجيمِه، وهو ما يحدث عادة بين الفرقاء عند الخصومة، وكما هو واضح فإن هذه الطريقة تخالف العدل الذي أمر اللهُ سبحانه وتعالى به.
وأخيراً: لم تنتهِ هذه القصّة الرائعة، فلها نهايةٌ قد لا يعلمها الكثير ممن قرأها، وهي أن لبيداً بما كان فيه من الفضل والعقل وتحرّي الصدق، ولأنه تربةٌ صالحةٌ حسنة المعدن، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه بنو جعفر فأسلم وحسن إسلامه، ليشهدَ له شعرُه في الجاهليّة وفي الإسلام على حسنِ أقواله، فرضي الله عنه وأرضاه.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج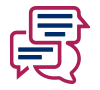 استشارات الحج
استشارات الحج

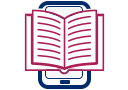












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات