
يقرأ القاريء في شأن الخوارج فيجد علامةً بارزةً لا تكاد تخطئها العين، وهي: قدرٌ كبيرٌ وجهدٌ عظيمٌ في العبادة والتنسّك والتأله والعبادة، ولهم في ذلك باع مديد في نوافل الأعمال لا يجارون فيه، حتى قيل: إنه لم ير مثلُهم في هذا الباب.
وليس في هذه الأوصافُ شيئاً من المبالغة، بل هي توصيفٌ دقيق للحال التي كانوا عليها، وإن طلبتَ شاهداً يشهد، فبين يدينا صاحب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وحواريّه الذي كان رأساً في الفقهِ والعلم، أُتيحت له فرصة اللقاء بهؤلاء الخوارج ورؤيتهم عن كَثَب، فرأى منهم ما أدهشه وحيّره، فقال فيهم مقولتَه المشهورة: "دخلت على قوم لم أر قوما قطُّ أشدَّ اجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثَفِنُ الإبل –يعني أنها غليظةٌ من شدّة اجتهادهم في العبادة-، ووجوههم معلّمةٌ –وفي رواية: معلّبةٌ- من آثار السجود" رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه والطبراني في المعجم الكبير، كما رواه الحاكم والبيهقي كذلك.
على أن الصورة لم تكتمل عند هذا الحد، فللصورة وجهٌ آخر قد تفجأ القاريء لأوّل وهلةٍ إذ قد يتصوّر جزاءً موفوراً وسعياً مشكوراً لهذه الألوان المتعدّدة من صالحات أعمالهم، فإذا به يقرأ في سنّة النبي –صلى الله عليه وسلم- الصحيحة التي لا يُخالجها الشكّ أو الريب، فيجد فيها وصفهم بأنهم: (كلاب أهل النار) و(شر قتلى قُتلوا تحت أديم السماء) كما رواه ابن ماجه في سننه، وبأنهم: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) كما في الصحيحين.
فأين الخللُ إذن؟ ولماذا استحقّوا هذه الأوصاف البشعة التي تقشعرُّ منها الأبدان، وترتجف لهولِ سماعها القلوب؟ وكيف يمكن جمع الصورتين معاً مع ما في الأولى من علوّ همّةٍ وتجلّدٍ في الطاعة، وسوءِ مصيرٍ وقبيحِ عاقبةٍ في الثانية؟ والجواب في كلمةٍ واحدة: إنه الخللُ في العلم والفهم، والغلو مجاوزة الحد .
ولولا هذا الخللُ ما كان جزاؤهم مثل ذلك، فإن السنّة الإلهيّة أن الله يُجازي على الإحسانِ إحساناً، كما قال ربّنا جلّ وعلا: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} (الرحمن:60)، والإحسان من الله إنما هو مقصورٌ على أهلِ الإحسان من عبادِه، وكلما أحسن المؤمنُ بعملِه، أحسن اللهُ إليه برحمتِه، وهذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض، وتُسيّر به شؤون العباد في المعاش والمعاد.
وإن هذا الاتّساق والترابط بين العملِ والجزاء حاصلٌ في الأصلِ ما لم يمنعْهُ مانعٌ كما هو في الخوارج، والأمر الذي ينبغي أن ننتبهَ إليه هنا أن العمل الصالح له شروطٌ ينبغي أن تُستوفى ، وموانعُ يلزمُ اجتنابُها، حتى يتحقق الجزاء الموعودُ به من الله تعالى، وإلا: فلا فائدةَ من هذا العملِ الصالح وإن أتقنَه صاحِبُه وجوّده وأحسنه.
لقد كان الخوارجُ في حالٍ من التعبّد والذكرِ وعلاقةٍ بالقرآن الكريم ترداداً وقراءة، حتى أُطلق عليهم وصف القرّاء، كما قال الحافظ ابن حجر: "كان يقال لهم: القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إِلَّا أنهم كانوا يتأولون القرآن المراد منه ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد والخشوع".
ومع ذلك: لم تنفعهم قراءتهم للقرآن لأنها كانت خاويةً خاليةً من التدبّر والتفقّه والفهم الصحيح لآيته، الأمرُ الذي جعلهم يرتكبون فظائع وأهوالاً باسم الدين والتديّن، وهكذا يصنعُ الجهلُ بأهله.
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: "وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه".
ومن جملةِ باطلِهم: تكفيرُ السواد الأعظم من المسلمين، وفوق ذلك: تكفير صحابةٍ رضي الله عنهم وشهد لهم بالخيريّة والأفضليّة على من عداهم، ونصّ الرسولُ –صلى الله عليه وسلم- على مكانتِهم ومنزلتِهم، فكانوا أحقّ بالجزاء المتوّعد به فيما صحّ من السنّة النبويّة: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما) متفق عليه.
ومن دائرة التكفير إلى دائرة الاستحلال للدماء المعصومة، وكان المبتدأ الصحابة والمنتهى عموم المسلمين الذين يُخالفونهم آراءهم وعقائدهم الباطلة، فوصلَ الحالُ إلى استرخاص دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يسترخصون من دماء الكفار؛ باعتبار أن المرتدَّ شرٌّ من غيرِه.
لقد وعد الله، ولا يُخلف الله الميعاد فقال: { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} (الإسراء: 19)، وبيّن سبحانه خيرَ بيان فقال: {وما ربك بظلام للعبيد} (فصلت: 46)، وهما قاعدتان لا يمكن أن يتخلّلهما الخطأ، فلا ينبغي أن نغترّ بحال الخوارج بعد أن قارفوا الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبّه الله، وفعل ما يبغضه الله، ومظاهر ذلك كثيرةٌ لا يمكن استيعابها في هذه العجالة، وهي بحاجةٍ إلى وقفاتٍ أخرى أكثر تفصيلاً وتحديداً.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج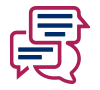 استشارات الحج
استشارات الحج

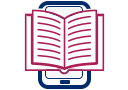












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات