
من النظائر القرآنية الآيتان التاليتان:
قوله عز وجل: {ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين} (الأنعام:6).
قوله سبحانه: {أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم} (الشعراء:7).
لسائل أن يسأل هنا: لماذا دخلت همزة الاستفهام في الآية الأولى على حرف الجزم (لم) مباشرة، من غير (واو) في حين أن همزة الاستفهام في الآية الثانية دخلت على (الواو) العاطفة، وفصلت (الواو) العاطفة بينها وبين (لم)؟ ولماذا خلا حرف الجزم (لم) من (الواو) في آية الأنعام، في حين أنه ثبت في آية الشعراء؟
أجاب الإسكافي عن هذا السؤال بما حاصله:
إن الألف تدخل على (واو) العطف في حال الاستخبار والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون الجملة التي فيها (الواو) معطوفة على كلام مثلها يقتضيها، فكل موضع فيه بعد (ألف) الاستفهام (واو) ففيه تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد (الواو) فالاعتبار به لكثرة أمثاله، كقوله تعالى: {وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون * أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم} (الشعراء:5-7) كأن قائلاً قال: كذبوا الرسول، وغفلوا عن الفكر والتدبر، فقد فعلوا ذلك، ولم ينظروا إلى المشاهدات، التي تنبه الفكر فيها من الغفلة.
وكذلك قوله تعالى: {ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير * أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات} (الملك:18-19) كأنه قال: كذبوا، ولم ينظروا إلى ما يردع عن الغفلة من الفكر في المشاهدات.
ومثله قوله عز وجل: {أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون} (النحل:48) لأن ذلك مشاهد.
فكل ما فيه (واو) مثل {أولم يروا} فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال منبهة، ولكثرتها، فالتبكيت فيه أعظم، هذا كله في المشاهد وما في حكمه. وما ليس فيه (واو) مثل {ألم يروا} فهو مما لم يقدر قبله ما يُعطف عليه ما بعده؛ لأنه من باب ما لا يكثر مثله، وذلك فيما يؤدي إلى علمه الاستدلالات، كقوله تعالى: {ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكانهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم} (الأنعام:6) وهذا مما لم يشاهدوه، ولكن علموه.
وكذلك قوله عز من قائل: {ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون} (يس:31) فالطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة.
فهذا ونحوه مما لم يكثر في علم المخاطبين أشباهه، فهم يُنبهون عليه ابتداء من غير تقدير تنبيه على شيء مثله مما قبله.
فإن قال قائل هنا: إن قوله تعالى: {ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء} (النحل:79) حقه أن يكون ملحقاً بقوله: {أولم} كما كان قوله عز وجل: {أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات} (الملك:19) إذ هما في شيء واحد، فلماذا اختلفا من حيث وجب أن يتفقا؟
قيل له: إنا عللنا موضع {ألم} بما يوجب أن يكون هذا الموضع من أماكنها؛ لأنا قلنا: هو كل موضع ينبهون عليه ابتداء من غير تنبيه على شيء مثله مما قبله، فعللنا المشاهدات بما يخرج هذا عنها؛ لأن قبل هذه الآية: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون * ألم يروا إلى الطير مسخرات} (النحل:78-79) فبُنيت هذه الآية على التي أخبر الله فيها عز وجل عن أول أحوال الإنسان، وأنه أخرجهم أطفالاً صغاراً من بطون أمهاتهم، لا يعلمون شيئاً من منافعهم فيقصدونها، ولا من مضارهم فيتجنبونها، ثم بصرهم حتى عرفوا، ونبههم على ما يشاهده كل حي من تصرف الطير في الهواء، وعجزه عن مثل ذلك، وكان هذا مقروناً بأول الأحوال، ولم يتقدمه أمثال له، يقع التنبيه عليها قبله، فيكون في حكم ما يُعطف على ما تقدمه.
وأيضاً، فإن قيل: إن قوله عز وجل: {وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقطنون * أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} (الروم:36-37) مما لا يُعلم ولا يُشاهد، وحكمه أن يكون بـ {ألم}.
فالجواب عنه: أن التوسعة في الرزق والتقتير فيه لما كانت لهما أمارات تُرى وتُشاهد من أحوال الغنى والفقر، صار أمرهما كالمشاهدات، فكانا مما شوهدت أمثال لهما فعُطف عليها.
وقد أجاب الكرماني عن توجيه الفرق بين قوله سبحانه: {ألم يروا} وقوله عز وجل: {أولم يروا} بجواب مختصر، حاصله: أن كلمة {ألم} تأتي في القرآن على وجهين:
أحدهما: متصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة، فذكره بـ (الألف) و(الواو) لتدل الألف على الاستفهام، و(الواو) على عطف جملة على جملة قبلها، وكذا (الفاء) لكنها أشد اتصالاً بما قبلها.
الثاني: متصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال، فاقتصر على (الألف) دون (الواو) و(الفاء) لتجري الجملة مجرى الاستئناف.
وقريب مما ذكره الكرماني ما قاله ابن جماعة من أنه إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال جاء بغير (واو) وهو كذلك في آية الأنعام لمن نظر في الآيات قبلها.
وإن كان السياق يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة، جاء بـ (الواو) أو بـ (الفاء) لتدل (الهمزة) على الإنكار، و(الواو) على عطفه على الجمل قبله، كقوله تعالى: {أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء} (النحل:48).
ومن الأسئلة الواردة في هذا السياق ما جاء من الآيات بـ (الفاء) نحو قوله تعالى: {أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض} (سبأ:9) ما الفرق بين المواضع التي جاءت فيها الآيات بـ (الفاء) وبين المواضع التي جاءت فيها الايات بـ (الواو)؟ وهل كان يصح في نظم الكلام (الواو) مكان (الفاء) ها هنا؟
والجواب أن يقال: إن (الفاء) ها هنا أولى؛ لأن قبلها: {وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض} (سبأ: 7-9) فكأنه قيل فيهم: إنهم كذبوا الله ورسوله بما أنكروه من البعث، فلم يتفكروا، ولم يخشوا عقيب هذا المقال نقمة تنزل بهم، فقيل: لم يتفكروا، ولم يخشوا {أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض} أي: هم لا ينفكون من أرض تقلهم وسماء تظلهم، والذي جعلها تحتهم وفوقهم قادر على أن يخسف الأرض بهم، أو يسقط السماء عليهم، فهذا موضع (الفاء) لا موضع غيرها؛ لما تبين. والله أحكم وأعلم.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج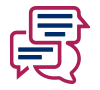 استشارات الحج
استشارات الحج

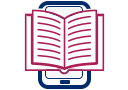












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات