
المراد بانتفاء الشبهة في هذا المقام: ألا تعرض للمسلم شبهة تحول دون فهمه مراد الشارع فهمًا صحيحًا في حكم من الأحكام، أو تحمله على صرف النص الشرعي عن ظاهره وتأويله لسبب ما، سواء في ذلك الأحكام العملية أم الاعتقادية. فمن انتفت عنه مثل هذه الشبهة، وفهم مراد الله تعالى ولم يحمله سبب على تأويله ثم خالف ذلك النص؛ فإن الحجة تكون قد قامت عليه، وترتبت عليه أحكامها، وأما مَن قامت أمامه شبهة فخالف الأمر الشرعي لأجلها؛ فإنه لا يعد عالمًا بالحكم الشرعي، ولا تترتب عليه أحكامها، بل هو جاهل معذور بجهله أو بتأوله.
وقد دلَّت على هذا الأصل كثير من الأدلة الشرعية من أبرزها أدلة الإعذار بالجهل وقد سبق إيرادها في مقالات سابقة، منها قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، ومنها قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وغيرها من الآيات كثير، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يعاقب من أكل من أصحابه حتى طلع نهار رمضان متأولًا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، ومنها أيضًا: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا من استحل شرب الخمر متأولًا، مع أن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ولكن لما طرأت على الشارب شبهة حالت دون فهمه النص الشرعي فهمًا صحيحًا؛ اكتفى عمر رضي الله عنه بجلده الحد دون قتله ردةً.
وقد قال بهذا الأصل -من أن انتفاء الشبهة شرط في قيام الحجة على المعيَّن- عددٌ كبير من علماء الأمة المحققين كالخطابي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن حجر، وابن الوزير وغيرهم. وقد كان ابن تيمية يقول لعلماء الجهمية: "أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال"، وإذا كان الجاهل يعذر بسبب جهله فإن المتأول أولى بالإعذار منه، وقد جاء ببيان إعذاره حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قصة الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه بعد موته، وقد ظن بذلك أن الله لا يقدر عليه، ثم إن الله تعالى عذره بتأوله وغفر له. قال ابن تيمية: "والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول؛ أولى بالمغفرة من مثل هذا". وقصة هذا الرجل تدل على أن الإعذار يكون في كل مسائل الدين حتى في مسائل الاعتقاد.
يقول ابن تيمية: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم".
يقول الخطابي في شرحه حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة: "فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه أن المتأول لا يخرج من المله وإن أخطأ في تأوله". ويقول ابن قدامة: "وقد عُرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم، واستحلال دمائهم وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يُخرَّجُ في كل مُحرَّم اُستُحل بتأويل مثل هذا...، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك، وتزول عنه الشبهة، ويستحله بعد ذلك".
ويقول ابن حجر: "قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغًا في لسان العرب، وكان له وجه في العلم"، ويقول ابن الوزير: "وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلاَّ مَنْ تأويلُه تكذيبٌ، ولكنه سمَاه تأويلاً مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجوداً وعالماً وقادراً، ونحو ذلك من الصفات التي علم الكافة بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على ظاهرها. والدليل على أنه لا يكفُرُ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلاَّ من بلغَ هذا الحدَّ في جحد المعاني المعلوم ثبوتُها بالضرورة؛ أنَّ الكُفْرَ هو: تكذيبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إمَّا بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزاماً ضرورياً لا استدلالياً، ومثال ذلك قول هؤلاء وأمثالهم، فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: إنه لا يوصف البتة، ويتأولون الصفات الربانية بأن المراد بها الإمام حتى تُوجَّهَ العبادة إلى الإمام، لأن توجيه الصلاة إلى الله يقتضي عندهم التشبيه".
وإذا كان انتفاء الشبهة شرطًا في قيام الحجة على المعيَّن؛ فإن ذلك ليس على إطلاقه في كل من تأول أمرًا من الدين، بل له ضوابط تُفهم من كلام العلماء الذين سبق ذكر أقوالهم في هذا الأصل، ومن كلام غيرهم من العلماء أيضًا، وترجع تلك الضوابط إلى أن يكون المتأول مسلمًا مؤمنًا بالله ورسوله، غير خارج عن أصل من أصول الإسلام، ولا متهاونًا أو متغافلًا عنها، وكل من ظهر منه الخروج عن أصل من أصول الدين أو تغافل عنه؛ فإنه لا يعذر بتأوله ولا بجهله، ولذا لم يعذر علماؤنا الفرق الباطنية بتأولهم أصول الدين، ولم يعتبروا ذلك التأول منهم شبهة، بل حكموا بكفرهم وزندقتهم، لأن حقيقة دين هؤلاء أنهم لا يعبدون الله تعالى، ولا يلتزمون أصول الإسلام، بل لقد عمدوا إلى كل أصل من أصول الدين فصرفوه عن حقيقته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، وذلك بخلاف من كان ملتزمًا بأصول الدين، حريصًا على تعلمه وتعليمه ثم أخطأ في أمر ما؛ فإنه يعذر بجهله أو بتأوله.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج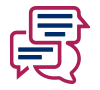 استشارات الحج
استشارات الحج

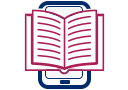












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات