
يظنُّ البعض أنّ الادعاءات الإسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الأونروا (من أصل 13000 موظف يعملون لديها في قطاع غزة وحدَه) في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، جاءت كإجراء مدروس لحرف الأنظار، ولو جزئيًا، عن الفظائع والإبادة الممنهجة ضد أهل فلسطين بغزة. إن هذا الظن يفتقر للدقة.
الرؤية التاريخية والإستراتيجية لدولة الكيان تمحورت، في أهم مفاصلها، بجهد محموم ومدروس في سلخ القدس عن الوجدان العربي والفلسطيني والمسيحي والإسلامي، ودفن حق العودة، وإبطال النصوص والقرارات الأممية التي تشير- ضمنًا أو صراحة- (إلى الذنب الإسرائيلي) المتمثل بالتهجير والترويع والإبادة التي مُورست في العام 1948، ومنع عودة اللاجئين وغسل اليد من محاولة البعض مطالبةَ الكيان بالتعويض للاجئين (وإن أقرّ مثل هذا التوجه فإنه على ما يسمّى المجتمع الدولي والدول العربية تقع مسؤولية دفع هكذا تعويضات، مع ضرورة أن يتم تعويض اليهود الذين (هجّروا قسرًا!) من بيوتهم وممتلكاتهم في العراق ومصر والمغرب واليمن وتونس وغيرها)!
التوقيتُ في الكشف المزعوم عما اقترفه 12 موظفًا يعملون لدى الأونروا وتزامنه مع ارتفاع منسوب النقاش الغريب العجيب عن وضع وكينونة غزة (بعد الحرب) مهمٌ.
جرت عشرات المحاولات، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، إما لتوظيف الأونروا كأداة للتوطين، وعندما فشل هذا الجهد باتت المحاولات تنصبّ على شيطنة الأونروا ومحاولة إنهائها وتجفيف مواردها المالية واتهام عامليها بخرق الحيادية المفروضة على موظفي الأمم المتحدة، والتركيز المجنون على مضامين (الكراهية) و(العنف) المشمولة، حسب زعمهم، بالمنهاج الفلسطيني الذي تعتمده الأونروا في مدارسها بغزة والقدس والضفة الغربية والذي ينهل منه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من أصل نصف مليون ويزيد، يدرسون بمدارس الأونروا داخل فلسطين المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.
عبر عقود نجحت هذه المحاولات في إخافة ولجم الأمناء العامين الذين تعاقبوا على سدة الأمم المتحدة، ولجمت المفوضين العامين الذين توالوا على قيادة الأونروا. ومن جابههم ووقف أمام محاولات الترهيب والتدجين منهم شنّت عليهم الحرب، كما حصل مع بيتر هانسن في أواخر القرن الماضي؛ لانتقاده ما قاموا به من تدمير ممنهج لمخيم جنين بالضفة الغربية وإجراءاتهم ضد سكان غزة، ولمواقفه الإنسانية المشرفة حينذاك والتي انتهت بإقصائه والإعلان عنه كشخص غير مرغوب فيه.
وكما حصل قبل سنوات قليلة مع المفوض العام السابق بيير كرهنبول الذي وقف بشجاعة وثبات يحسبان له أمام قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب بنقل سفارة بلده للقدس، وإيقاف كافة المساعدات المالية للأونروا، وأطلق مقابل ذلك حملة دولية ناجحة سميت: (الكرامة لا تقدر بثمن)، ووقف بحزم أمام محاولات إنهاء الأونروا حينها، ومحاولات إنهاء وجودها في مدينة القدس بالتّحديد، وانتهى به المطاف مجبرًا على الاستقالة بعدما تمّ تلفيق تهم (جنسيّة) و (سوء إدارة) ضدّه، وهو عنها ومنها براء.
واستمرَّت حملات الكيان في محاولة كيّ وعي عاملي الأونروا وأكثر من خمسة ملايين لاجئ منتفع من خدماتها الأساسية والطارئة، وتمّ توظيف أموال وإنشاء مؤسسات وهيئات وجمعيات وبحّاثة ومراكز بحثية تحت مسميات مختلفة، جلُّ هدفها النهشُ بجسم الأونروا والتركيز – ضمن جهود متعددة- على الثلاثين ألف موظف الذين يعملون لدى الأونروا واتهامهم بأنهم يخرقون مفهوم أو مبدأ (الحيادية)، وأنهم – ويا للهول- يعبّرون عن فلسطينيّتهم وانتمائهم لأهلهم على منصات التواصل الاجتماعي، وأنهم يجرؤون على الإشارة إلى المدن والقرى التي هجّروا منها.
واتبعتها هذه المؤسسات والهيئات، بتركيز ومثابرة شديدَين، بالهجوم على المناهج الفلسطينية التي تعتمدها الأونروا في المئات من مدارسها بغزة والضفة الغربية والقدس، واتهام المؤسسة الدولية بأنها، عبر هذه المناهج، تحرّض على (العنف والكراهية). وانضمت لهذا الجهد بحماسة الدول الغربية المتبرعة لصندوق الأونروا التشغيلي، مناديةً هي الأخرى (بإصلاحات).
وفُرض على الوكالة قبل عديد السنوات إدخال وتعليم مساق (حقوق الإنسان) كمساقٍ تربوي، مكملٍ (وناقضٍ في بعض جوانبه) للمنهاج الفلسطينيّ المعتمد.
وترافق ذلك مع إصدار (دليل المعلم) لتوجيه معلمي الأونروا (وعددهم يتخطى 18000 معلمة ومعلم) كمرافق ومساعد لهم لاستخدام ما سمي بمواد تتعلّق بحقوق الإنسان، وتستبعد مضامين بالمنهاج الفلسطيني اعتبرت مناقضة له! وترافق ذلك مع عقد مئات الورش والاجتماعات المكلفة ماليًا؛ بهدف كي وعي المعلمين، ومن عبرهم نصف مليون طالب وطالبة، وكيف يستبعدون مضامين ونصوصًا واردة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعيات والتاريخ وغيرها، والتي قرر الكيان وداعمو الأونروا الغربيون أنها لا تتماشى مع مفاهيم الإنسان ولا القانون الدولي، وكلها مفاهيم تم فضحُها وتبيان خللها وانتقائيتها خلال الحرب المجنونة على غزة.
ضمن ذات السياق، لعله من المهم التذكير بقرار إسرائيلي وغربي مدروس اتخذ بعد النكبة وعشية الإعلان عن إنشاء الأونروا، وإصرارهم حينها على أن تكون جسمًا منفصلًا وألا يتم شمل اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة مفوضية شؤون اللاجئين خشية من -لا سمح الله- المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين، واللاجئين الأوروبيين واليهود منهم؛ بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية، ولكي لا تنضوي مطالب اللاجئين الفلسطينيين قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا وإنسانيًا ضمن الأطر والهيئات الدولية التي انبثقت بعد الحرب الكونية.
إذن لماذا الهجمة المركزة الحالية على الأونروا وتوقيتها؟
التهم الموجهة لـ 12 موظفًا عملوا/يعملون لدى الأونروا بغزة مبهمة ومتناقضة. الكيان بدأ يتراجع عن روايته، فمرة يشير إلى توافر اعترافات ضدهم (؟!)، ومرة يشير إلى أن اتهامهم تم بعد الرصد والتنصّت على هواتفهم.عبر سنوات عملي بالأونروا – وأنا عملت معها لمدة 32 عامًا كناطق رسمي ومدير للإعلام والاتصال والتواصل بمقر رئاستها – عانى عاملوها من اتهامات متواصلة، وما رافقها من تلفيق لتهم وتشكيك بالمؤسسة، وأنها تعزز الاتّكالية بين صفوف اللاجئين، وأنها بيروقراطية وتبيع الأوهام للاجئين بإمكانية عودتهم، وأنها تمثل (رمزية) لمطلب أكل عليه الزمن وعفا.
التوقيت هنا يتعلق بتوفر (فرصة تاريخية) مقدرة إسرائيليًا وقد لا تعوض بالقضاء على الأونروا، وإن لم يكن بالضربة القاضية، فإذن بإضعافها والقضاء عليها بتراكميّة النقاط المسجّلة عليها، وعبر أهم بواباتها ألا وهو قطاع غزة، حيث الوجود الأكبر والأكثر أثرا، وحيث يتواجد جيش من العاملين يتخطى 13000 موظف، وإقليم يتواجد فيه أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، بعد إقليم الأردن، والإقليم الذي يستحوذ على حصة الأسد من الميزانية العادية والطارئة.
يهدف الكيان إما لتفتيت وتمييع دور الأونروا، أو إنهاء وجودها في غزة بعد وقف العدوان، ومع رفع مستوى المساعدات الإنسانية والبدء بعملية إعادة الإعمار، وإيجاد كيان سياسي جديد مفصل حسب الرغبة والتوجه الإسرائيلي والأميركي والأوروبي.
نقطتان ذواتا صلة في هذا المقام:
خساسة وبذاءة القرار الأميركيّ والأوروبي والكندي، إمّا بتعليق أو إيقاف الدعم المالي للأونروا على ضوء الاتهامات الموجهة لبعض عامليها، فهو موقف يعكس نيّة واضحة لفرض ما يسمّى (بالإصلاحات الإدارية والمالية) لعمل الوكالة.
وهنا تأتي محاولات تغيير المنهاج، ومحاولة إنهاء بعض الخدمات، وتفتيت الخدمات الأساسية الأخرى وترحيل بعضها لمؤسسات أممية كاليونيسيف واليو. ان. دي.بي، أو لمؤسسات مدنية أو للدول المضيفة، هي كلها مؤشرات في هذا الاتجاه (انظر مثلًا القرار الكندي الملغوم بتوفير 40 مليون دولار لغزة، مع التأكيد بعدم توجيه دولار واحد للمؤسسة الأساس بغزة والمؤسسة القادرة على توصيل المساعدات ألا وهي الأونروا. هذا مؤشر خطير ومدروس وبالون اختبار!).
الدول الغربية وأميركا توفر تقريبًا 85٪ من ميزانية الأونروا التشغيليّة (وأقل من ذلك لميزانيات الطوارئ لسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلّة)، وهي ميزانيات هزيلة وميزانيات حدّ الكفاف لوكالة تعاني من عجوزات مالية متأصلة منذ عقود، وميزانيات تستخدم كأداة لضرب رأس الأونروا، وحصر دورها وخدماتها وكبت صوتها عندما تتحدّث عن الخروقات الإنسانية والقانونية بحقّ اللاجئين، وعندما تتحدث عن آلة البطش والقتل والتنكيل وانتهاك المخيمات ومنشآت الأونروا، أو عندما تتجرأ الوكالة وتتحدث عن حماية اللاجئين، كما المنصوص عليها ضمن ولاية إنشائها، أو مناصرة اللاجئين والتعريف بحقوقهم المشروعة.
هذه الدول والتي عبّرت عن (رعبها وهلعها) من الذي قام به نفرٌ قليل جدًا من عاملي الأونروا حسب ادعاءات الكيان غير المعززة بدلائل دامغة، هي نفس الدول التي لم تتحرك البتة عندما تم ذبح 152 موظفًا لدى الأونروا (وهم موظفو الأمم المتحدة) وعوائلهم، وهو أكبر عدد يقتل منذ إنشاء هذه المؤسسة الأممية.
هذه الازدواجية وهذا الانفصام الواضح والمقصود، وأن من يسقط من الفلسطينيين بآلافهم المؤلفة لهي أرقام تتوالى، وأما من يسقط من غيرهم فتهتز لهم ضمائر الإنسانية وتبكي عليهم السماء (!)، هذه الازدواجية تعكس وتفضح ليس النوايا فقط، ولكن الجهد المنظم من قبل هذه الدول لتقييد ولاية الأونروا وإضعافها وإبقائها على حد الكفاف ماليًا، وكفّ يدها عن أي جهد يتعلق بحماية اللاجئين ومناصرتهم، والعمل على كيّ وعي العاملين والمنتفعين من خدماتها ووصولًا إما للانتهاء منها أو تحويل ولايتها لمؤسسة تعمل على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين بأماكن تواجدهم وتشجيع أصحاب الكفاءات منهم للهجرة.
النقطة الثانية تتعلق بقرار مجلس الأمن أواخر شهر ديسمبر / كانون الأول 2023 باستحداث منصب منسق لشؤون الخدمات الإنسانية وإعادة الإعمار لقطاع غزة برئاسة سيغريد القاق (وهي بالمناسبة زوجة دبلوماسي فلسطيني سابق). بالرغم من النية الحسنة (أو عدمها) لهكذا قرار فإن هذا الجسم الجديد/الغريب سيكون المشرف على إدخال المساعدات وتفتيشها ومراقبة آلية توزيعها، بالإضافة للملف الصعب والشائك المتعلق بإعادة البناء والذي أشرفت على الجزء الأكبر منه الأونروا سابقًا بعد الحروب المتتالية على غزة وأهلها.
إذن الكفة ترجح أن هذا الجسم سيساهم بتهميش الأونروا وحصر دورها بغزة مستقبلًا، وما يحمله هذا الوضع الجديد من تداعيات مختلفة وعلى أكثر من صعيد.
الخلاصة، تتلاقى وتتقاطع إذن أهداف عدة ضمن "هبروجة" ومسرحية (الأشرار الاثني عشر!) واللهاث المسعور بتعليق أو إنهاء الدعم الغربي للأونروا. وهذه الأهداف هي:
توفر فرصة ذهبية إما لشطب الأونروا بغزة بعد الحرب (وهي الرغبة الإسرائيلية)، وإن فشل هذا المسعى سيصار لتحييدها وتهميشها وتجفيف مواردها المالية وقصقصة أجنحتها، (وهي رغبة الدول الداعمة ماليًا للأونروا وتلحق بها بعض الدول العربية!).
إتمام عملية إضعاف الأونروا ولسان الحال يقول: سنفرض عليكم تبني وكالة على مقاسنا كدول غربية داعمة، وسننجز مهمة تفريغ المنهاج الفلسطيني المطبق بمدارس الأونروا من محتواه الوطني، (وهو جهد يبذلونه ونجحوا فيه لحد بعيد عندما يتعلق الأمر بالمدارس الفلسطينية في القدس)، وسنمنعكم من التحدث عن الحقوق والحماية، ونفرض حيادية على موظفيكم كما نريد، ونستقطع ما نرتئي من خِدمات.
الالتفات لاحقًا إلى إضعاف وجود الأونروا بالضفة الغربية ضمن مخطط (إعادة هيكلة وإصلاح السلطة الفلسطينية)، وأمام ضعف المؤسسات والهيئات والأطر الرسمية والشعبية التي تمثل اللاجئين، الخوف يتأتى من اختراقات إسرائيلية في هذا المضمار .
إتمام الطوق المفروض، ورفع مستوى الضغوط المفروضة، على الأونروا وعلى مقرها الرئيس في القدس وإضعاف وعرقلة خدماتها لمخيمي اللاجئين الفلسطينيين الواقعين ضمن حدود بلدية القدس الكبرى: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتمييع الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داخل أسوار البلدة القديمة للقدس وضواحيها. النية هنا طرد الأونروا من مقرها بالقدس (وكان هناك محاولات بالسابق وفشلت)، وإنهاء مفهوم وواقع وجود مخيم اسمه شعفاط ضمن نطاق (القدس الموحدة).
وهذه النقطة الأهم: تكثيف الجهود، أو أكثر دقة، إتمام الجهد المتواصل منذ عقود للإجهاز على مفهوم (حق العودة)، وهو حق، للأسف الشديد، لم يعد ينادي به كثر من الذين يدّعون تمثيلهم للشعب الفلسطيني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المتحدث السابق باسم الأونروا



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج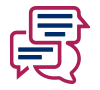 استشارات الحج
استشارات الحج

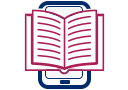












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات