
من السنة أن يقول المصلي بعد رفعه من الركوع (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) أو (ربنا لك الحمد) أو (اللهم ربنا لك الحمد)، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه وفيه: «وإذا قال -أي الإمام- سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد». وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وقريب منه في صحيح مسلم.
وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ـ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ فلما انصرف قال «من المتكلم»؟ قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول».
فما معنى: سمع الله لمن حمده؟
منطوق العبارة أن الله يسمع من حمده، والمفهوم أن من لا يحمده لا يسمعه، فهل هذا المفهوم مراد؟ الجواب: أن الله سبحانه وسع سمعه الأصوات، فيسمع كل شيء، وكل أحد، فيسمع دوي الحيتان في قعور البحور، إذن فلماذا خص السمع بمن حمده؟ والجواب: أن المقصود ليس مجرد السمع، بل المقصود الإجابة، فمعنى سمع الله أي: استجاب الله لمن حمده، ولذلك في الدعاء المأثور: وأعوذ بك من دعاء لا يُسمع، أي: لا يستجاب، وقد كان من دعاء العرب: "لا سمع الله دعاءك"، أي: لا استجاب الله دعاءك.
ولذلك شرع للمصلي الحمد والثناء على الله بعد قوله: سمع الله لمن حمده، فيقول عقبها مباشرة: ربنا ولك الحمد...، ثم يأتي بعده السجود الذي هو موضع الدعاء، ليقع الدعاء بعد الحمد، وربنا سبحانه يسمع دعاء من حمده، وذلك أقرب لإجابة الدعاء، قال الشاعر العربي:
| دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ما أقول |
|
|
أي: يستجيب.
وهذا أسلوب عربي يعرف بالتضمين، وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، بحيث إن كلمة واحدة تؤدي معنى كلمتين، فكلمة (سمع) فعل يتعدى بنفسه في الأصل، كقوله تعالى: {يوم يسمعون الصيحة}، فلم يقل: يسمعون للصيحة، بينما في الدعاء يقول المصلي: "سمع الله لمن حمده" فعداه باللام؛ ليدل على معنى زائد عن مجرد السماع وهو الإجابة.
وهل قول المصلي: سمع الله لمن حمده دعاء أم خبر؟ الجواب: يحتمل أن يكون قول المصلي: سمع الله لمن حمده جاء على سبيل الخبر، فيكون المعنى يسمع الله حمد الحامد، ويثيبه عليه، ويحتمل أن يكون دعاءً، والمعنى اللهم اقبل حمدي لك: وأثبني عليه.
قوله: (ربنا ولك الحمد) الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فقد يثني الإنسان على مثله من غير تعظيم ولا محبة، وإنما يثني عليه رغبا أو رهبا، ووأما الثناء على الله فهو مع كمال محبته وكمال الذل له، والتعظيم لجلاله، وهذه هي حقيقة العبودية، بحيث يجمع العبد بين كمال الحب وكمال الذل، فيكون اللسان مثنيا بالكمال والقلب مملوء بالحب والتعظيم.
قوله: (طيباً) أي: خالصاً، قوله: (مباركاً) أي: متزايداً، قوله: (ملء السموات وملء الأرض وما بينهما) إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه، قال الخطابي – رحمه الله -: "هذا الكلام تمثيل وتقريب، فالكلام لا يقدر بالمكاييل، ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو يُقدَّر أن تكون تلك الكلمات أجساماً تملأ الأماكن، لبلغت من كثرتها ما يملأ السموات والأرض".
قوله: (أهلَ الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاص أو المدح، أو بتقدير: يا أهل الثناء، أو بالرفع بتقدير: أنت أهل الثناء. ومعنى الثناء: الوصف الجميل، ومعنى المجد: العظمة والشرف. قوله: (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت...)، أحق ما قال العبد، أي: أصدقه وأثبته، وإنما كان هذا أحق ما يقوله العبد كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى، والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه، وانفراده بالوحدانية، وتدبير مخلوقاته". انتهى.
قوله: (ولا ينفع ذا الجَدِّ) قال الشوكاني في نيل الأوطار: الجَد: بفتح الجيم على المشهور، وروى ابن عبد البر عن البعض الكسر قال ابن جرير: وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من قاله غيره ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أيضا: "أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظُّه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى: { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}. [الكهف:46 ].
ومثله قوله تعالى: { وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} [سبأ: 37].
فمقام الاعتدال بعد الركوع مقام حمد وثناء بهذه الكلمات العظيمة، ومهما اجتهد المصلي في انتقاء كلمات الثناء على الله فلن يصل إلى هذا الثناء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم بهذه الكلمات بين يدي دعائه في سجوده، حتى يكون دعاؤه مستجابا، وينبغي أن يكون هذا حاله في كل دعائه، فلا يشرع في الدعاء حتى يثني على الله ويحمده.




 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج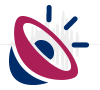 تسجيلات الحج
تسجيلات الحج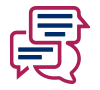 استشارات الحج
استشارات الحج

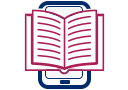












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات