
إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وثقلت عليك محنة التكذيب والأذى ممن حولك؛ فلا ملجأ لك حينها إلا ربّ السماء والأرض، ذلك ما جرى لسيّد الدعاة وإمام الصابرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حين غادر مكة متوجّهًا إلى الطائف بعدما أُغلقت في وجهه الأبواب وتكالبت عليه الأحزان.
أولًا: خروجه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم:
روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب، وقد فقد برحيلهما دعمًا لا يُعوّض؛ غاب عنه قلبٌ مؤمنٌ يواسيه، وسندٌ قويّ يذود عنه، فلم يبقَ له في مكة من يخفّف عنه ألمه أو يردّ عنه أذى قريش، وحين ضاقت عليه السبل في بلده، انطلق بدعوته المباركة إلى الطائف يحدوه أملٌ أن يجد هناك قلوبًا مفتوحة، وأيدٍ حانية تمتد لنصرته. دخل صلى الله عليه وسلم الطائف داعيًا لا هاربًا، عرض الإسلام على كبار ثقيف وسادتها، لكنهم لم يكتفوا برفض دعوته والاستهزاء بها؛ بل حرّضوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فجعلوا يرمونه بوابلٍ من الحجارة حتى أدمَوا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وتصبّب دمه الطاهر على تراب الطريق؛ عند ذلك هرب صلى الله عليه وسلم منهم، وأوى إلى ظل شجرةٍ في بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وقد بلغ به الأذى والخذلان مبلغًا عظيمًا، هناك رفع أكفّ الضراعة يناجي ربّه بدعاءٍ رؤوف رحيم قائلًا:
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربُّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك» السيرة لابن هشام.
لم يكن ذلك الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مجرد كلمات عابرة؛ بل كان صورةً ناصعة للتسليم المطلق لله تعالى، واعترافًا بأن كل وجعٍ يهون ما لم يكن غضبُ الله فيه، وبأن الهوان أمام الناس لا يُخيف المؤمن ما دام قلبه موصولًا بالرحمن.
وفي تلك اللحظة العصيبة، حين بلغ الألم ذروته، جاءه الجواب من السماء، فقد نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال: «إن شئتَ أن أُطبِق عليهم الأخشبين لفعلتُ!»، ولكن قلب النبي الرحيم كان أوسع رحمةً، وأبعد نظرًا من أن يُجازي بالانتقام؛ فجاء جوابه يفيض إيمانًا قائلًا: «بل أرجو أن يُخرِج الله من أصلابهم من يعبدُ الله وحده لا يشرك به شيئًا» رواه البخاري ومسلم.
لم يكن هدفه صلى الله عليه وسلم أن يَنتصر لنفسه، بل أن تنتصر رسالةُ الله تعالى، فلم يُرد عقوبةً لأعدائه، وإنما رجا لهم ولذراريهم الهداية والخروج من الظلمات إلى النور، وسرعان ما أثمر صبره أولى بشائر الفرج والنصر، فقد رأى هذا المشهد «ابنا ربيعة: عتبة وشيبة، وما لقي صلى الله عليه وسلم، فتحركت له رحمهما، فدعوا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له عداس، فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده، قال: باسم الله، ثم أكل، فنظر عداس في وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس، وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي، كان نبيا وأنا نبي، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه». السيرة لابن هشام. وقد كان في إيمان عَدّاس هذا بلسمٌ لجراح النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالةٌ ربانية بأن الله لا يضيّع أجر الصابرين، ولا يتخلى عن عباده المؤمنين.
ثانيًا: الدروس والعبر من رحلة الطائف
نأخذ من أحداث رحلته صلى الله عليه وسلم الكثير من الدروس والعبر ومنها:
1. أن الطريق إلى النصر والتمكين محفوفٌ بالمخاطر والصعاب، فلم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم طريقًا مفروشًا بالورود، بل كان دربها مليئًا بالآلام. وإن المحنَ سنّةٌ ماضية في مسيرة الأنبياء والمصلحين، غير أن نهاية الطريق لمن يصبرون: فتحٌ ونصرٌ مؤزّر بإذن الله. قال تعالى: (وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ) [السجدة: 24].
2. أن المحن مفتاح المنح، ففي أصعب لحظات الضيق تتولّد أعظم المنح من الله تعالى، فما إن انتهت محنةُ الطائف القاسية حتى أعقبها الله بكرامة الإسراء والمعراج، ثم هيّأ له بيعةَ العقبة حيث بايعه نخبةٌ من أهل يثرب، لتبدأ مرحلة الهجرة وبناء الدولة والتمكين في الأرض.
3. أن الرحمة صفة تسبق الغضب في نهج المصلحين، فقد تجلّت رحمته صلى الله عليه وسلم في أسمى معانيها يوم الطائف؛ فرغم ما لاقاه من أهلها من ظلمٍ وأذى، أبى إهلاكهم، بل دعا لهم بالهداية بدل الانتقام، فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن تتسع صدورهم للجاهلين والمعاندين؛ حرصًا على نفوسهم أن لا تهلك في الضلالة.
4. أن خذلان الخلق لا يعني خذلان الخالق، فلما تنكّر أهل الأرض للدعوة وصاحبها، جاءت نصرةُ الله تعالى تؤنسه وتؤازره، رفض أهل الطائف دعوة الإسلام وخذلوها، ولكن الله عز وجل بعث لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكَتَه تَؤْنسه وتثبت فؤاده، وكأن لسان الحال يقول: إن تخلّى عنك الناس فإنّ ربّ الناس معك.
5. أن لكل داعيةٍ طائفُه الخاص، فما من داعيةٍ أو مصلحٍ إلا ويمرّ في حياته بموقف أذى وانكسار يشبه ما حدث في طائف النبي صلى الله عليه وسلم، وسيواجه التجاهل والسخرية وربما الظلم من قومه في بادئ الأمر، لكنها محطة ابتلاء وتمحيص لا بد منها، فإذا صبر وثبت ولم يستسلم لليأس، سيقيّض الله له عدّاسًا يهتدي على يديه، ويفتح له طريقًا للنصر من حيث لا يحتسب.
لم تكن الرحلة إلى الطائف رحلة يأس وهزيمة كما قد يُظَنّ، بل كانت في حقيقتها رحلة أملٍ ونصرٍ للإيمان، انكسر فيها الجسد، ولكن الروح ارتفعت بها إلى آفاق التسليم واليقين والثبات.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج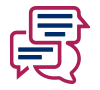 استشارات الحج
استشارات الحج

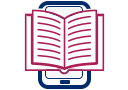












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات