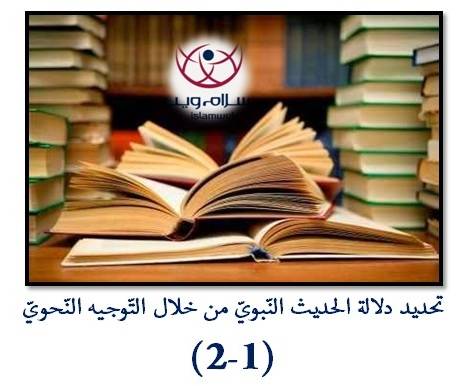
ليس غريبًا أنْ يُطلق السّابقون من أهل المعرفة على (النَّحْو) بأنّه: "قانون اللُّغة، وميزان تقويمها"، إذ الإعراب هو "الإبانة عن المعاني بالألفاظ"، وبما أنَّ النَّحْو هو انتحاء سَمْت كلام العرب في تصرّفه وإعرابه وغيره، ليلحق مَن ليس مِن أهل اللُّغة العربيّة بأهلها في الفصاحة؛ فهو الوسيلة لفهم النّصوص العربيّة، بما فيها حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ثُمّ إنَّ معرفة الحديث النّبويّ الشّريف تنقسم -عند أهل الشَّأن- إلى معرفة ذات، وصفات؛ فالذّات هي معرفة وزن الكلمة وبنائها، وتأليف حروفها وضبطها، وأمّا الصّفات فهي معرفة حركات الكلام وإعرابه؛ لئلا يختلّ فاعل بمفعول، أو خبر بأمر، أو غير ذلك من المعاني الّتي يُبنَى فهم الحديث النّبويّ عليها.
ومِن هنا تظهر العَلاقة القويّة للتّوجيه النَّحْويّ بالحديث الشّريف، حتَّى قال شُعبة بن الحَجّاج رحمه الله: "مَثَلُ صاحب الحديث الّذي لا يَعْرِفُ العربيَّةَ، مثل الحمار عليه مخلاة لا عَلَفَ فيها".
وقال حمَّاد بن سلمة رحمه الله: "مَن طلب الحديث ولم يتعلّم النَّحو -أو قال: العربيّة- فهو مثل الحمار، تُعَلَّقُ عليه مخلاة ليس فيها شعير".
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ مَن لَحَنَ في كلام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يُتْقنه، وأحدث التباسًا، وأُفهم منه غير المقصود؛ فإنّه يُخشَى عليه أنْ يدخل في قوله عليه الصّلاة والسّلام: (مَن كَذَبَ عليَّ متعمّدًا فليتبوّأ مقعده مِن النّار) متّفق عليه.
وفي ذلك قال الحافظ العراقيّ في ألفيّته:
ولْيَحذر اللَّحـــــانُ والمُصَحِّفا *** على حديثه بأنْ يُحَــــرّفا
فيدخل في قوله: (مَن كذب) *** فَحُقَّ النَّحوُ على مَن طلبا.
فوجبَ تعلَّم النّحو على مَن أراد علم الحديث النّبويّ الشّريف.
التَّوجيه النَّحْويّ للأدوات في اللُّغة العربيّة
عَمَدَ بعض الباحثين اللُّغويّين إلى دراسة التَّوجيه النَّحْويّ للأدوات في اللُّغة العربيّة، وأثره في تحديد دَلالة الحديث النّبويّ الشّريف؛ ومن هذه الأدوات:
أولًا: (أو).
(أو) أداة عطف، ذُكرت لها معانٍ وصلت إلى اثني عشر معنى، وقد ذهب الكوفيّون إلى القول بمجيئها بمعنى (الواو)، وبمعنى (بل)، ومنعه البصريّون.
وذَكَر المحقّقون مِن النُّحاة أنّ (أو) موضوعة لأحد الشّيئين، أو الأشياء، وأمّا المعاني الأخرى؛ كالشَّك والإبهام والتَّخيير والإباحة والتَّقسيم والإضراب، فهي مستفادة مِن القرائن السّياقيّة للكلام.
ومِن النّماذج الّتي درسوها مِن كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: دَلالات (أو) في قوله عليه الصّلاة والسّلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كُنْ في الدُّنيا كأنّك غريبٌ، أو عابر سبيل..) رواه البخاريّ.
قيل في (أو): إنّها للتّخيير، والإباحة، وقيل: إنّها بمعنى (بل)؛ أي: إنّه شبّه النَّاسك بالغريب، ثمّ عَدَلَ وأضرب عن هذا التّشبيه؛ فقال: (أو عابر سبيل)، أي: بل عابر سبيل؛ لأنّ الغريب قد يسكن في بلاد الغربة بخلاف عابر السّبيل.
وقد وجَّه الباحثون (أو) في هذا الحديث النّبويّ الشّريف؛ فقالوا: وقعت (أو) في الحديث بعد طلب، لذا جاز فيها التَّخيير والإباحة والإضراب، فإذا قلنا: إنَّ المعنى هو التَّخيير أو الإباحة؛ فمعنى الحديث سيكون أوسع، أي: إنْ شئتَ فكُن كالغريب اسْكُن واعمل، لكنْ لا تنسَ الرّحيل والعودة إلى الدَّار الآخرة، أو كُن كعابر سبيل مشغولًا أبدًا بالرّحيل فلا يحطّ الرّحال حتّى يسير، إلى أنْ يبلغ غايته، ويصل إلى مأواه.
أمّا إذا كان المعنى (بل عابر سبيل)؛ أي: كُن كعابر سبيل، فهذا المعنى -وإنْ ذهب إليه عددٌ من العلماء- فإنَّ ظاهره لا يتوافق مع قوله تعالى: {ولا تَنْسَ نصيبكَ مِن الدّنيا} (القصص: 77)، ومع قوله سبحانه: {إنّي جاعلٌ في الأرض خليفة} (البقرة: 30)، والخليفة لا يكون كعابر سبيل.
أمّا إذا أراد النّصيحة لشخص بعينه دون التّعميم، فربّما تصحّ له، وإلا أصبح المسلمون كلّهم كعابري سبيل، وتركوا العمل الدّنيويّ، وأصبحوا عالة على غيرهم، وهذا -بكلّ تأكيد- ما لم يقصده أفصح العرب صلّى الله عليه وسلّم، وهو يتوافق مع مذهب البصريّين.
ثانيًا: (حتَّى).
المعنى العام لدَلالات (حتَّى) في اللُّغة هو: الغاية، ولها ثلاثة أقسام: فتكون حرف ابتداء، وتكون حرف عطف، وتكون حرف جرّ.
ومِن معانيها ها هنا هو القسم الأخير من هذه الاقسام؛ فإنْ كانت حرف جرّ فإنّها تدخل على الأعيان؛ نحو: قام القومُ حتَّى زيدٍ، وتدخل على المصدر الصّريح؛ نحو: سِرتُ حتَّى غروبِ الشّمس، وتدخل على المصدر المؤّول، فتدخل على الفعل المضارع، وتنصبه بـ(أنْ) مضمرة، ويقدّر بمصدر مؤّول.
و(حتَّى) الدّاخلة على الفعل المضارع لها معانٍ عدَّة؛ فتكون مرادفة لـ(إلى)، وتكون مرادفة لـ(كي) التَّعليليّة، وتكون مرادفة لـ(إلا) في الاستثناء.
وكُلّ موضع دخلت فيه (حتَّى) على الفعل المضارع إذا صلحت فيه بمعنى (إلى أن)، أو (كي) فينصب الفعل بعدها، وإلا فيرفع.
ومِن دَلالات (حتَّى) في الأحاديث النّبويّة الشّريفة: قوله صلّى الله عليه وسلّم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أُمرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمّدًا رسول الله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم، وأموالهم إلا بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله) متّفق عليه.
قال الكرمانيّ، وابن الملقّن، وابن حجر، والعينيّ: "إنَّها - أي: حتَّى - للغاية، فقد تكون غاية للقتال، وقد تكون غاية للأمر به"، وقيل: يجوز أنْ تكون للتّعليل.
فإنْ كانت بمعنى (إلى أنْ) كانت الغاية مِن المقاتلة أنْ يشهدوا، ويقيموا، ويؤتوا، فإنْ فعلوا هذا عصموا دماءهم، وإنْ جحدوا باقي الأحكام، ولذا جاء في نهاية الحديث: (إلا بحقّ الإسلام) ليزيل هذا الاشتباه، ويُدخل فيه جميع أحكام الإسلام.
وإنْ كانت (حتَّى) للتَّعليل كان المعنى: أُمرتُ أنْ أقاتل النَّاس ليشهدوا؛ أي: إنَّ قتالي لهم لأجل أنْ يشهدوا، فإنْ فعلوا دخلوا في حُكْم الإسلام، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم مِن واجبات، وحدود، وغيرها.
ويُستَدَلُ بهذا الحديث أنَّ مَن أخلَّ بواحدٍ ممّا بعد (حتَّى) كترْكِه الصَّلاة عمْدًا معتقدًا وجوبها يُقتل.
ويُردُّ عليه بأنَّ (المقاتلة) غير (القتْل)؛ لأنَّ الأُولى تدلّ على المفاعلة، والمشاركة بين اثنين، يفعل كلّ واحد منهما فعلًا بصاحبه، وليس كذلك القتل.
وبهذا يظهر أنَّ المقاتلة مستمرّة إلى حصول الغاية، والنّتيجة الّتي كان لأجلها أَمْرُ المقاتلة؛ فعلى هذا يصحُّ في (حتَّى) أنْ تكون بمعنى (إلى)، وكذلك يصحُّ أنْ تكون بمعنى التَّعليل.
ولهذا الموضوع بقيّة في مقال لاحق بإذن الله تعالى.


 المقالات
المقالات









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات