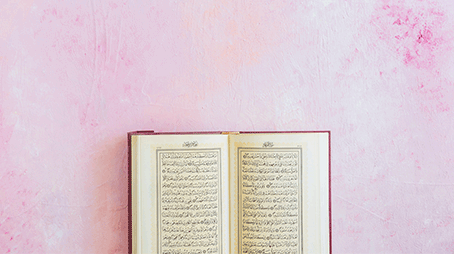
في سورة مريم نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: {لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} (مريم:87) فمن الذين لا يملكون الشفاعة؟ وهل من أحد يملك الشفاعة يوم القيامة؟ وما المراد بـ (العهد) في الآية؟
نقول بداية: إن معنى {لا يملكون} أي: لا يستطيعون، فإن (المِلْك) يُطلق على المقدرة والاستطاعة.
ثم إن بعض أهل العلم قال: إن الضمير (الواو) في قوله سبحانه: {لا يملكون} راجع إلى (المجرمين) المذكورين في قوله: {ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا} (مريم:86) أي: لا يملك المجرمون الشفاعة، ولا يستحقون أن يشفع فيهم شافع، يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب.
وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: {فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم} (الشعراء:100-101) وقوله سبحانه: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} وقوله عز وجل: {وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} (غافر:18) وقوله عز من قائل: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون} (الأنبياء:28) ونحو ذلك من الآيات الكريمات.
وهذا الوجه يُفْهَمُ منه بالأحرى أن (المجرمين) لا يشفعون في غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم، فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الضمير (الواو) في {لا يملكون} راجع إلى {المجرمين} فالاستثناء منقطع، و(من) في قوله سبحانه: {إلا من اتخذ} في محل نصب، والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً، يملكون الشفاعة، أي: بتمليك الله إياهم وإذنه لهم، فيملكون الشفاعة بما تقدم ذكره، ويستحقها به المشفوع لهم، قال تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} (البقرة:255) وقال جل شأنه: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} (الأنبياء:28) وقال العلي القدير: {وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} (النجم:26).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير (الواو) في قوله عز وجل: {لا يملكون} راجع إلى (المتقين) و(المجرمين) جميعاً المذكورين في قوله: {يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا * ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا} (مريم:86)، وعليه فالاستثناء في قوله: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} متصل، و(من) بدل من (الواو) في {لا يملكون} أي: لا يملك من جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً، وهم المؤمنون، و(العهد) العمل الصالح، والقول بأنه (لا إله إلا الله)، وغيره من الأقوال يدخل في ذلك، أي: إلا المؤمنون، فإنهم يشفع بعضهم في بعض، كما قال تعالى: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا} (طه:109)، وقد بيَّن تعالى في مواضع أُخر من كتابه الكريم: أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة، وأن من شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك، كما في قوله تعالى: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} (الزخرف:86) أي: لكن من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك. وقال تعالى: {ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين} (الروم:12-13). وقال عز وجل: {ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون} (يونس:18). والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة.
واتخاذ (العهد) هو الإيمان بالله والعمل الصالح؛ أي لكن من آمن وعمل صالحاً، فإنه يشفع للعصاة على ما وعد الله تعالى. ويجوز أن يكون (العهد) بمعنى الإذن والأمر، يقال: أخذت الإذن في كذا واتخذته بمعنى، من باب (عهد الأمير إلى فلان بكذا) إذا أمره به، أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة، المأذون له فيها، ويؤيده ما تقدم من الآيات الناصَّة على الإذن بالشفاعة.
ومن أقوال العلماء في (العهد) المذكور في الآية: أنه المحافظة على الصلوات الخمس، واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره) متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله سبحانه: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} قال: (العهد) شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله. رواه الطبري. فمن اتخذ عند الله عهداً، فآمن به وبرسله واتبعهم، فإنه ممن ارتضاه الله، وتحصل له الشفاعة، كما قال تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} وسمَّى الله الإيمان به واتباع رسله عهداً، لأنه عَهِدَ في كتبه وعلى ألسنة رسله، بالجزاء الجميل لمن اتبعهم، وسار على دربهم.
وقال بعضهم: العهد المذكور: هو أن يقول العبد كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاً، ووضعها تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. ذكره القرطبي بهذا اللفظ مرفوعاً عن ابن مسعود، وقال السيوطي: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وليس فيه قوله: فإذا قال ذلك. وذكر السيوطي أيضاً: أن الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الشنقيطي: "الظاهر أن المرفوع لا يصح، وأن (العهد) في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه".
فـ (العهد) الذي يأخذه العبد على الله بالشفاعة، أن يقدم من الحسنات ما يسع تكاليفه، ثم يزيد عليها ما يؤهله لأن يشفع للآخرين، والخير لا يضيع عند الله، فما زاد عن التكليف فهو في رصيد للعبد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا يهمل مثقال ذرة.
وعلى المؤمن مهما كان مسرفاً على نفسه، عندما يرى إنساناً مقبلاً على الله مستزيداً من الطاعات، أن يدعو له بالمزيد، وأن يفرح به؛ لأن فائض طاعاته لعله يعود إليه، ولعله يحتاج شفاعته في يوم من الأيام. أما من يحلو له الاستهزاء والسخرية من أهل الطاعات، كما أخبر الحق تبارك وتعالى: {إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون} (المطففين:29-32). فكيف سيقابل العاصي أهل الطاعات، ويطمع في شفاعتهم بعد ما كان منه؟ فإن لم يكن طائعاً، فلا أقل من أن يحب الطائعين، ويطلب منهم الدعاء، فهذه في حد ذاتها حسنة له، يرجو نفعها يوم القيامة.
وما أشبه الشفاعة في الآخرة بما يحدث من شفاعة في الدنيا، فحين يستعصي على المرء قضاء مصلحة يقال له: اذهب إلى فلان، وسوف يقضيها لك. وفعلاً يذهب معه فلان هذا، ويقضي له حاجته، فلماذا قضيت على يديه هو؟ لا بد أن له عند صاحب الحاجة هذه أياديَ لا يستطيع معها أن يرد له طلباً.
إذن: لا بد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات، يسمح له بالشفاعة، وإذا تأملنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه أول من قدم رصيداً إيمانياً، وسع تكليفه وتكليف أمته، ألم يخبر عنه سبحانه بقوله: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم} (التوبة:61) لذلك أكرمه الله بالشفاعة وأذن له فيها.
والحق تبارك وتعالى لا يُضيع رصيد العبد من الطاعات أبداً، فكل ما قدم من طاعات فوق ما كلفه الله به مُدَّخَرٌ له، حتى إن الإنسان إذا اُتُّهم ظلماً، وعوقب على عمل لم يرتكبه، فإن الله يدخره له، ويستر عليه ما ارتكبه فعلاً، فلا يعاقبه عليه.
وخلاصة القول أن (العهد) في قوله تعالى: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} أن يدخل العبد مع ربه في مقام الإحسان، ولا يدخل هذا المقام إلا من أدى ما عليه من تكليف، وإلا فكيف يكون محسناً من كان مقصراً في مقام الإيمان؟ ولنتأمل قول الحق تعالى: {إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} (الذاريات:15-19) فالمحسن من يؤدي من الطاعات فوق ما فرض الله عليه، ومن جنس ما فرض الله عليه، ويرجو الثواب والأجر من الله.
ونختم بقول ابن عجيبة (ت1224هـ) عند تفسيره لهذه الآية، قال: "اعلم أن (العهد) الذي تكون به الشفاعة يوم القيامة، هو الطاعة وتربية اليقين والمعرفة، فتقع الشفاعة لأهل الطاعات على قدر طاعتهم وإخلاصهم، وتقع لأهل اليقين على قدر يقينهم، وهم أعظم من أهل المقام الأول، وتقع لأهل المعرفة على قدر عرفانهم، وهم أعظم من القسمين". فلا شفاعة يوم القيامة إلا لمن قدم عملاً صالحاً، فهو (عهد) له عند الله يستوفيه. وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن يجزيه الجزاء الأوفى، ولن يخلف الله وعداً، {وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا} (الكهف:88) {وعد الله لا يخلف الله وعده} (الروم:6).


 المقالات
المقالات









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات