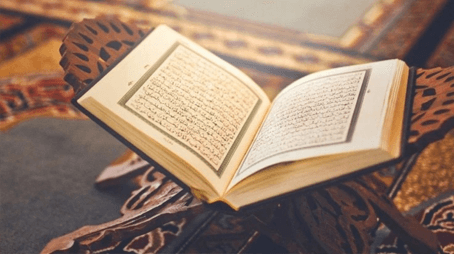
معرفة مواضع الوقف والابتداء في القرآن الكريم أمر على غاية من الأهمية، وقد صحَّ عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سئل عن تفسير قوله تعالى: {ورتل القرءان ترتيلا} (المزمل:4) أنه قال: "الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف".
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لقد عشنا بُرْهَةً من دهرنا، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد ﷺ، فنتعلم حلالها وحرامها، وآمِرَهَا وزَاجِرَهَا، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تَعَلَّمُونَ أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمِرُهُ ولا زَاجِرُهُ، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل) (الدقل) أَرْدَأُ التمر.
وقد وضع العلماء عدداً من الضوابط، يُضبط من خلالها مواقع الوقف والابتداء، نجملها وفق الآتي:
الضابط الأول: لا يجوز الوقوف على ما لا يتم به المعنى.
تفصيل هذا الضابط: أنه لا يجوز أن يوقف على العامل دون المعمول، ولا المعمول دون العامل، وسواء أكان العامل اسماً أم فعلاً أم حرفاً، وسواء أكان المعمول مرفوعاً أم منصوباً أم مخفوضاً، عمدة أو فضلة، متحداً أو متعدداً.
ولا يوقف أيضاً على الموصول دون صلته، ولا على ما له جواب دون جوابه، ولا على المستثنى منه قبل المستثنى، ولا على المتبوع دون التابع، ولا على ما يُستفهم به دون ما يُستفهم عنه، ولا على ما أُشير به دون ما أُشير إليه، ولا على الحكاية دون المحكي، ولا على القَسَمِ دون المقْسَمِ به، وغير ذلك مما لا يتم المعنى إلا به.
الضابط الثاني: كلمة {كلا} وردت في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين (33) موضعاً؛ منها سبعة للردع يوقف عليها بالاتفاق، وهي:
- قوله تعالى: {أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا * كلا} (مريم:78-79).
- قوله تعالى: {واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا} (مريم:81-82).
- قوله تعالى: {ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون * قال كلا} (الشعراء:14-15).
- قوله تعالى: {قال أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا} (الشعراء:61-62).
- قوله تعالى: {قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم} (سبأ:27).
- قوله تعالى: {ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا عنيدا} (المدثر:15-16).
- قوله تعالى: {يقول الإنسان يومئذ أين المفر * كلا لا وزر} (القيامة:10-11).
والباقي من موارد {كلا} منها ما هو بمعنى حقَّا، أي: قطعاً، فلا يوقف عليه، كقوله سبحانه: {كلا والقمر} (المدثر:32) وقوله تعالى: {كلا إذا دكت الأرض دكا دكا} (الفجر:21) ونحوهما، ومنها ما احتمل الأمرين، ففيه الوجهان، كقوله سبحانه: {يحسب أن ماله أخلده كلا} (الهُمَزة:3) فمن القراء من يقف عليها أينما وقعت، وغلب عليها معنى الزجر. ومنهم من يقف دونها أينما وقعت، ويبتدئ بها، وغلب عليها أن تكون لتحقيق ما بعدها. ومن القراء من نظر إلى المعنيين؛ فيقف عليها إذا كانت بمعنى الردع؛ ويبتدئ بها إذا كانت بمعنى التحقيق، وهو أولى.
وإذا تتبعنا هذه اللفظة في القرآن الكريم، فإننا سوف نجد أنها لم تُذكر إلا في النصف الثاني من القرآن الكريم، وفى السور المكية فحسب. والسبب في ذلك أن {كلا} تفيد الردع والزجر والرد على الكفار في ما يزعمون أو يدَّعون.
الضابط الثالث: كلمة {بلى} جاءت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعاً، وهي على أقسام ثلاثة:
الأول: لا يجوز الوقف عليه بالإجماع؛ لتعلِّق ما بعدها بما قبلها؛ وذلك في سبعة مواضع:
- {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا} (الأنعام:30)
- {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا} (الأحقاف:34).
- {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا} (النحل:38).
- {وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم} (سبأ:3).
- {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن} (التغابن:7).
- {بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها} (الزمر:59).
- {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} (القيامة:4).
الثاني: المختار فيه عدم الوقف، وذلك في خمسة مواضع:
- {قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} (البقرة:260).
- {وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} (الزمر:71).
- {بلى ورسلنا لديهم يكتبون} (الزخرف:80).
- {ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم} (الحديد:14).
- {قالوا بلى قد جاءنا نذير} (الملك:9).
الثالث: المختار فيه جواز الوقف عليه، وهي العشرة الباقية:
الضابط الرابع: قال ابن الجزري: "كل ما أجازوا الوقف عليه، أجازوا الابتداء بما بعده".
الضابط الخامس: كل ما في القرآن من {الذي} و{الذين} يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً، والقطع على أنه خبر، إلا في سبعة مواضع، فإنه يتعين الابتداء بها، وهي:
- {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته} (البقرة:121).
- {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} (البقرة:146) و(الأنعام:20).
- {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} (البقرة:275).
- {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله} (التوبة:20).
- {الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا} (الفرقان:34).
- {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم} (غافر:7).
وذكر الزمخشري في "الكشاف" في قوله تعالى: {الذي يوسوس} (الناس:5) أنه يجوز أن يقف القارئ على الموصوف {الخناس} (الناس:4) ويبتدئ بـ {الذي} إن حملته على القطع، بخلاف ما إذا جعلته صفة، فيتعين الوصل.
وقال الرماني: الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها، وإن كانت للمدح جاز؛ لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف.
الضابط السادس: كلمة {نعم} وردت في القرآن في أربعة مواضع، وضابط الوقف عليها وعدمه: أنه إن وقع بعدها (واو) لم يجز الوقف عليها، وإن لم يقع بعدها (واو) فالمختار الوقف عليها؛ لأن ما بعدها غير متعلِّق بما قبلها. ومثال ذلك قوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} (الأعراف:44) فالمختار هنا الوقف على {نعم} لأن ما بعدها غير متعلِّق بما قبلها، حيث إنها من قول الكفار، وما بعدها {فأذَّن} ليس من قولهم.
وأما المواضع الثلاثة الباقية التي وردت فيها كلمة {نعم} فإنه لا يوقف عليها؛ لكونها مرتبطة ومتعلِّقة بما بعدها، وهي:
- قوله تعالى: {وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقربين} (الأعراف:113-114).
- قوله سبحانه: {قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين} (الشعراء:41-42).
- {أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون} (الصافات:16-18).
تلك إذن أهم بعض ضوابط الوقف والابتداء التي ينبغي على قارئ القرآن الكريم مراعاتها؛ لما يترتب على ذلك من فَهْمٍ وتدبر للقرآن الكريم؛ إذ المقصد الأساس من قراءة كتاب الله الفهم والتدبر ومن ثم العمل، والله الموافق للصواب، والهادي إلى سبيل الرشاد.


 المقالات
المقالات









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات