السؤال
بارك الله فيكم، وفي جهدكم، ونفع بكم الإسلام وأهله، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول، والعمل.
شيخي الفاضل: أشكو لكم بعد الله تعالى ما يؤذي نفسي، ويؤلم فؤادي من أمري.
ولكي أريكم من أمري ما يعينكم بإذن الله على الحكم فيه بما شرع.
أرجو أن تصبروا على طول مسألتي.
قصتي أني منذ كنت طفلا في المرحلة الابتدائية، وفي مادة الحديث، قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فلانت نفسي، واقشعر بدني، واستقر هذا الكلام من الذي لا ينطق عن الهوى، داخل قلبي، وسألت الباري عز وجل من حينها أن يفقهني في الدين، وما جعلني أدعو بذلك بعد فضل الله ورحمته، رغبتي في أن أشعر بأن الله راض عني، وأنا أسير على الأرض.
الحقيقة أني لم ألتحق بحلق علمية وما شابه، ولكن كان لي اطلاع- أقسم بالله أنه لا يكاد يذكر- صفحات معدودة في تفسير ابن كثير، وزاد المعاد، وبعض الكتب الأخرى في الفقه على المذاهب الأربعة، وبداية المجتهد لابن رشد، رغم يقيني بأني لست للاجتهاد كفؤا، ولكن من باب المطالعة، وأقسم بالله لا أقولها تواضعا، ولكنها كانت مجرد صفحات، واطلاع على بعض الفتاوى هنا وهناك في المواقع الموثوقة كموقعكم، وموقع ابن باز وغيرها، وأقارن أحيانا بين الآراء في المسألة، وأدرك أن من كان معلمه كتابه؛ غلب خطؤه صوابه. المهم أني شعرت بأن الله يفتح لي، وأرجو ألا يكون استدراجا، فحين أتفكر في الآية، أو الحديث، أو في مسألة فقهية، يتبين لي من ذلك ما يطابق آراء علمائنا السابقين، وكنت أسعد بذلك، إلا أني أصبحت أرى في نفسي العُجب، وأخشى من الرياء رغم قلة ما عندي من المعلومات، وأعلم أن ذلك قد يكون من مداخل الشيطان ليصدني عن طلب العلم، إلا أني أصبحت أغتم لذلك غما شديدا، خاصة أني لست في منطقة فيها حلق علمية، فلم أختلط بطلاب علم لأقارن بين ما أجد، وما يجدون في أنفسهم.
من أصحابي من لمح قليلا معرفتي، فيستفتيني في أمور، وأنا طبعا لا أفتيهم برأيي دون معرفة قول عالم عدل ثقة، وإن كانت المسألة تتعلق بما يدور في أيامنا هذه، فإني أحرص على أن أعود لآراء علمائنا في نفس البلد لكيلا أسبب فتنة من حيث لا أشعر، إلا أني أرغب أحيانا في أن ألا أجيب على أسئلتهم؛ لأني لست والله من أهل العلم، فأتذكر لجام النار، وأخشى أحيانا إن أنا سكت من اجتهادات من لا ينبغي له الحديث، خصوصا في الأمور العقدية، والصلاة، وأركان الإسلام فأتدخل، وأشعر أحيانا بالعجب، وبأني مرائي.
أنا أعلم تماما الأفضل لي، ولو كنت بذلت جهدا، فكيف بي وأنا لم أبذله، فأنا متيقن أنه لم يبلغ أحد ما بلغ من العلم إلا بفضل الله، فيقرأ الإنسان في الشرع سطرين، فيفتح له الله بذلك فتحا من عنده، ومع ذلك أضجر مما أنا فيه، وينفطر قلبي عند سماع قول الله: ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) رغم علمي ببعض ما قيل في سبب نزولها، والأقوال التي قرأت في موقعكم المبارك، إلا أنها تهزني، وغيرها الكثير من الآيات، والأحاديث، فأنا لست ملتحيا، ولي من الذنوب ما يجعلني أشعر أحيانا أن علمي ببعض المسائل ما هو إلا فتنة لي، فلو كنت أريد بها وجه الله ما حلقت ذقني، وارتكبت ما أرتكب، أسأل الله الهداية والمغفرة.
فهل يحق لي أن أفتي من يسألني إذا كنت متيقنا من الحكم، أم يجوز لي السكوت بحجة أني لست أهلا للفتيا؟
وإذا جاز لي التحدث. فماذا أصنع بشعوري بمخالطة الرياء، والعجب قلبي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بما رزقك الله من العلم، والفهم، والحرص على التفقه في الدين، وإفادة غيرك مما تعلم، فهذا خير وفضل عظيم، لكنه يبقى ناقصا من وجهين: أولهما عدم اعتمادك على شيخ في الدراسة، وذلك نقص كبير، وخلل بيِّن في التحصيل، ينبغي أن تعالجه مستقبلا إن وجدت شيخا تتعلم على يديه، وتسأله عما يشكل عليك. والثاني: عدم تطبيقك لبعض ما علمت، حيث أشرت إلى بعض المخالفات الشرعية التي يظهر من كلامك ارتكابها مع العلم بالنهي الوارد فيها، وفائدة العلم التطبيق، وإلا كان حجة على صاحبه، وقد كان سلفنا الصالح حريصين على التطبيق، كحرصهم على التحصيل إن لم يكن أشد.
جاء في مجالس شهر رمضان للعثيمين: قال أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله-: حدثنا الذين كانوا يُقْرِئُوننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات، لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم، والعمل, قالوا: فتعلمنا القرآن، والعلم، والعمل جميعا. اهـ.
ومع هذا فإننا نشد على يديك، ونوصيك بالمواصلة في هذا الدرب العظيم مع الأخذ بالملاحظتين السابقتين، وتجديد التوبة كلما لاحظت انحرافا عن جادة الطريق.
وتذكر أن ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلا تجعل من خطئك، أو تقصيرك سببا لترك التعلم، ونشر الخير، بل جاهد نفسك على اجتناب ما لا يرضي المولى سبحانه، وإن حصل خطأ، أو ذنب، فبادر بالتوبة والاستغفار، وهذا المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن في حياته.
وبخصوص شعورك بالرياء، أو العجب فإننا نخشى أن يكون ذلك شعورا وهميا، يهدف منه الشيطان إلى صدك عن سبيل الله. فإن كان الأمر كذلك، فلا تفتح للوساوس الشيطانية بابا إليك، بل أعرض عنها بالجملة، وإن كان الشعور بالرياء حقيقيا، فحاول التخلص منه، ومن أهم ما يعين على ذلك، الاستعانة بالله تعالى، والالتجاء إليه ليصرف عنك هذا الداء الخبيث، واستشعار مراقبته سبحانه، وأنه مطلع على ما خفي، وما ظهر منك، مع الحرص على إخفاء العبادة، وعدم إظهارها، وتذكر ما توعد الله تعالى به المرائين من سخطه، وعقابه.
وأما بخصوص الفتوى لمن يسألك، فإن من يفتي في شرع الله لا بد أن يكون عالما بالمسألة التي يفتي فيها بدليلها، أو يكون ناقلا لها عن إمام معتبر.
فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين، عند كلامه على شروط الإفتاء عند العلماء، وحكم فتوى المقلد: والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل؛ قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعاليقه، قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول: سمعت أبا الحسين بن بشران يقول: ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل، استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها. اهـ.
ولذلك، فإذا علمت حكم مسألة من الشرع، وضبطت ما قال العلماء فيها، جاز لك أن تفتي من سألك عنها، وربما وجب عليك ذلك إذا لم يجد السائل غيرك؛ وانظر الفتوى رقم: 59501.
ولمعرفة شروط، وصفات المؤهل للفتوى انظر الفتوى رقم: 176935.
أما إذا كنت لا تعلم ما يسأل عنه السائل، فحرام عليك أن تفتيه؛ لأن ذلك قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم، قرين الشرك -والعياذ بالله- فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

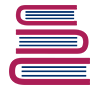
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات