السؤال
أعاني من ضعف الثقة في النفس، والحساسية الشديدة من كلام الناس عني، حيث إن كل من يراني يقول لي: إن مشيتي فيها تكبر، وهذا يسبب لي الإحراج، حتى أني أصبحت أتفادى الخروج والمشي في طريق يراني فيها الناس، وحاولت أكثر من مرة تغيير مشيتي، والعلاج عند أخصائي نفسي، لكن لا شيء تغير، والناس أصبحوا يتحدثون عني بسوء، ويتحاشون حتى الحديث معي بما فيهم المتدينون، وأصبحت أخشى أن يكون هذا عقابًا من الله، ومن بغضه سبحانه وتعالى لي، خاصة إن كانت لي ذنوب كبائر، فبماذا تنصحوني -من فضلكم-؟ وهل كره الناس لي، دليل على كره الله سبحانه وتعالى، وعدم رضاه عني؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأخ السائل يعاني من ضعف الثقة بالنفس، والحساسية الشديدة من كلام الناس، فلا يبعد أن يكون في وصفه لحال الناس معه نوع من المبالغة، بسبب فرط حساسيته، وضعف ثقته بنفسه!
وعلى أية حال؛ فالذي يحسن علاقة المرء بالناس هو حسن خلقه معهم، بجانب قيامه بحقوق الله تعالى وعبادته، مع المبادرة إلى تصحيح ما يبدر من خطأ أو تقصير، وأداء ما فات من الحقوق، وهذا ما جمعته وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا لما بعثه إلى اليمن، فقال: "يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن". وكان معاذ -رضي الله عنه- من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية ... فعلم أنها وصية جامعة .. وبيان جمعها: أن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل. وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانًا: إما بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {اتق الله حيثما كنت}، وهذه كلمة جامعة، وفي قوله: "حيثما كنت" تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال: {وأتبع السيئة الحسنة تمحها}، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضرًّا، أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيّس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات ... فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات. والحسنات: ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال، والأخلاق، والصفات. ومما يزيل موجب الذنوب: المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من همّ، أو حزن، أو أذى في مال، أو عرض، أو جسد، أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح، وإصلاح الفاسد، قال: {وخالق الناس بخلق حسن}، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، والدعاء له، والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم، والمنفعة، والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم، أو مال، أو عرض. وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب. اهـ.
وأما السؤال عن كره الناس، وهل هو دليل على كره الله تعالى؟ فهذا أمر معتبر من حيث الجملة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادى جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري مسلم. ولكن المحبة والقبول المذكور في هذا الحديث محله أهل الحق من أولياء الله وعباده الصالحين.
قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: (ثم يوضع له القبول في الأرض): يعني أنه يقبله أهل الحق الذين يقبلون أمر الله سبحانه، وإنما يحب أولياء الله من يحب الله، فأما من يبغض الحق من أهل الأرض، ويشنأ الإسلام والدين؛ فإنه يريد لكل ولي لله محبوب عند الله مقتًا وبغضًا. اهـ.
وقال العيني في عمدة القاري: قيل: يوضع له القبول في الأرض عند الصالحين، ليس عند جميع الخلق. اهـ.
وقال فيصل المبارك في تطريز رياض الصالحين: المراد بالقبول: الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخير. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 200529.
ثم نلفت نظر السائل إلى أن العادات السيئة، والأخلاق الرديئة، إن وجدت في المرء، فيمكنه بالاجتهاد، والمثابرة، والمصابرة أن يغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه. رواه الخطيب البغدادي، وحسنه الألباني. هذا مع تحري اختيار الرفقة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعين عليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه الألباني.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 


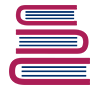
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات