الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا: أن الانتصار من الظالم بقدر ظلمه جائز، وأن العفو أفضل، وأقرب للتقوى، لكن إن كان العفو يجرّئ هذا السفيه على التمادي في ظلمه، وعدوانه، لم يشرع العفو، بل المشروع أن ينتصر الشخص لنفسه، إذا لم يكن العفو أصلح، كما قال الله: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ {الشورى:41}، قال ابن الجوزي: وليس للمؤمن أن يُذِلَّ نَفْسه، فينبغي له أن يَكْسِر شوكة العُصاة؛ لتكون العِزَّة لأهل الدِّين. قال إبراهيم النخعي: كانوا يَكرهون للمؤمنين أن يُذِلّوا أنفُسَهم، فيجترئَ عليهم الفُسّاق، فإذا قَدَروا عَفَوْا. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: لكن الإنسان تزيّن له نفسه أن عفوه عن ظالمه يجرّيه عليه، وليس كذلك؛ بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ثلاث إن كنت لحالفًا عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
فالذي ينبغي في هذا الباب أن يعفو الإنسان عن حقه، ويستوفي حقوق الله بحسب الإمكان، قال تعالى: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. قال تعالى: {هم ينتصرون}، يمدحهم بأن فيهم همة الانتصار للحق، والحمية له؛ ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزًا، وذلًّا؛ بل هذا مما يذم به الرجل، والممدوح العفو مع القدرة، والقيام لما يجب من نصر الحق، لا مع إهمال حق الله، وحق العباد. انتهى.
فإذا علمت أين يستحب العفو، وأنه إنما يستحب مع القدرة، لا مع العجز، وإنما يستحب في حقوق العبد، لا في حقوق الله تعالى، وأنه إنما يستحب حيث كانت فيه مصلحة، بأن كان الباغي نادمًا، وكان العفو عنه لا يجرِّئه على التمادي في ظلمه، وعدوانه؛ فاعلم أن ضابط الانتصار هو: ألا يزيد على ما اعتدي عليه به، كما قال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا {الشورى:40}.
ثم إن هذا الانتصار إنما يشرع حيث وجدت القدرة، وأمنت المفسدة، فإذا خشي العبد ترتب مفسدة أكبر على انتصاره، فلا حيلة إلا الصبر، كما قال تعالى: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ {البقرة:109}.
والعاقل اللبيب يضع الدواء في موضع الداء، ولا يشتبه عليه الشجاعة والتهور، ولا التواضع والمهانة، ولا الحلم والصفح والعجز.
ونحن نسوق لك من كلام ابن القيم -رحمه الله- طرفًا، يتبين به بعض الفروق بين تلك الأخلاق؛ لتكون على بصيرة، قال -رحمه الله-: فصل: وَالْفرق بَين الشجَاعَة والجرأة: أَن الشجَاعَة من الْقلب، وَهِي ثباته، واستقراره عِنْد المخاوف، وَهُوَ خلق يتَوَلَّد من الصَّبْر، وَحسن الظَّن؛ فَإِنَّهُ مَتى ظن الظفر، وساعده الصَّبْر، ثَبت. كَمَا أَن الْجُبْن يتَوَلَّد من سوء الظَّن، وَعدم الصَّبْر، فَلَا يظنّ الظفر، وَلَا يساعده الصَّبْر. وأصل الْجُبْن من سوء الظَّن، ووسوسة النَّفس بالسوء ... فالشجاعة حرارة الْقلب، وغضبه، وقيامه، وانتصابه، وثباته. فَإِذا رَأَتْهُ الْأَعْضَاء كَذَلِك، أعانته؛ فَإِنَّهَا خدم لَهُ، وجنود. كَمَا أَنه إِذا ولى، ولت سَائِر جُنُوده.
وَأما الجرأة فَهِيَ: إقدام، سَببه قلَّة المبالاة، وَعدم النّظر فِي الْعَاقِبَة، بل تقدم النَّفس فِي غير مَوضِع الْإِقْدَام، معرضة عَن مُلَاحظَة الْعَارِض، فإمَّا عَلَيْهَا، وَإِمَّا لَهَا.
فصل: وَأما الْفرق بَين الحزم والجبن: فالحازم هُوَ الَّذِي قد جمع عَلَيْهِ همّه، وإرادته، وعقله، وَوزن الْأُمُور بَعْضهَا بِبَعْض، فأعد لكل مِنْهَا قرنه.
وَلَفْظَة الحزم تدل على الْقُوَّة، وَالْإِجْمَاع، وَمِنْه: حزمة الْحَطب، فحازم الرَّأْي هُوَ الَّذِي اجْتمعت لَهُ شؤون رَأْيه، وَعرف مِنْهَا خير الخيرين وَشر الشرين، فأحجم فِي مَوضِع الإحجام رَأيًا، وعقلًا، لَا جبنًا، وَلَا ضعفًا.
والْعَاجِز الرَّأْي مضياع لفرصته ... حَتَّى إِذا فَاتَ أَمر عَاتب القدرا.
وقال أيضًا: وَالْفرق بَين الْعَفو والذل: أَن الْعَفو إِسْقَاط حَقك جودًا، وكرمًا، وإحسانًا، مَعَ قدرتك على الانتقام، فتؤثر التّرْك رَغْبَة فِي الْإِحْسَان، وَمَكَارِم الْأَخْلَاق، بِخِلَاف الذل، فَإِن صَاحبه يتْرك الانتقام عَجزًا، وخوفًا، ومهانة نفس، فَهَذَا مَذْمُوم غير مَحْمُود، وَلَعَلَّ المنتقم بِالْحَقِّ أحسن حَالًا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذين إِذا أَصَابَهُم الْبَغي هم ينتصرون}، فمدحهم بقوتهم على الِانْتِصَار لنفوسهم، وتقاضيهم مِنْهَا ذَلِك؛ حَتَّى إِذا قدرُوا على من بغى عَلَيْهِم، وتمكنوا من اسْتِيفَاء مَا لهم عَلَيْهِ، ندبهم إِلَى الْخلق الشريف من الْعَفو، والصفح، فَقَالَ: {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا فَمن عَفا وَأصْلح فَأَجره على الله إِنَّه لَا يحب الظَّالِمين}، فَذكر المقامات الثَّلَاثَة: الْعدْل، وأباحه، وَالْفضل، وَندب إِلَيْهِ، وَالظُّلم، وَحرّمه.
فَإِن قيل: فَكيف مدحهم على الِانْتِصَار وَالْعَفو وهما متنافيان؟
قيل: لم يمدحهم على الِاسْتِيفَاء، والانتقام، وَإِنَّمَا مدحهم على الِانْتِصَار، وَهُوَ الْقُدْرَة، وَالْقُوَّة على اسْتِيفَاء حَقهم، فَلَمَّا قدرُوا ندبهم إِلَى الْعَفو، قَالَ بعض السّلف فِي هَذِه الْآيَة: كَانُوا يكْرهُونَ أَن يستذلوا، فَإِذا قدرُوا عفوا. فمدحهم على عَفْو بعد قدرَة، لَا على عَفْو ذل، وَعجز، ومهانة. وَهَذَا هُوَ الْكَمَال الَّذِي مدح سُبْحَانَهُ بِهِ نَفسه فِي قَوْله: وَكَانَ الله عفوًا قَدِيرًا. انتهى. وله تتمة حسنة، فلتنظر في كتاب الروح.
وبهذا التفصيل؛ يتضح لك هذا المقام، وتعلم الواجب فيه من المستحب، وتتبين أولى الأمرين المشتبهين، والعبد مع هذا يحتاج إلى بصيرة، واستعانة بالله تعالى، وتوفيق منه؛ فإن الهدى لأحسن الأخلاق، إنما هو هداه جلّ اسمه.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 


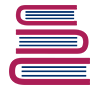
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات