السؤال
قدمت على منحة دراسية تتعلق بتصميم مواقع الإنترنت، ولها عدة اختبارات للقبول، وكنت قد أعددت نفسي جيدًا لهذه الاختبارات، وقبل بدء الاختبارات تذكرت أني لم أستخر الله في هذا الأمر، فوجدت مسجدًا، فصليت الاستخارة، وبعد فترة ظهرت النتيجة، ولم أكن من المقبولين، ولكنني أشعر بضيق شديد من هذا الأمر، وأشعر أني لم أنصرف عنه، فهل هذا علامة من الله على أنه ليس فيه خير لي؟ ولو كان كذلك، فلماذا لم أنصرف أنا عنه؛ رغم أنه كان هناك أمر مشابه، وصليت فيه أيضًا استخارة، ولكني لم أفكر به بعد أن انصرف عني؟ فما الحل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يعوّل عليه المستخير بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر، أو تيسّر الأمر، أم إنه يمضي في الأمر، ولا يتركه، إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه، إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى: 123457.
وإذا صدق العبد في الاستخارة، وفوّض أمره إلى الله؛ فإنّ الله تعالى يختار له الخير، وإذا صرف عنه الأمر، صرف قلبه عنه، فلم يتعلق به، ولم يَأْسَ عليه، قال ابن الملقن -رحمه الله- في التوضيح: وقوله: (واصرفه عني، واصرفني عنه) أي: لا تعلق بالي به وبطلبه. انتهى.
والظاهر -والله أعلم- أنّ تعلّق القلب بالأمر بعد أن صرفه الله عن المستخير؛ دليل على ضعف صدقه في الاستخارة، وتقصيره في تفويض الأمر إلى الله تعالى، فإنّ من صدق الاستخارة أن يفوّض المستخير الأمر إلى الله تعالى، قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره: قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطر؛ حتى لا يكون مائلًا إلى أمر من الأمور. انتهى.
وقال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار: ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا، وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بل يكون مستخيرًا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم، والقدرة، وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك، تبرأ من الحول، والقوة، ومن اختياره لنفسه. انتهى.
وعلى أية حال؛ فينبغي عليك أن ترضى بما قضاه الله لك، ولا تتحسر على ما فات، وكن موقنًا بأنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنّ الله تعالى أرحم بك من أبيك، وأمّك، ومن نفسك، وهو أعلم بما يصلحك، وأن تسأله أن يرزقك الرضا، قال ابن الملقن -رحمه الله- في التوضيح: وقوله: "ثم أرضني" ... أي: اجعلني راضيًا به، إن وجد، أو بعدمه، إن عدم. والرضى: سكون النفس إلى القدر، والقضاء.
ففيه: أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله، وصرف أزمتها، والتبرؤ من الحول والقوة، وأن لا يروم شيئًا من دقيق الأمور ولا جليلها؛ حتى يسأل الله فيه، ويسأله أن يحمله فيه على الخير، ويصرف عنه الشر؛ إذعانًا بالافتقار إليه في كل أمره، والتزامًا لذلة العبودية له، وتبركًا لاتباع سنة سيد المرسلين في الاستخارة، وربما قدر ما هو خير ويراه شرًّا، نحو قوله: {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم} [البقرة: 216]. انتهى.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

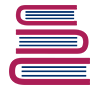
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات