السؤال
يوجد لديَّ مرض نفسي من ثلاث سنوات، وهو مرض انفصام الشخصية، ويرافقه مرض تعدد الشخصيات. مع العلم بأن أبسط الأشياء لا أقوى على تنفيذها، فيمنعني مرضي من قراءة القرآن والذكر؛ بسبب تعدد الشخصيات؛ بحيث الشخصية الأخرى لا تدع لي قراءة القرآن والذكر.
سؤالي هو: لقد دعوت الله أن يشفيني، وما زلت أدعو منذ ستة أشهر، فلم أر استجابة لدعائي، فما زلت مريضا. فما الحكمة من عدم شفائي من هذا المرض؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيها السائل الكريم ـ أولا ـ بالشفقة على نفسك، وطرد وساوس الشيطان التي يوسوس لك بها لينكد عليك حياتك، ويفسد دينك، ويزعزع ثقتك بربك.
ثم نؤكد لك أن الدعاء إذا اجتمعت فيه الشروط المطلوبة، وانتفت عنه الموانع، فإنه يستجاب لصاحبه لا محالة؛ لوعد الله سبحانه بذلك، والله لا يخلف وعده؛ كما قال: لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {الروم:6}. وقد سبق لنا بيان شروط وموانع إجابة الدعاء، وكذلك آداب الدعاء بما في ذلك أوقات الإجابة في الفتاوى التالية: 2150، 32655، 120715. فلتراجعها.
ونؤكد لك أيضا بأن من يدعو ربه بإخلاص وصدق وفق الضوابط المبينة في الفتاوى المحال عليها، لا يخيب مسعاه أبدا، فله واحدة من ثلاث، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله؛ وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. قال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله : وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا.
وبهذا تعلم أن المرء مأمور بالدعاء، وموعود بالإجابة، لكنه ليس هو من يختار الكيفية التي يستجاب له بها، فالذي يختار ذلك هو الله سبحانه، وهو الأعلم بمصلحة العبد، وبما يليق به ويناسبه، وكثيرا ما تتعلق النفس بأشياء قد لا يكون الخير فيها، فيصرفها الله برحمته، وحسن تدبيره للعبد.
وبعض الناس لقصر نظرهم لا يشعرون أن النعمة في المنع أحيانا تكون أعظم منها في العطاء، بل قد يكون هلاك الإنسان في أن يعطى، وخيره في أن يمنع، وقد قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وقال في آية أخرى: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا {الإسراء:11}.
يقول الرازي في تفسيره: أقول: يحتمل أن يكون المراد: أن الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلباً لشيء يعتقد أن خيره فيه، مع أن ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره، وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء، وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولاً مغتراً بظواهر الأمور غير متفحص عن حقائقها وأسرارها. اهـ
ويقول السعدي في تفسيره: الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور، فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك، أن يشكر الله، ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه؛ كما قال تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره، سواء سرتكم أو ساءتكم. اهـ
واعلم أن لله سبحانه حكمة بالغة في عدم شفائك إلى هذا الوقت، مع عدم علمنا وعلمك بما سيكون عليه حالك مستقبلا، بل قد يكون ما أنت فيه الآن هو أعظم العطاء لك، وأكثر الخير لك، كما بينا. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى : 358375.
وعليك بمواصلة التداوي، والعلاج النفسي والشرعي بالرقية. وفقك الله تعالى، وشفاك الله من كل سوء، ومرض، ومكروه، وجميع مرضى المسلمين.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
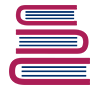
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات