السؤال
تزوجت من غير مسلمة وأحببتها كثيرا وأنا عصبي الطبع في حالات ظلم الشريك أو ضغطه علي وكنا إذا تخاصمنا بسبب غضبي لا نتكلم وأعاملها بجفاء ومرات غضبنا كانت كثيرة جدا، وهنا بدأت المشكلة أحبت زوجتي أن تعمل ووافقت لها وعملت بشركة جديدة لم يكن فيها سوى هي ومدير العمل لحين توظيف آخرين وحدثت الفاجعة وجدت خطابا منها تتحدث إلى الله فيه أنها وقعت في الزنى مع مدير الشركة وواجهتها بالأمر واعترفت لي وأن السبب معاملتي لها وقد أبدت الندم والتوبة الشديدة، وهي الآن حامل وسوف أقوم بعمل تحليل دى ان ايه للتأكد من نسب المولود لأني لا أثق فيها, هنا أسألك بالله هل ممكن أن أتسامح عن حد الزنا وهو الرجم أو الحد القانوني لا أريد أن أقسوعلى مخلوق ولا أريد الفضيحة، ولكن أولا لا أريد أن أغضب الله أبدا وهذا سبب عذابي الآن وهنا عندي أمران إن كان المولود لي سوف أتركها تعيش معي كخادمة للمولود ولن أعاملها كزوجه وسوف تدفع ثمن غلطتها حرمان وحبس وعذاب، وإذا لم يكن المولود لي فسأطلقها.
الآن أنا في نار بين اتباع الحد وبين عدم تخيلي أن أكون سببا في موت أو عذاب أحد ويطوف في خاطري أن أجد سببا للعفو عنها ولكن أتعذب كلما تذكرت غلطتها.
وسؤالي في حالة المولود هل يحق لي أن أعفو وأصفح عنها وتصبح زوجتي الطبيعية هل هذا يعتبر رأفة ترضي الله إذا أثبتت بجميع الطرق أنها أصبحت مسلمة صالحة وتوبتها من القلب لله صادقه فعلا، هل ميولي إلى العفو يغضب الله مني أم يرضيه عني، أقول هذا ولا أعرف كيف سوف أنسى فعلتها التي جعلتني أكره النظر في وجهها وتسببت في كسري?
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنك قد أخطأت بزواجك من غير مسلمة لأن ذلك وإن كان مباحا بشروطه فإنه قد تنبني عليه مفاسد كثيرة، وانظر في تفصيل ذلك الفتويين: 33896، 323، كما أنك قد أخطأت أيضا بتركك لها تعمل في عمل مختلط، بل ليس معها فيه غير المدير فالخلوة بينهما كائنة قائمة وقد قيل:
ومن رعى غنمه بأرض مسبعة * ونام عنها تولى رعيها الأسد.
وأما الحمل فإنه منسوب إليك لكونك صاحب الفراش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم، فلا يمكنك أن تتبرأ منه بالتحاليل أو غيرها إلا إذا لاعنتها وحينئذ ينسب الولد لأمه ولا ينسب إليك، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 7424.
وأما خطأها فينبغي مسامحتها فيه والستر عليها إن ظهر ندمها عليه واستقامتها بعده، وأما إقامة الحد عليها فليس ذلك لك. ولا يجوز لك قتلها ولا جلدها وإنما ذلك للإمام فحسب كما في الفتوى رقم: 7940. والستر عليها أولى من رفعها إليه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر..... رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. وقال أيضاً: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. فالستر عليها أولى، ومسامحتها خير ما دمت تطمع في إسلامها واستقامتها، والله سبحانه يحب الستر على عباده والعفو عنهم؛ كما قال: وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ {آل عمران:134} فجعل العفو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وبذا تعلم أنه يحبه ويرضاه منك ولا يغضبه عليك.
وينبغي أن تعينها على التوبة والاستقامة وتحبب إليها الإسلام بالصفح الجميل والمعاملة الحسنة لعل الله يهديها على يديك، ففي الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، وإذا أسلمت فإن ذلك يكفر جميع ذنوبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص وفي آخر الحديث قال عمرو: يا رسول الله، أنا أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها.
ويجب عليك أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته..... رواه البخاري وغيره. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 75457.
والله أعلم


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 


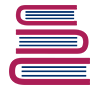
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات