
مما هو مسطورٌ في كتب التاريخ أن عضد الدولة أرسل الباقلاني في سفارة رسمية إلى ملك الروم عام 371هـ فأدخلوه وهو في عاصمة الروم على بعض القسس, فقال الباقلاني للبابا: "كيف أنت وكيف الأهل والأولاد؟" فتعجب البابا وقال له: "ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة، أنك لسان الأمة، ومتقدم على علماء الملة! أما علمت أن المطارنة والرهبان منزّهون عن الأهل والأولاد؟" فأجابه الباقلاني: "رأيناكم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل والأولاد، فهل المطارنة عندكم أقدس وأجلّ وأعلى من الله سبحانه؟".
بهذه المناظرة السريعة المُفحمة يستبين لنا مدى قُبح القول بأن الله سبحانه يجوز عليه أن يتّخذ ولداً، ويظهر بجلاء أنه اعتقاد فاسد وضلال مبين شهدت ببطلانه الفطرة السوية، والعقول المستقيمة، وتواترت الأدلّة على بطلانه وضلاله.
والأدلة على استحالة أن يتخذ الله سبحانه الولد أكثر من أن تحصى، وكان للقرآن حضورٌ كبيرٌ في إبطال هذه العقيدة الكفريّة، وقد تنوّعت أساليبه في إبطالها وبيان فسادها في عددٍ من الحُجج والبيّنات المنثورة في آياته، ولم تكن السنّة بمعزلٍ عن ذلك فقد أسهمت الأحاديث النبويّة في تأصيل التفرّد والوحدانيّة لله جلّ وعلا ونفي الصاحبة عنه والولد، وجاءت هذه النصوص متوافقة مع دلالات العقل على بطلان هذه العقيدة المنحرفة عن سواء السبيل والمائلة عن جادة الصواب.
ونبدأ بشيء من الإيجاز في بيان منهج القرآن في إبطال هذه العقيدة.
منهج القرآن في إبطال عقيدة البنوّة
جاءت الكثير من النصوص القرآنية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وقد ورد فيها ما يؤكد نفي الولد عن الله تعالى عن ذلك وتقدّس، وجاء هذا النفي في صورٍ متعدّدة وطرائق متنوّعة، ولو أردنا فرز هذه الأدلة إلى اتجاهين اثنين، فيمكن القول بأن الأدلة هي ما بين إثبات ضدّ هذه الفرية الباطلة، وهو ما يُسمّى ب: "إثبات كمال الضد"، وبين أدلّة النفي الخاصة بها، أما عن أدلّة إثبات ما يُناقضها فيمكن إجماله فيما يلي:
أولاً: إثبات الغنى لله سبحانه
إذا كان الغنى هو الكفاية والاستغناء وعدم الحاجة للغير، فاسم الله (الغني) دالٌ على عدم حاجته لغيره من خلقه، فله الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكمال ذاته وكمال صفاته، فإذا كان سبحانه وتعالى غنياً عن الخلق كلّهم، فليس له حاجةٌ أن يتخذ صاحبةً أو ولداً، لأن وجود الصاحبة والولد هي حاجةٌ من الحاجات لا يشك في ذلك عاقل، فإذا ثبت أنها حاجةٌ وأن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شيء، ثبت بطلان هذا الادعاء وهذه النسبة بالضرورة، ولذا قال الله سبحانه في الرد على هذه الفرية: { قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } (يونس: 68).
ثانياً: إثبات الوحدانية لله
الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، توحّد ربنا بجميع الكمالات، وتفرّد بكل كمال ومجد، وجلال وجمال، فليس له في ذاته ولا صفاته مثيل ولا نظير، ولا مناسب أو مشابه بوجه من الوجوه.
فإذا تقرّر ذلك، فإن وحدانيّة الخالق وتفرّده دليلٌ قاطع على انتفاء الولد عن الله تعالى، وهذا أمرٌ فطري في النفوس البشرية، إلا إذا انتكست تماماً وانطمس نورها، وإلا فإن الوحدانية الثابتة للخالق أمرٌ لا يحتمل الشك، لظهور الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة على ذلك.
ثالثاً: إثبات الصمديّة لله تعالى
من أسماء الله سبحانه: الصمد، ومعنى هذا الاسم أنه الذي تقصده المخلوقات وتصمد إليه في كل الحاجات، فهو السيد الذي قد كُمل في سؤدده، والغني الذي قد كَمُل في غناه، كما قال ابن الأنباريِّ: "لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم".
فمن كان متّصفاً بالصمديّة –وفق المعاني السابقة- فهو منزّهٌ عن الصاحبة والولد، لأن اتخاذ الولد يتصادم مع السؤدد الكامل النافي لجميع الحاجات والافتقار إلى الغير؛ فثبت بطلان عقيدة اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في مسألة البنوّة المفتراة.
النفي العام الوارد في هذه القضيّة
وردت الكثير من الآيات التي تنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، وتنوّعت هذه الآيات في تقديم الحجج والبراهين المتعلّقة بالمسألة، وأوّل مسلكٍ نلحظه فيها: إبطال هذه العقيدة الفاسدة استدلالاً بصفتين من صفات الربوبيّة، وهما: صفة الخلق، وصفة الملك، فخلق الله تعالى للخلائق، وملكه للكون كلّه، ينفي الحاجة للولد.
وقد تتعلّقت صفتي الخلق والملك في الآيات الكريمة بالسماوات والأرض، فإن إبداعهما من غير مثالٍ سابقٍ أعظم من إبداع كائنٍ بشري، والله سبحانه يقول في كتابه: {لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون} (غافر: 57)، فالذي أبدع السماوات والأرض، على جلالتهما، وعظم شأنهما، وكبر أجسامهما، وسعتهما، وعجيب خلقهما، ولم يعيَ بخلقهنّ أقدر على أن يوجد البشر ويخلقهم، وكذلك فإن إثبات أن الكون كلّه علويّه وسفليّه مخلوق مملوك لله تعالى يعني انتفاء استحقاق مخلوقٍ أن يكون ولداً لله، لأن من ذكروه ولداً لله من المسيح وعزير وغيرهما هو داخلٌ في جملة السماوات والأرض فيسري عليه حكم الخلق والملك، والمملوك لا يكون ولداً للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق ولداً للخالق!
وهذه الآيات هي قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون* بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون} (البقرة:116- 117)، وقوله تعالى: {إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا} (النساء: 171)، وقوله تعالى: {قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض} (يونس: 68).
ولننظر إلى أقوال أهل العلم في هذه الآيات، ويأتي في مقدّمتهم شيخ المفسرين الإمام الطبري إذ يقول: "لله ما في السموات والأرض من الأشياء كلها ملكا وخلقا وهو يرزقهم ويقوتهم ويدبرهم فكيف يكون المسيح ابن الله وهو في الأرض أو في السموات غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن، وقوله: {وكفى بالله وكيلا} يقول: وحسب ما في السموات وما في الأرض بالله قيما ومدبرا ورازقا من الحاجة معه إلى غيره".
وذكر ابن الشيخ أن لطائف هذه الآيات أننا نجد أن الحق سبحانه وفي كل موضع نزّه نفسه عن الولد، ذكر أن جميع ما في السموات والأرض مختصٌّ به خلقاً وملكاً؛ وذلك للإشارة إلى أن ما زعمه المبطلون أنه ابن الله، وما نسبوه من وجود صاحبة له –والعياذ بالله- فكلّه مملوك مخلوق له لكونه من جملة ما في السموات وما في الأرض، فلا تُتصوّر المجانسة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، والمالك والمملوك، فكيف يعقل مع هذا توهّم إمكان أن يكون له من جنس هذه المخلوقات؟ وقوله سبحانه: { وكفى بالله وكيلا} أن إليه يَكِلُ كل الخلق أمورهم، وهو غني عن العالمين فأنّى يُتصوّر في حقّه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم أو يعينهم؟
إثبات العبوديّة لمن ادّعوا بنوّته
وهذا يترتّب على ما سبق، فإذا كانت السماوات والأرض ومن فيهنّ مملوكةٌ لله مخلوقةٌ له، فذلك يعني أن الجميع عبدٌ لله تعالى عبودية القهر والملك؛ لأن الله ربهم ومليكهم فلا يخرجون عن ملكه أو ومشيئته وقدرته.
وعليه: نفهم سرّ إيراد هذه العبوديّة العامّة في سياقات نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} (مريم:92 – 95)، وقوله سبحانه: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون, لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون} (الأنبياء: 26-27)، وقوله سبحانه: {لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون} (النساء: 172)، وقول الحق تبارك وتعالى عن نبي الله عيسى: {إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل} (الزخرف: 59)، وقول عيسى عليه السلام عن نفسه مؤكّداً هذه الحقيقة، في أوّل كلمةٍ نطقها وهو لا يزال رضيعاً: {قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا} (مريم: 30).
والله سبحانه وتعالى أراد أن يُثبت أن عيسى عليه السلام والملائكة المقربون –وهم أبرز من نُسبوا لله تعالى زوراً وبهتاناً- قد رغبوا في عبادة ربهم، وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فجاء التعبير عن عبوديّتهم لله ودفع هذا الغلو فيهم بذكر أنهم لا يستنكفون عن عبادة ربهم، والاستنكاف هو الاستكبار والامتناع عن فعل شيء رغبة عنه، وتتّضح قوّة هذا النفي بالتعبير القرآني: {أن يكون عبداً لله} ولم يقل: (لن يستنكف عن عبادة الله) وذلك لإفادة كمالُ نزاهتِه عليه السلام عن الامتناع الدائم المطلق عن الاستكبار عن عبادة الله، وإثبات كونه عبداً له تعالى على وجه الدوام، كما ذكر ذلك الإمام أبو السعود.
تكذيب القائلين بهذا القول وإنذارهم
وردت آياتٌ تهزّ الجبال توضح فداحة القول بإمكان أن يتخذ الله ولداً، وتُشدّد النكير على من يعتقد هذه العقيدة الباطلة، وانظر إلى سياق هذه الآيات: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا* لقد جئتم شيئا إداً* تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدا* أن دعوا للرحمن ولدا* وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا* إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا* لقد أحصاهم وعدّهم عدا* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} (مريم: 88-95).
لقد بيّن الله عز وجل مقالتهم الفظيعة؛ وحكايتهم الشنيعة؛ وأن قولهم من أقبح القَوْل وأفسده حتى وصفه الباري بقوله: {لقد جئتم شيئا إدا} يعني: عظيما ؛ ولذا حُقَّ للسماوات والأرض وسائر المخلوقات أن تبغضهم وتبغض كفرهم وإلحادهم، وأن تحنق عليهم وأن تتميّز غيظاً منهم، وما ذاك إلا لتضمّن تلك المقالة شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته وغناه إليه؛ فلذلك جاء تصوير الآيات على نحوٍ اشتركت فيها الخلائق في السماوات والأرض، شعوراً منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء، أي: تتشقّق وتسقط قطعاً صغيرة، وتنشقّ الأرض: أي تتمزق، وتخرّ الجبال: أي تصبح كثيباً مهيلاً وتستحيلُ تراباً،وكلّه من هول ما قيل ومن كذب ما افتُري وانتُقص من عظمة الله وعزّته ومكانته.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في معرض هذه الآيات، قال: "إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله تعالى"وأيّ شركٍ أعظم من نسبة الولد لله تعالى؟.
وأما تكذيب هذه المقالة فقد ورد في أكثر من موضع في القرآن، منه قوله تعالى: {ألا إنهم من إفكهم ليقولون* ولد الله وإنهم لكاذبون} (الصافات: 151-152)، والإفك كما هو معلومٌ في اللغة: الكذب والبهتان.
ولنتأمّل سياق هذه الآيات البينات: {قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون* قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون} (يونس:68-70) فبعد أن بيّن الحق سبحانه أن القائلين بهذا القول ليس لديهم فيه أية حجة أو برهان على صحّة دعواهم، كان الوعيد في حقّهم ألا يظفرون ببغية ولا يبقون في نعمة، ولا ينالون مطلوبهم، ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم، في الدنيا، متاعاً قليلاً زائلاً، ثم مرجعهم إلى الله تعالى فيسومهم سوء العذاب بما كانوا يفترون، جزاءُ وفاقاً على ظلمهم لأنفسهم وقولهم ما لا ينبغي: {وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون} (آل عمران:117).
وفي مطلع سورة الكهف تكذيبٌ صريح لهذه الفرية خالطه الإنذار الوعيد، وهي قوله تعالى: {وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا* ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا} (الكهف:4-5)، ولا يخفى ما في هذه الآيات من استبشاعٍ لمقالتهم واستعظامٍ لإفكهم، إذ ليس لها مستندٌ سوى قولهم ودعواهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم.
وقد أكّد القرآن أن هذا القول هو من أعظم الكفر، وذلك في قوله سبحانه: {وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين} فقولهم هذا كفرانٌ للنعمة، فإن ما سوى الخالق فهو مفتقر بالعبودية مقهور بها، فكيف يصلح أن يكون إلها مرغوبا مرهوبا مدعواً؟.
الحمد والثناء على الذات الإلهيّة بنفي الولد.
إذا كان الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود وصفاته الحسنى التي يستحقّ بموجبها الثناء والمدح، فإن ثناء الرّب جلّ وعلا هو أعظم الحمد وأعلاه، لأنّه الإعلام من الذات الإلهيّة بمواطن الحمد ومواضعه وشواهده.
والأمور التي يستحق الرّب تبارك وتعالى الحمد عليها كثيرةٌ جداً، كان منها: ثناء الله جلّ وعلا على نفسه بعدم اتخاذ الولد، وذلك في قوله سبحانه: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا} (الإسراء: 111)، وهذه الآيات ردٌّ على ضلالات أهل الكفر جميعاً، فقد روى ابن جرير عن القرظي قوله: "إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولدا، وقال العرب: لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذلّ، فأنزل الله هذه الآية".
وفي معنى ذلك، إخبار الله جلّ وعلا عن نفسه بـ"تبارك"، قال تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا* الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا } (الفرقان:1-2)، فقوله {تبارك} على وزن: تفاعل، مأخوذٌ من البركة، ومعناه جاء بكل بركة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الضحّاك: تعظّمَ، وعلى هذه المعاني نستشفّ قصد الحمد والثناء والتعظيم على الذات المقدّسة، فيكون داخلاً في مسمّى الحمد.
نفي اتخاذ الولد
وقد نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد في قوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون} فقوله: {سبحان الله عما يصفون} تنزيهٌ لله عن كلا الوصفين: اتخاذ الولد، ووجود الشريك.
ومن اهتدى من الجن وآمن برسالة محمد –صلى الله عليه وسلم- آمن بهذه الحقيقة، ونفى عن الخالق هذه النقيصة، فقالوا كما ورد في سورة الجن: {وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا} (الجن:3).
نفي الصاحبة نفي للولد:
وهذه من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه، يلزم من نسبة الولد إليه نسبة الصاحبة إليه -أيضا-، وهو محال، فما يلزم عن الباطل فهو باطل، ونجد هذه الحجّة البيّنة في قوله تعالى ردّاً على المشركين: {بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيءٍ وهو على بكل شيءٍ عليم } (الأنعام:101).
وقد كان سلطان هذه الحجّة وبرهانها على الحق سبباً في إسلام طلحة صحابي رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن أن قريشا قالت: قيّضوا لكل رجلٍ رجلاً من أصحاب محمدٍ يأخذْه. فقيضوا لأبي بكر رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى! قال أبو بكر رضي الله عنه: وما اللات؟ قال: ربنا! قال: وما العزى؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمّهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم، فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان في نفي وجود الصاحبة عن الخالق إبطالٌ لقولهم في المخلوقات التي يجعلونها أبناءً وذريّةً له.
فأنا أول العابدين
جاء القول من باب الممانعة العقلية والجواب الجدلي: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} والمعنى كما يقول الشيخ السعدي: " {فأنا أول العابدين} لذلك الولد، لأنه جزء من والده، وأنا أول الخلق انقياداً للأمور المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك، وأشدهم له نفياً" وهذا أسلوبٌ معروف عند العرب يُقصد به المبالغة في النفي.
النفي الخاص عن نسبة الملائكة والجن لله جل وعلا
وذلك مذكورٌ في قوله سبحانه: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون * وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون * أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون} (الزخرف:19 – 21). فقد طالب الله عز وجل بالدليل والبرهان أولئك الذين جعلوا الملائكة إناثا.
وقال سبحانه: {أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما} (الإسراء:40).
وأما نسبة الجنّ إليه ففي قوله تعالى: {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون} (الصافات:158)، فالجن تعلم في قرارة نفسها أنهم محضرون للحساب، فكيف ينسبهم الجهّال من الخلق إلى الخالق، ولو كان بينه وبينهم نسب لم يحضرهم الحساب، ونظير ذلك قوله تعالى: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم} (المائدة: 18).
القسمة الجائرة في نسبة الأولاد والبنات للخالق جلّ وعلا
تجاوز الظالمون مسألة نسبة المخلوقات لله جلّ وعلا إلى ما هو أقبح وأعظم، فجعلوا البنات لله تعالى ولهم البنون، والظلم في هذا القول حاصلٌ من جهتين: جعلهم الولد لله تعالى، جعلهم أردأ القسمين عندهم لله تعالى، مع أنهم لا يرضونهن لأنفسهم نسبة البنات لضعفهنّ ورقّتهنّ، قال تعالى: {فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون * أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون * ألا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطفى البنات على البنين * ما لكم كيف تحكمون * أفلا تذكرون * أم لكم سلطان مبين * فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين * وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون * سبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله المخلصين} (الصافات:149-160).
وبذلك يتبين لنا كيف استطاع القرآن الكريم إبطال هذا الإفك المبين من خلال الأدلّة الشرعيّة، واتضحت مخالفة هذه المقولة لمقتضيات الكمال والجلال الإلهي، فما أحلم الله على عباده.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج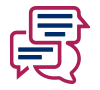 استشارات الحج
استشارات الحج

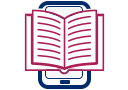












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات