
لعبت الكنيسة دوراً مميزاً في أوروبا في العصور الوسطى، كما لعبت مبادئ المسيحية دوراً فاعلاً في التأثير في المجتمع الأوروبي، وأبرز المبادئ التي دعت إليها الكنيسة، ووجهت الشعوب الأوروبية إليها هي ثنائية المقدس والمدنس.
فاعتبرت الكنيسة أن الشهوات والجسد والدنيا أمور مدنسة يجب الترفع والابتعاد عنها، واعتبرت كل ما يتصل بالله والروح والآخرة مقدساً يجب التوجه إليه والحرص عليه والقيام به، واعتبرت الرهبنة هي الجسر الذي يجب أن يسير عليه المسيحي لينتقل من المدنس إلى المقدس، واعتبرت تعذيب الجسد وقتل الشهوات ونبذ الدنيا هو الطريق الذي يجب أن يمشي عليه المسيحي من أجل أن يحرر جسده، لذلك ازدهرت الأديرة التي ترعى الرهبان الذين يتركون عالم الدنيا، وازدهرت الممارسات التي تعذب الجسد من أجل الخلاص الروحي: كحمل الأثقال والجوع واعتزال الناس...إلخ.
ليس من شك بأن المبادئ التي قامت عليها الكنيسة معادية للفطرة؛ لأن الله لم يخلق تلك الشهوات عبثاً، لذلك شهدت أوروبا أزمة حضارية، ومما زاد في استفحال تلك الأزمة تدخل رجال الكنيسة في شؤون العلم والعلماء، والقول بأقوال مجانبة للحقائق العلمية، واضطهاد العلماء الذين قالوا بالصواب وتعذيبهم وقتلهم في بعض الأحيان.
لذلك انفجرت جماهير أوروبا وعبرت عن غضبها على الكنيسة ومبادئها ورجالها في الثورة الفرنسية عام 1789، لكن تلك الثورة لم تحل الأزمة الحضارية التي كانت تعيشها أوروبا، بل انتقلت أوروبا من وضع خاطئ إلى وضع خاطئ، وانتقلت من أزمة إلى أخرى، والسبب في ذلك أن أوروبا لم تعد حقائق الجسد والشهوات والدنيا والمرأة، إلى دائرتها الصحيحة، فتصبح حاجات أساسية وطبيعية يجب إعطاؤها حقها من الإشباع والإرواء لأن هذا هو الهدف من خلقها، بل غالت في ذلك نتيجة الأزمة السابقة وقدستها وحولتها إلى مصاف التأليه.
وكذلك لم تعد حقائق الدين والعبادة والإيمان بالله والآخرة إلى دائرتها الصحيحة، وإلى الاعتراف بفطرية وجودها في كيان الإنسان، بل أصبحت -نتيجة الأزمة السابقة- في دائرة الاتهام، وأصبحت توصف تلك الحقائق بأنها خرافة وأوهام، وأن علينا إنكارها وأن علينا الإيمان بكل ما هو محسوس فقط.
انتقلت أوروبا من أزمة كانت تعيشها وهي ثنائية المقدس والمدنس إلى أزمة أخرى بدأت تعيشها وهي: تدنيس المقدس، وتقديس المدنس، وسأوضح ذلك في المنظومتين الأيديولوجيتين اللتين سادتا في القرن العشرين وهما: الشيوعية والرأسمالية، وفي أكبر كتلتين سياسيتين هما: الإتحاد السوفيتي والعالم الحر.
لقد جسد الاتحاد السوفيتي الشق الأول من ثنائية الأزمة، وهو: تدنيس المقدس خير تجسيد، فأصبح الإلحاد هو الأصل الذي يقوم عليه، وأصبح يعلن أن الدين خرافة وأوهام، وأنه أفيون الشعوب، وأنه ليس هناك عالم غيب، وأن الملائكة والشياطين والجنة والنار أوهام من اختراع الأغنياء لاستغلال الفقراء... إلخ.
ومن الجدير بالذكر أن المجتمعات البشرية لم تعرف مجتمعاً قام على الإلحاد، صحيح أنها عرفت بعض الملحدين، لكنها لم تعرف مجتمعاً خالياً من الإقرار بوجود إله، بغض النظر عمن هو الإله، فقد يكون كوكباً أو شجرة أو شخصاً أو جبلاً... إلخ، ولم تعرف مجتمعاً خالياً من دور العبادة، وربما كان المجتمع الأول الذي قام على الإلحاد في التاريخ هو المجتمع الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، هذا في مجال تدنيس المقدس.
أما في مجال تقديس المدنس وهي الدنيا والمرأة والشهوات، فإن أيديولوجيا الاتحاد السوفيتي وهي الشيوعية فقد كانت تقوم على أن المادة هي الأصل في الحياة، وعلى أن تطور وسائل الإنتاج هو الذي يصنع القيم والأخلاق والمثل... إلخ، واعتبرت الاشتراكية على لسان إنجلز ستر العورة طريقة صريحة لامتلاك النساء، واعتبرت كذلك أن ولادة الحجاب جاءت مترافقة مع ولادة الملكية الفردية، لذلك سينتهي الحجاب عند انتهاء الملكية الفردية، وستعود العلاقات الجنسية مشاعة كما كانت في المجتمع القديم: كل النساء لكل الرجال.
فماذا كانت نتيجة هذه الأزمة التي عاشها الاتحاد السوفيتي؟ كانت الانفجار الذي أدى إلى سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه عام 1990 وإلغاء الشيوعية بسبب معاداة الفطرة التي كان يقوم عليها الوجود الشيوعي، لأنه في حال أي تصادم مع الفطرة، فلابد من أن تنتصر الفطرة في النهاية، ويؤكد ذلك أنه بعد عدة سنوات قليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي أعلن 30% من الشباب الروسي تحت سن الخامسة والعشرين أنهم تحولوا من الإلحاد إلى الإيمان، وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي زاد عدد الكنائس العاملة في منطقة موسكو خمسة أضعاف، أما في آسيا الوسطى ففي غضون خمس سنوات فقط من حقبة التسعينيات زاد عدد المساجد فيها من 160 مسجداً إلى عشرة آلاف مسجد.
أما المعسكر الرأسمالي فإنه مثال أوضح على الشق الثاني من ثنائية أزمة الحضارة الغربية وهو (تقديس المدنس) بمعنى أن الشهوات والمرأة والجسد واللذة والمنفعة والاستهلاك... إلخ، هي العناوين الرئيسة التي أصبحت في مصاف التقديس والإلوهية، والتي أصبحت تحكم المجتمع الرأسمالي، ومما يؤكد ذلك حجم الإنفاق على الجنس في الإنترنت، والصورة التي تستغل بها المرأة في الدعاية والإعلان، وحجم العري الذي يسود المجتمع، والتشريع للشذوذ الجنسي بشقيه: اللواط والسحاق، وقبوله حتى في الكنائس.
ومن الجدير بالذكر أن الاستغراق في الشهوات وتأليه اللذة، وتعظيم المنفعة يزداد استفحالاً مع مرور الزمن ويعمق الأزمة التي يعيشها المجتمع الرأسمالي، وقد رصد ذلك التطور الدكتور عبد الوهاب المسيري فبين أن الحضارة الغربية أفرزت العلمانية الجزئية بعد ممارسات الكنيسة الخاطئة في العصور الوسطى، وقد كانت تعني العلمانية الجزئية فصل الدين عن الدولة، لكن حدثت تحولات تاريخية حوّلت العلمانية الجزئية إلى علمانية شاملة أودت بالإنسان كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة.
وبدأت هذه العملية بانفصال المجال الاقتصادي عن القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، وأصبح يحكم على عالم الاقتصاد بمقدار ما يحققه من الأهداف الاقتصادية بغض النظر عن أية قيمة دينية وأخلاقية وإنسانية، ثم شملت عملية الانفصال بقية المجالات الحياتية: السياسة والعلم والجسد... إلخ، فيحكم على نجاح العلم أو فشله بمقدار ما يحقق من أهداف علمية محضة مثل مراكمة المعلومات وإجراء التجارب الناجحة، بعيداً عن أية قيم أخلاقية وإنسانية ودينية، ويتحرر الجنس من سائر المعايير والقيم ليستمد معياريته من ذاته، ويحكم على مقدار نجاحه أو فشله بمقدار ما يحققه من أهداف جنسية محضة مثل اللذة، خارج أي نطاق اجتماعي أو أخلاقي.
إذن انتهت العلمانية الشاملة لا لتفصل الدين عن الدولة فقط، وإنما لتفصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية جميعها عن الدولة وعن جوانب الحياة العامة والخاصة كافة، أي أنها تفصل سائر القيم عن الطبيعة والإنسان وتنـزع عنهما أية قداسة، فكلاهما مكتف بذاته، ومرجعية لذاته.
وقد تبلورت العلمانية الشاملة في الفلسفة الداروينية الاجتماعية التي تذهب إلى أنّ العالم مادة واحدة صدر عنها كل شيء، وهذه المادة خالية من الغرض والهدف والغاية ولا توجد داخلها مطلقات متجاوزة من أي نوع، ويرد كل شيء إلى المادة، ويفسر كل شيء بالتطور المادي.
وليس الإنسان إلا جزءاً من هذه الطبيعة والمادة وقد صدر عنهما من خلال عملية التطور، ويحكم القانون الطبيعي الإنسان والأشياء، ومن ثم فإنّ الأخلاق الدينية التي تدعو إلى حماية الأضعف تقف ضد التقدم العقلاني المادي، وهذا يعني أنّ كل الأمور نسبية ولا توجد مطلقات، لذلك فإنّ النظرية الداروينية تعتبر الأساس العلمي للفكر النسبي.
ومن البديهي القول إنّ الداروينية تفترض عدم وجود مخطط إلهي وراء الكون إلا أنها تفترض وجود غاية طبيعية هو التطور وأنّ البقاء هي القيمة الوحيدة التي تعترف بها، والصراع هو الآلية التي تقر بها، لذلك فالعالم هو ساحة قتال من الذئاب البشرية، ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيء، إذ إنّ ما يحدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء.
إن الكلام السابق بين عمق الأزمة التي يعيشها المعسكر الرأسمالي، والتي تحتم انتصار الفطرة في النهاية كما انتصرت في المعسكر الشيوعي، ومما يؤكد ذلك تحذير بعض قيادات ومفكري الحضارة الغربية الناس من الهاوية التي ينحدرون فيها وأبرز أولئك جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية والذي أصدر كتاباً في عام 2005، يحمل عنوان: "قيمنا المهددة: أزمة أميركا الأخلاقية" ويؤكد ذلك بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأسبق في أميركا والذي أصدر عدة كتب في هذا الاتجاه، ولكن العامل الإيجابي الذي يعطي المعسكر الرأسمالي القوة والاستمرارية، هو: التجريب الذي ولد هذه التقنيات المتعددة من قطار وسيارة وطائرة وذرة وصاروخ وكمبيوتر... إلخ، وقد انعكست هذه التقنيات بالإيجابية على مختلف مجالات الحياة: من طب وزراعة وصناعة وفضاء وفلك... إلخ. وأصل التجريب مأخوذ من حضارتنا إذ نقله فرنسيس بيكون من الأندلس.
الخلاصة: انتقلت الحضارة الغربية من أزمة إلى أخرى، فبعد أن كانت أوروبا تعيش أزمة ثنائية المقدس والمدنس في العصور الوسطى، أصبح الغرب يعيش أزمة حضارية في العصور الحديثة تقوم على تقديس المدنس وتدنيس المقدس، لذلك نقول لدعاة الحضارة الغربية ومروجيها عندنا، والذين يريدون منا أن نأخذ الحضارة بكل ما فيها من حلو ومر، وصواب وخطأ، نقول لهم: رفقاً بنا فإنها حضارة مأزومة، وعلينا أن نعي ذلك أولاً، ونأخذ ما هو بعيد عن أزمتها من جهة، ويجب أن يكون لنا دور في حل هذه الأزمة بما نملك من معطيات حضارية إلهية من جهة ثانية.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج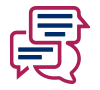 استشارات الحج
استشارات الحج

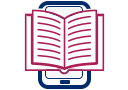












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات