
لا بد للمتصدي لفهم السنة النبوية وإفهامها للناس أن يستبصر بالمقاصد الشرعية في فهم النص النبوي، وحسن تنزيله وتطبيقه، وأن لا يتجنى على ظواهرها، فإن ظاهر النص مقصود أيضا، ولكن لا بد أن يكون التمسك بالظواهر متوافقا مع المقاصد والمعاني التي يرمي إليها الشارع؛ ومحاولة المنافرة بين الظواهر والمقاصد يعود على فهم النصوص بالاختلال، بل وعلى الشريعة بالإزراء، وقد كان الجمع بين النصوص ومقاصدها حاضرا فيما سطره علماؤنا في كتب الشروح، على تفاوت بينهم في تمثل ذلك.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل ايتني بها، وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم من وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع ويلزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير موضع".
وهذه بعض الأحاديث مع بيان معانيها في إطار مقاصد الشرع، حتى يتضح أثر المقاصد في توجيه معنى النص النبوي:
الأول: في صحيح البخاري: عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: «وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ».
وقد كان هذا الحكم مناسبا للحال، حتى كان عهد عثمان، فتغير الحكم تبعا لمقصده، كما في الموطأ عن مالك؛ أنه سمع ابن شهاب يقول: "كانت ضوالُّ الإبل في زمن عمر بن الخطاب إِبِلاً مُؤَبَّلَةً (المجعولة للقنية)، تنَاتجُ لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان، أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها، أعطي ثمنها".
وإنما فعل عثمان ذلك مع أن النهي صريح عن التقاطها لتحقيق مقصد الحديث النبوي، فإن عدم الالتقاط كان يحقق حفظها؛ لأن المخاطب في العهد السابق لعثمان كان يعف عن أخذها، فلما كان في عهد عثمان، واختلط المجتمع بمن لا يعف عن مثل ذلك، كان أخذها وتعريفها هو الإجراء الذي يتحقق به مقصود الشرع من حفظ الأموال من الضياع.
قال السرخسي في المبسوط: وتأويله _أي النهي عن التقاط ضالة الإبل_ عندنا أنه كان في الابتداء، فإن الغلبة في ذلك الوقت كان لأهل الصلاح والخير، لا تصل إليها يد خائنة إذا تركها واجدها، فأما في زماننا لا يأمن واجدها وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها، فهو أولى من تضييعها. أ.هـ.
الثاني: حديث عبد الله ابن عمرو: "لا ضمان على مؤتمن". رواه الدار قطني والبيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
فهذا الحديث يدل على أن من كانت يدُه يدَ أمان فلا ضمان عليه، كالمودَع، والمرتهِن، والصانع، إلى أن تغيرت أحوال الناس، قضى علي رضي الله عنه بتضمين الصناع، ووافقه الآخرون على ذلك، رعاية لقصد الشارع بحفظ أموال الخلق، لا مخالفةً لنصه، قال الشاطبي في الموافقات: واتفاق السلف على تضمين الصناع، مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله وما لا، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة. انتهى.
الثالث: عن ابن عمر _رضي الله عنهما_ أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم". وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صبيا»، فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر، وابن الزبير، وعلي وسويد بن مقرن من لطمة وأقاد عمر، من ضربة بالدرة وأقاد علي، من ثلاثة أسواط واقتص شريح، من سوط وخموش. رواه البخاري.
وقد قضى عمر رضي الله عنه بهذا الحكم، ولا مخالف له؛ تأكيدا على مقصد حفظ النفس، إذ لو لم يقم عليهم القصاص لأدى ذلك إلى ضياع نفوس كثيرة، فيجعل الناس من ذلك ذريعة إلى فشو القتل لعلمهم بعدم إقامة الحد عليهم في حال الاشتراك، فكان فقه المقاصد، وورعاية المآلات حاضرا في قضاء عمر رضي الله عنه.
الرابع: امتناع عمر عن تقسيم أرض السواد على الفاتحين، عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول: "لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخَرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَّمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ سُهْمَانًا، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُ". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
فهذا اجتهاد من عمر مع وجود نص في المسألة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حين قسم أرضها غنيمة بين المقاتلين، ولم يخالف عمر هذا النص، إنما عمل بمقصوده، وهو العدالة في توزيع الثروة بين الحاضرين والأجيال القادمة، على خلاف بين الفقهاء في تفسير فعل عمر رضي الله عنه.
قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم)، فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين، فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين.
الخامس: حديث: الالتفات في الأذان عند بلوغ الحيعلتين، وهو ثابت في الصحيحين، وقد جرى عليه العمل عند المتقدمين، وأما عند المعاصرين فقد حدث خلاف هل يلتفت المؤذن أم يبقى متوجها نحو لاقطة الصوت، يقول ابن عثيمين: «أمَّا الآنَ فلا حاجةَ للالتفاتِ؛ لأنكَ إذا التفَتَّ الآنَ فـرُبَّما يكونُ في الالتفاتِ ضررٌ؛ لأنَّ اللاقطةَ لا تكونُ أمامَكَ فيضعفُ الصوتُ، فالذي أرى في مسألةِ مكبرِ الصوتِ الآنَ أنهُ لا يُلتفتُ يمينًا ولا شمالًا، لا في "حيَّ على الصلاةِ" ولا في "حيَّ على الفلاحِ" ويكونُ الالتفاتُ الآنَ بالنسبةِ للسماعاتِ، فينبغي أنهُ يُجعلُ مثلًا في المنارةِ سماعةٌ على اليمينِ وسماعةٌ على الشمالِ».
وهذا فهم للحديث بمقتضى مقصده، فإن القصد من الأذان هو الإعلام، كما قال النووي: «ليعمَّ الناسَ بإسماعِهِ، وخُصَّ بذلكَ؛ لأنهُ دعاءٌ» وهذا المقصد متحقق بدون الالتفات، بل إن الالتفات يعود على هذا المقصد بالنقص، فاقتضى الفهم المقاصدي للحديث القول بعدم مشروعية الالتفات طالما تحقق المقصد منه.
السادس: حديث أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»، رواه مسلم.
لا إشكال في الجزء الأول من الحديث من مدح صفوف الرجال الأولى، وذم الصفوف المتأخرة، ولكن الإشكال في الجزء الثاني منه، وبالنظر إلى ظاهر الحديث نفهم منه ذم صفوف النساء الأولى مطلقا، ومدح صفوفهن المتأخرة مطلقا.
وقد نظر النووي وغيره إلى ظاهر هذا الحديث فوجده مشكلاً، إذ كيف يتصور ذم الصفوف الأولى للنساء مطلقا، وما المصلحة في ذلك، ثم وجه هذا الظاهر توجيها مقاصديا، مبنيا على سبب ورود الحديث وحكمته المتضمنة، فقال: "أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا أما صفوف النساء فالمراد بالحديث أما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم". أ.ه من شرح النووي على صحيح مسلم.
ومثله القاضي عياض الذي رأى تقييد الإطلاق المستفاد من ظاهر الحديث بالمقصد المستنبط منه، فقال: "وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال، وأوَّلْنا خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء". انتهى. من كتاب المعلم بفوائد مسلم.
هذه بعض الأمثلة التي يتضح بها المقصود، من تأثير المقاصد في فهم النص النبوي، وما يقتضيه من توجيه المعنى إلى الاحتمال الذي يتوافق مع الأصول الشرعية والمقاصد المرعية، وهذا دأب العلماء، وطريقة المحققين، ولذلك نجد الشراح قد يصرفون ظواهر بعض الأحاديث، ويؤولونها بما لا يتعارض مع النصوص العامة، والكليات المعهودة في الشريعة، ولكن ليس هذا إلا للراسخين في العلم، فنفوسهم ريانة بالشريعة أصولا وفروعا، مما يمكنهم من القيام بهذه المهمة الخطيرة.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج تسجيلات الحج
تسجيلات الحج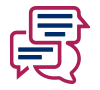 استشارات الحج
استشارات الحج

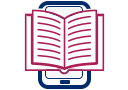












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات