
في مقالات سابقة عن الغضب ذكرنا فيها المعالجات النبوية لغريزة الغضب، والحد من آثارها، وهنا نقف على مواقف من الغضب النبوي، حتى يتبين لنا مقاصده ودوافعه، فقد أثبتت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه الغضب، ولكنه لا يجاوز الحق في غضبه، ومن خلال جمع المواقف التي غضب فيها عليه الصلاة والسلام تتضح تلك المقاصد بصورة أكمل.
أولا: الغضب لحماية الدين والتوحيد على وجه الخصوص:
المواقف النبوية لحماية التوحيد والعقيدة، والتحذير من الشرك وذرائعه الموصلة إليه كثيرة جدا، ولكن من الروايات التي صرحت بحصول الغضب النبوي لأجل ذلك:
ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور». والقرام: الستر الرقيق.
وقد بوب البخاري على هذا الحديث "باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله"، ومن المعلوم أن الصور والتماثيل كانت بوابة الشرك بالله في البشرية منذ عهد نوح عليه السلام، ولذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تلون وجهه؛ حماية لجناب التوحيد.
ومن غضبه لحماية الدين: الغضب لبعض مشاهد التنفير من الدين، بالإطالة على المصلين من بعض أئمة الصلاة، لكون ذلك ينفرهم، ويؤدي إلى كراهية الشعائر، ففي الصحيحين عن أبي مسعود، قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة».
ومن ذلك: غضبه لبعض مظاهر الغلو المتمثلة في الرغبة عن الرخص الشرعية، لما يؤول إليه الأمر من الرغبة عما جاء عن الله ورسوله، ففي صحيح مسلم عن عائشة، قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: «ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية».
ومثله: ما في الصحيحين عن زيد بن ثابت، قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة، أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». فغضب عليهم لكمال رحمته بهم من أن يلحقهم المشقة والعنت بافتراض قيام عليهم، وبهذا يظهر أن من مقاصد غضبه زجرهم عن بعض مظاهر الغلو مخافة أن يشدد عليهم، فيعجزوا عن القيام بما وجب عليهم.
ثانيا: الغضب لحماية الإيمان بالرسل:
ومن ذلك: الغضب من الطعن في عدله: ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فغضب من ذلك غضبا شديدا، واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له، قال: ثم قال: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر».
ولا شك أن غضبه هنا لا لأجل شخصه وحظه، وإنما لحق الله تعالى، فهو يعلم أن الطعن في عدالته طعن في الإيمان به، وهذه هلكة للقائل والعياذ بالله.
ومن تلك المواقف: ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «أسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك» ، فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ، فقال الزبير: " والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] ".
ومن ذلك: الغضب من التفضيل بين الأنبياء المؤدي إلى انتقاص جناب بعضهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه - شك عبد العزيز - قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال: فلان لطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم لطمت وجهه؟» قال: قال - يا رسول الله - والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أو بعث قبلي، ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام».
ثالثا: الغضب لأجل حماية مصادر التلقي لدى المسلمين:
لمان أهل الكتاب أهل دين سماوي فقد بقيت لديهم بعض الروايات التي تستهوي المسلمين للاطلاع على بعض الحوادث المفصلة، فكانوا يسألونهم، ويستمعون لبعض قصصهم، وربما أخذا بعض صحائفهم يقرأونها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط الحق بالباطل، وبين يدي المسلمين القرآن والنبوة، فزجرهم عن مظاهر التبعية الفكرية لأهل الكتاب، وعزز نقاء مصادر المعرفة لديهم، وربما اشتد غضبه لأجل ذلك.
ويدل لهذا ما رواه الإمام أحمد في المسند عن جابر: أن عمر بن الخطاب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب وقال: «أَمُتَهَوِّكُونَ فيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني». وقوله: "أمتهوكون" أي: متحيرون في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من غير كتابكم ونبيكم.
رابعا: الغضب لحماية أصل الأخوة الإسلامية:
يعد الاجتماع والائتلاف من أهم الأصول الإسلامية بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا قيام للملة إلا بالجماعة والاجتماع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حين يسمع أو يرى ما يخل بهذا الأصل العظيم.
ومن ذلك: غضبه صلى الله عليه وسلم لاختلافهم على الولاة؛ لما يورثه ذلك من ضعف مكانتهم، وعدم استقامة أحوال الرعية، واجتماعهم على عليهم، ففي غزوة مؤتة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك يستطيل على خالد بن الوليد وقد كان واليا عليهم، فعزره بمنعه من سلبه الذي استحقه.
ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك، قال: قتل رجلٌ من حمير رجلاً من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله، قال: «ادفعه إليه»، فمر خالد بعوف، فَجَرَّ بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: «لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا، أو غنما، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم».
خامسا: الغضب لأجل السؤال فيما لا يحل للسائل:
ومن ذلك: ما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله أبْعِرةً من الصدقة، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن يحمر عيناه، ثم قال: «الرجل يسألني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيتُه أعطيتُه ما لا يصلح لي، ولا له» ، فقال الرجل: لا أسألك منها شيئا أبدا.
قال محمد، أي: بن الحسن الشيباني: لا ينبغي أن يعطى من الصدقة غنيا، وإنما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأن الرجل كان غنيا، ولو كان فقيرا لأعطاه منها.
والغضب لأجل السؤال الذي يفهم منه التعنت والشك: في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر، فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «حذافة» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار، حتى رأيتهما وراء الحائط» وكان قتادة، يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101].
وقد بين الشراح وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما يقول ابن دقيق العيد في جامع العلوم والحكم: "النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابُه مثل: سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة؟، وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره؟، والسؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم.
ومواقف الغضب النبوي كثيرة، وإنما ذكرنا بعضا منها ليعلم القارئ أن الغضب النبوي كمال كله، فقد كان غضبه لأجل الله، ورحمة بعباد الله، ولا يدفعه غضبه لظلم أحد، بل كان يعفو ويصفح، وإنما يغضب لتعليمهم، وتقويم سلوكياتهم، وحماية إيمانهم.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج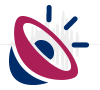 تسجيلات الحج
تسجيلات الحج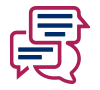 استشارات الحج
استشارات الحج

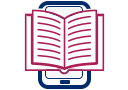












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات