
مِنَ القواعد الهامة عند أهل السُنة في أسماء الله تعالى وصفاته: الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسولُه صلى الله عليه وسلم، مِنْ غير تحريف (صرف اللفظ عن معناه الحقيقي)، ولا تعطيل (نفي صفات الله تعالى أو أسمائه)، ومِنْ غير تكييف (ليس المقصود نفي وجود كيفية لصفات الله، وإنما المقصود نفي عِلم الخَلْق بهذه الكيفية) ولا تمثيل (اعتقاد مُمَاثلة أي شيء مِنْ صفات الله تعالى لصفات المخلوقات).. وقاعدة أهل السُنة في ذلك قول الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(الشورى:11). قال القرطبي: "والذي يُعْتقد في هذا الباب أن الله جلَّ اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحُسْنى أسمائه وعَليِّ صفاته، لا يشبه شيئا مِنْ مخلوقاته ولا يُشبه به {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مُشبهة للذوات، ولا مُعَطّلة مِنَ الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا مِن جهة موافقة اللفظ.. وهذا كله مذهب أهل الحق والسُنة والجماعة رضي الله عنهم". وقال الإمام الأوزاعي: "كُنَّا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السُنة مِن صفاته جل وعلا". وقال الإمام الدارمي: "ونصفه بما وصف به نفسه، ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم". وقال ابن خزيمة: "نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في مُحْكَم تنزيله، أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدول موصولا إليه". وقال ابن تيمية في "شرح العقيدة الأصفهانية": "الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أنْ يوصَف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مِنْ غير تحريف ولا تعطيل، ومِنْ غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد عُلم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله". وقال الشيخ ابن عثيمين: "فأهل السُنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله مِنْ غير تحريف ولا تعطيل، هذه الطريق التي مشى عليها أهل السُنة والجماعة"..
وقد كثُرت وصحت الأدلة على أن المؤمنين يلقون ويرَوْن ربهم سبحانه في الآخرة، وأنه عز وجل يكلمهم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة، يعرفه المُخاطَب به.. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مِنكُم أحَدٌ إلَّا سَيُكَلِّمُه رَبُّه ليس بيْنَه وبيْنه تُرْجمان، فَيَنْظر أيْمَن منه فلا يرى إلَّا ما قَدَّم مِنْ عَمَلِه، ويَنْظُر أشْأَم منه (شماله) فلا يَرَى إلَّا ما قَدَّم، ويَنْظُر بيْن يَدَيْه فلا يَرى إلَّا النَّار تِلْقاء وجْهِه، فاتَّقُوا النَّار ولو بشِقِّ تَمْرَة) رواه البخاري. التَرجُمان فيه لغات، يقال: تُرجُمان، وتَرجَمان، وتَرجُمان، والتَرجُمان يقال لمن ينقل مِنْ لغة إلى لغة أخرى. قال العيني: "قوله: (ما مِنكم) الخطاب للمؤمنين، وقيل: بعمومه. قوله: (ترجمان) فيه لغات ضم التاء والجيم وفتح الأول وضم الثاني". وقال النووي: "قوله (ليس بينه وبينه ترجمان) هو بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان". وقال الأصبهاني: "وَالْمرَاد بذلك أَن يفهمهم خطابه يَوْم الْقِيَامَة من غير ترجمان، فَإِذا حاسبهم يَوْم القيامة أفهمهم كَلَامه وأسمعهم خطابه من غير وَاسِطة، لَا كما أفهمهم في الدُّنْيا بوسائط الرُّسُل والكتب". وقال ابن بطال: "(ليس بينه وبينهم ترجمان) وجميع أحاديث الباب فيها كلام الله مع عباده، ففي حديث الشفاعة قوله تعالى لِمُحمد صلى الله عليه وسلم: (أخْرِج من النار مَنْ في قلبه مثقال حبة مِنْ خردل من إيمان) إلى قوله: (وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها مَنْ قال: لا إله إلا الله) فهذا كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله: (فأستأذن على ربي).. وكذلك قوله في حديث: آخِر مَنْ يدخل الجنة قوله تعالى: (ادْخُل الجنةَ، فيقول: رب الجنة ملأى) إلى قوله: (لك مثل الدنيا عشر مرات) فأثبت بذلك كلامه تعالى مع غير الأنبياء مشافهة، ونظرهم إليه، وكذلك حديث النجوى: (يُدْنيه الله ويقول: سترْتُها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم) على الانفراد عن الناس"..
وفي الحديث: (ما مِنكُم أحَدٌ إلَّا سَيُكَلِّمُه رَبُّه) إثبات صفة الكلام لله تعالى، على ما يليق بجلال الله وعظمته، فالله سبحانه يتكلم كما شاء بما شاء، لا يماثل كلام المخلوقين.. والأدلة على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، ومِنْ أقوال علماء أهل السُنة كثيرة، ومِنْ ذلك:
أولا: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله عز وجل:
1 ـ قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}(النساء:164). قال ابن كثير: "َوهذا تَشْرِيفٌ لِموسى عليه السَّلام، بهذه الصفة، ولهذا يُقال له: الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي.. قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعتُ رجلا يقرأ: {وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا} فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأتُ على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السُلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن، على عليّ بن أبي طالب، وقرأ عليّ بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله، على مَنْ قرأ كذلك لأنه حرَّف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون اللهُ كلم موسى عليه السلام، أو يكلم أحداً مِنْ خَلْقِه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: {وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا} فقال له: يا ابن اللخناء (كناية عن القُبح)، فكيف تصنع بقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}(الأعْراف:143)، يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل". وقال السعدي: "وأنه كلم موسى تكليما أي: مشافهة منه إليه، لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال "موسى كليم الرحمن". وقال البغوي: "العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام".
2 ـ قال تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}(القصص:30). قال ابن كثير: "قوله تعالى: {أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين، الفعَّال لما يشاء، لا إله غيره، ولا رب سواه، تعالى وتقدَّس وتنزَّه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته، وأقواله وأفعاله سبحانه".
3 ـ قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}(التوبة:6). قال ابن كثير: "{اسْتَجَارَكَ} أي: استأمنك، فأجبه إلى طلبته {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} أي: القرآن". وقال السعدي: "وفي هذا حُجة صريحة لمذهب أهل السُنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها". وقال ابن تيمية في "العقيدة الواسطية": "ومِنَ الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله، مُنَزَّل، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره". وقال الشيخ ابن عثيمين: "القرآن كلام الله"..
ثانيا: الأدلة من الأحاديث النبوية:
1 ـ حديث احتجاج آدَم وموسى عليهما الصلاة والسلام وفيه: (قال له آدَم: يا مُوسى، اصطفاك اللهُ بكَلامِه) رواه البخاري.
2 ـ وعن صَفوان بن محرِزٍ المازِنيُّ قال: (بيْنَما أنَا أمْشِي مع ابن عمر رضي اللَّه عنه آخِذٌ بيَدِه، إذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فقال: كيف سَمِعْتَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في النَّجْوى (النَّجوى هي إسرار الواحدِ بالكلامِ مع آخَرَ على انفراد، والمراد بها هنا: ما يقَع بيْن الله تعالى وبيْن عبْدِه المؤمنِ يوم القيامة)؟ فقال ابن عمر: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ اللَّهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيَضَع عليه كَنَفَه ويَسْتُرُه، فيَقول: أتَعْرِف ذَنْبَ كَذا؟ أتَعْرِفُ ذَنْب كذا؟ فيَقول: نَعَمْ أيْ رَبِّ، حتَّى إذَا قَرَّرَه بذُنُوبِه، ورَأَى في نَفْسِه أنَّه هَلَكَ، قال: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وأَنَا أغْفِرُها لك اليَوم) رواه البخاري.
3 ـ وعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ اللهَ يقول لأهلِ الجَنَّة: يا أهلَ الجنَّة، فيقولون: لَبَّيك رَبَّنا وسَعْدَيك والخير في يَدَيك، فيقول: هل رَضِيتُم؟..) رواه البخاري.
4 ـ وعن عديّ بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم مِنْ أحَدٍ إلا سيُكَلِّمُه رَبُّه، ليس بينه وبينه تَرجمانٌ، ولا حِجابٌ يَحجُبُه) رواه البخاري ومسلم.
قال الشيخ الهراس: "في هذين الحديثين: (يقول تعالى: يا آدم) و (ما منكم مِنْ أحد إلا سيكلمه ربه) إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بيَّنّا مذهب أهل السُنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال، ويقول، ونادى، وينادي، وكلم، ويُكَلم.. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام، لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(البقرة:174)، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المُكَلَّم، وهو تكليم خاص (حديث صَفوان بن مُحرِزٍ المازِنيُّ)، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان"..
ثالثا: أقوالِ بعض الأئمة والعلماء في صفة الكلام لله عز وجل:
قال ابنُ بطَّةَ العُكْبَري في "الإبانة الكبرى": "اعلَموا - رحمكم الله - أنَّه مَنْ زعم أنَّه على مِلَّة إبراهيم ودين محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وأنَّه مِنْ أهل شَريعة الإسلام، ثمَّ جحد أنَّ الله كَلَّم موسى، فقد أبطل فيما ادَّعاه مِنْ دينِ الإسلام، وكَذَب في قوله: إنَّه من المسلمين، ورَدَّ على الله قَولَه، وكَذَّب بما جاء به جبريل إلى محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ورَدَّ الكتاب والسُّنَّةَ وإجماع الأمَّة". وقال حَنبَل بن إسحاق: "قُلتُ لأبي عَبدِ الله: يُكَلِّمُ عَبدَه يَوم القيامة؟! قال: نَعَمْ، فمَن يَقضي بَينَ الخَلقِ إلَّا اللهُ؟! يُكَلِّمُ اللهُ عَبْدَه ويَسألُه، اللهُ مُتكَلِّمٌ، لم يَزَلِ اللهُ يأمُر بما شاء ويَحْكُم، وليس لِله عِدْلٌ ولا مِثْلٌ، كيف شاءَ، وأنَّى شاء".. وقال عبد الله بن أحمد في "السُنة": "سألتُ أَبي ـ رَحِمه الله - عن قومٍ يقولون: لَمَّا كلَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ موسى لم يَتكلَّمْ بصَوت، فقال أبي: بلَى! إنَّ ربَّكَ عزَّ وجلَّ تكلَّمَ بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت". وقال ابن أبي زيدٍ القيرواني في "الجامع في السنن والآداب": "ممَّا أجمعت عليه الأمَّةُ من أمورِ الدِّيانة، ومِنَ السُّنَن التي خلافها بدعة وضلالة: .. أنَّ كلامه صِفةٌ مِن صفاتِه.. وأنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ كَلَّم موسى بذاتِه، وأسمعه كلامَه... وكُلُّ ما قَدَّمْنا ذِكْرَه فهو قول أهل السُّنَّة وأئمَّة النَّاس في الفِقه والحَديث على ما بَيَّنَّاه، وكُلُّه قَول مالِك، فمنه منصوصٌ مِن قوله، ومنه معلومٌ مِن مَذهَبه"..
والذي عليه أهل السُنة أن الكلام صفة ذاتية فِعْلية لله عز وجل، فهو صفة ذاتية باعتبار أصله، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً، وصفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته فيتكلم كيف شاء ومتى شاء.. وكما أنَّ ذات الله سبحانه حقيقيَّة لا تُشبِه الذَّوات، فهي متَّصفة بصِفاتٍ حقيقيَّةٍ لا تُشبِه الصِّفات، وكما أنَّ إثباتَ الذَّات إثبات وجودٍ لا إثبات كيفيَّة، كذلك إثبات الصِّفات إثبات وجودٍ لا إثبات كيفيَّة. قال الخطيب البغداديّ في "مسألة في الصفات": "أمَّا الكلام في الصِّفات فإنَّ ما رُوِي منها في السُّنَن الصِّحاح مَذهب السَّلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهِرها، ونَفي الكيفيَّة والتَّشبيه عنها، والأصل في هذا أنَّ الكلام في الصِّفاتِ فَرعٌ على الكلامِ في الذَّات، ويُحتذَى في ذلك حَذْوه ومِثاله، فإذا كان مَعْلُومًا أنَّ إثبات رَبّ العالمين عزَّ وجَلَّ إنَّما هو إثبات وجودٍ لا إثبات تحديدٍ وتكييف، فكذلك إثبات صِفاتِه إنَّما هو إثبات وجودٍ لا إثبات تحديدٍ وتكييف، فإذا قُلْنا: لله تعالى يَدٌ وسَمعٌ وبَصَرٌ، فإنَّما هو إثبات صِفاتٍ أثبَتها اللهُ تعالى لنَفْسِه، ولا نقول: إنَّ معنى اليَدِ: القُدرة، ولا أنَّ معنى السَّمع والبَصَر: العِلْم.. ونقول: إنَّما ورد إثباتُها، لأنَّ التَّوقيفَ وَرَد بها، ووَجَب نَفيُ التَّشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(الشورى:11)، وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}(الإخلاص: 4)"..
وقال ابن القيم في "مدارج السالكين": "والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يُوصَفَ الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مِنْ غير تحريف ولا تعطيل، ومِنْ غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات، وتنفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكونُ إثباتُك مُنَزَّهًا عن التشبيه، ونَفْيُك مُنَزَّهًا عن التعطيل".. وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "قَوْلُ الْجُمْهور وأَهْل الْحَدِيث وأَئِمَّتِهِم: إنَّ اللَّه تعالى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذا شاء، وأَنَّه يَتَكَلَّم بِصَوْت كما جاءت بِه الْآثَار، وَالْقُرْآن وَغَيْره مِن الْكُتُب الْإِلَهِيَّة كَلَام اللَّه". وقال الشيخ ابن عثيمين: "عقيدة أهل السُنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام حقيقي، متى شاء وكيف شاء، بما شاء، بحرف وصوت، لا يماثل أصوات المخلوقين".. وقال: "فالله تعالى لم يزل، ولا يزال متكلما، إذا شاء بما شاء، وكيف شاء، ويكلم مَنْ شاء مِنْ عباده مِنْ: ملائكته، ورسله، وعباده، وسائر الخَلق، ومِن كلامه الكتب، ومنها القرآن، فالقرآن كلام الله {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}(التوبة:6)".
حديث عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحَدٍ إلا سيُكَلِّمُه رَبُّه، ليس بينه وبينه تَرجمان). حديث جليل النفع، عظيم القَدْر، ينبغي على كل مسلم أن يستحضر معناه، وقد بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مِنْ أحدٍ مِنَ البشر إلا سيقف بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة، فيحاسبه على أعماله، خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، ما علِمَه وذكره العَبْد منها وما نسيه، ويحاسبه بدون واسطة، بل يتولى الرب عز وجل ذلك بنفسه، ويكلمه تكليماً مباشراً، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، على ما يليق بجلال الله وعظمته، فالله يتكلم كما شاء، بما شاء، كلاماً يليق به، لا يماثل كلام المخلوقين، قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(الشورى:11). قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: "{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} في الصّفة والْعلم والْقُدْرَة والتَّدْبِير".. وفي الحديث: تكريم وتشريف المؤمنين بكلام رب العالمين، وسماعهم لكلام ربهم سبحانه وفهمه دون واسطة، ورؤيتهم له عز وجل يوم القيامة..



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج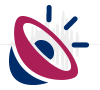 تسجيلات الحج
تسجيلات الحج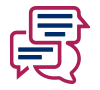 استشارات الحج
استشارات الحج

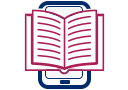












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات