السؤال
أنا امرأة في الثلاثين من عمري، متزوجة منذ خمسة عشر عامًا، تربيت على الدِّين، والأخلاق الفضيلة، ولكني تزوجت برجل أكرهه، وليس على شيء من الدِّين والأخلاق، إلا أنه يحبّني فقط، ولكنه لا يعلم شروط الحب وواجباته، وأهلي زوّجوني به رغمًا عني، فهو رجل يسبّ الله، ولا يصوم، ولا يصلي، ولا يعمل من الدِّين شيئا.
وبعد عدة سنوات من زواجي تعرفت إلى زوج أختي الذي هو صديق زوجي المقرّب، ولا يستغني عنه بأي حال من الأحوال، فهو نصفه الثاني، وشقيق روحه، وبدأت قصتي في خيانة زوجي مع زوج أختي، فعشقته وعشقني، وإلى الآن نحن على علاقة منذ تسع سنوات.
حاولت كثيرًا أن أتوب، وأبتعد عن معصية الله، والخيانة، لكني لم أستطع؛ لأني إذا طردت زوج أختي من بيتي، فسأفضح نفسي أمام زوجي، الذي لم يعلم بخيانتي كل تلك السنين، وزوج أختي رجل تتمناه كل امرأة؛ مما فيه من المحافظة عليّ، وعلى سمعتي، ويؤدّي لي كل ما أطلبه وأتمناه، لكني أكره كل شيء في حياتي، وأكره معصية الله.
فكّرت كثيرًا في الطلاق، وأن أتخلّص من زوجي، وعشيقي الذي هو زوج أختي، لكن وضع أهلي لا يسمح بالرجوع إليهم، وفكّرت حينها في المكان الذي سأذهب إليه إذا طلّقت؛ لأن أهلي لديهم من الهموم ما يكفيهم، ويستحيل أن يتقبلوا فكرة الطلاق.
سئمت العيش، وكرهت حياتي، وأريد أن أتوب وأرجع إلى الله قبل فوات الأوان، ولكن لا سبيل لي من النجاة مما أنا فيه، وأنا أمّ لثلاثة أطفال. أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العجب أن تكون امرأة تربت على الدِّين، والأخلاق الفاضلة؛ ثم تسلك هذا السلوك المنحرف المخالف للدِّين، والمنافي للأخلاق الفاضلة، فبدلًا من سعيها في إصلاح زوجها الفاسد، أو مفارقته، إذا بها تسخط ربّها، وتدنّس عِرضها، وتخون الأمانة بالوقوع في المحرمات.
وإن كان الأمر قد وصل إلى الزنى، فهو من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، ولا سيما إذا وقع من محصنة، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، قال ابن القيم -رحمه الله- في روضة المحبين: فأما سبيل الزنى، فأسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شرّ مقيل، ومستقرّ أرواحهم في البرزخ في تنور من نار، يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب، ضجوا، وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة، كما رآهم النبي في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، لا شك فيها، ويكفي في قبح الزنى أن الله سبحانه وتعالى -مع كمال رحمته- شرع فيه أفحش القتلات، وأصعبها، وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. انتهى.
ومع ذلك؛ فإن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه أنه من تاب توبة صادقة، فإن الله يقبل توبته، ويعفو عنه، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة، وذلك بتحقيق الشروط التالية:
أولًا: الإقلاع فورًا عن هذه الفاحشة، دون تهاون، ولا تسويف، مع اجتناب أسبابها، وقطع الطرق الموصلة إليها، والحذر من اتّباع خطوات الشيطان.
وثانيًا: بالندم على الوقوع في هذه المعصية الشنيعة، والاستحياء من الله الذي سترك بحِلمه، ولم يعاجلك بالعقوبة، وفتح لك باب التوبة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، وتنكشف فيه السرائر، وتبدو فيه السوءات والفضائح.
وثالثًا: بالعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب.
والإكثار من الأعمال الصالحة، والحسنات الماحية، مع كثرة الذِّكر، والدعاء.
ثمّ اجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله تعالى.
فإن لم يتب؛ ففارقيه بطلاق، أو خلع.
وإذا صدقت مع الله تعالى، واتقيتِه، فلن يضيعك، وسيجعل لك مخرجًا، ويعوّضك خيرًا.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

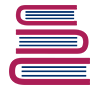
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات